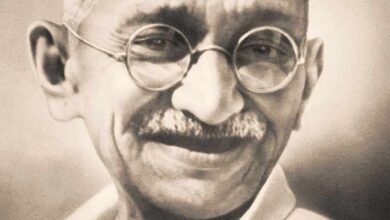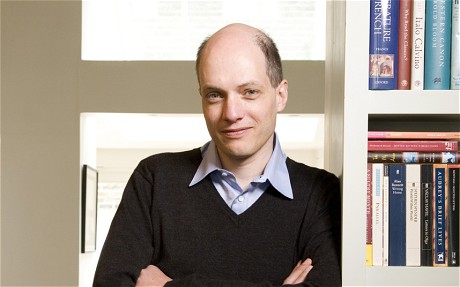الفلسفة باعتبارها أسلوب حياة
يمكن أن يكون القرار العامّ لممارسة الفلسفة هذه العصر، دقيقًا أكثر وفعّالًا من خلال إعطاء أنفسنا تمارين تسمح بتغيير نمط تفكيرنا
يشرّفني، أن أقدّم لكم من جديد، مقالًا مترجمًا، حصريًا لدى ساقية، بعنوان: “الفلسفة باعتبارها أسلوب حياة“، حاول من خلاله الكاتب أن يقنعنا بأن الفلسفة ليست مجرد نظريات وأفكار تُدرّس في المدارس والجامعات، بل هي في الوقت نفسه أسلوب حياة يجب أن يطبق لتنمية طريقة عيشنا. ولن يكون هذا الأسلوب ساري المفعول إلا بإدراجه في قرارتنا اليومية.
مع حلول فترة جديدة من الحياة تأتي قرارات، بغضّ النّظر عن تلك التي سنطبّقها، تهدف كافّتها إلى تحسين نوعيّة حياتنا. علاوة على ذلك، ولهذا السّبب يجب أن ندرج ممارسة الفلسفة في قائمة قراراتنا الرّاهنة، لأنّ الفلسفة منذ بدايتها، كانت تهدف دائمًا إلى تحسين حياة الإنسانيّة.
بالنسبة لـ(بيير هادوت) [١٩٢٢م-٢٠١٠م]، المتخصّص في الفلسفة القديمة، لا يمكن فصل الفلسفة عن النّهج الوجوديّ. إذ سيطوّر (بيير هادوت) هذه الأطروحة، من خلال تحليل كيفيّة ولادة الفلسفة في العصور القديمة، معتقدًا وجود الطّبيعة الحقيقيّة للفلسفة هناك: فلا يمكن فهمها على أنّها نشاط استطراديّ يعتمد على استدلالات متتاليّة، ولكنّها بالأحرى طريقة عيش. وهذا هو منظور الفلسفة الذي يجب إدراجه في قراراتنا الآنيّة.
يجزم (بيير هادوت) على أنّ العالَم المعاصر خسر شيئًا ما في طريقة ممارسته للفلسفة، ويصبح هذا واضحًا عندما نقارنه بالطّريقة التي كانت تُمارَس بها في العالَم القديم. إذ أصبحت الفلسفة اليوم، نشاطًا نظريًّا بشكل أساسيّ لا أكثر: حيث ندرس أفكار الفلاسفة، ونوضّح ونحلّل الأسئلة الفلسفيّة، ونناقشها. وهذا ليس مفاجئًا، لأنّ الفلسفة اليوم يتمّ تدريسها في مؤسّسات الجامعات والكلّيات، أي المؤسّسات التّعليميّة التي تعطيها شكلًا وتملي أهدافًا معينة. فكانت أطروحة، (بيير هادوت) بالتّحديد، أنّ الحال اليوم لم يعد كحال العصور القديمة، حيث لا يمكن فيها فصل الخطاب الفلسفيّ عن طريقة معيّنة للحياة؛ ومن الواضح إنّها ليست مسألة تنحيّة القيمة الأساسيّة التي لا مفرّ منها للخطاب الفلسفيّ جانبًا، بل مسألة التّذكير بأنّه كان دائمًا جزءًا من خيار وجوديّ.
من المثير للاهتمام ملاحظة أنّ (بيير هادوت)، توصّل إلى هذه الفكرة من خلال مواجهته إشكاليّة في تفسير النّصوص القديمة، وهي: كيف سنفسّر تناقضاتها؟ التي تختفي بمجرّد قبولنا أنّ هذه النّصوص لم تكن تهدف إلى تقديم التّفكير النّظريّ فقط للمؤلّفين، ولكنّها كانت تهدف أيضًا إلى:
إنتاج تأثير تدريبيّ: يريد منه الفيلسوف أن يجعل أذهان القرّاء أو المستمعين تعمل، بحيث يضعون أنفسهم في موقف معيّن
– (الفلسفة باعتبارها أسلوب حياة)، ٢٠٠٣م.
سقراط، الشّخصيّة المؤسِّسة للفيلسوف:
تظهر فكرة إنّ الفلسفة هي طريقة حياة واضحة جدًّا، في شخصيّة (سقراط) الأسطوريّة: “
فهل يمكننا فصل خطاب سقراط عن حياته ثمّ موته؟
– (ما هي الفلسفة القديمة؟) ١٩٩٥م.
لذا نحن نتحدّث عن شخصيّة (سقراط)، لأنّنا نعرفها فقط عبر تعليقات الآخرين، وخاصّة تعليقات (أفلاطون). كما أنّه أسطوريّ أيضًا، لتأثيره الملحوظ على تاريخ الفلسفة.
على هذا النّحو، ليس لدى (سقراط) ما يعلِّمه، بالإضافة ادّعاءه أنّه لا يعرف شيئًا، وهذه ميزته على الآخرين الذين يعتقدون أنّهم يعرفون بينما هم جاهلون. والنّتيجة أن سيكلّف نفسه بمهمّة: يمشي بلا كلل في المدينة لإيقاظ فكر ساكنيها، فكانت تعاليمه حِواريّة بحتة؛ إذ لا يمكن سكب المعرفة، إذا جاز التّعبير، داخل رأس شخص آخر، ولكن المعرفة تُكتسب من خلال التّساؤلات التي يحاول (سقراط)، عبرها، قيادة محاوريه، إلى اكتشاف جهلِهم ما يعتقدون أنّهم يعرفون. فالتّعلم والبحث عن الحقيقة والحكمة لا يمكن أن يبدأ إلّا بعد أن يدرك المرء جهله.
بهذا المعنى، فإنّ مقابلة (سقراط) هي تجربة تحويليّة: بمعنى أنّ محاوره ينتهي باستجواب نفسه، وبالتّالي، فـ“في الحوار السّقراطيّ، يكون السّؤال الحقيقيّ المطروح ليس ما نتحدّث عنه، بل هو الشّخص الذي يتحدّث نفسه”. وعبر أسئلته، لا يقود (سقراط) محاوريه فقط إلى التّعرف على جهلِهم، ولكنّه يأتي أيضًا ليحثّهم على الالتزام بحياة أفضل. إذ يضايق (سقراط) محاوريه، “مثل “الذّبابة”، بأسئلة يحوِّلها من جديد لأسئلة أخرى تتناسل وهكذا، حتّى يجبرهم على الاهتمام بأنفسهم، ورعايتها. وعليه، يجسّد (سقراط) مثالًا على هذا البحث عن الحياة الجيّدة، ليس عبر خطاباته، ولكن بواسطة نوع الوجود الذي يعيشه، كما يوضّح هذا الاقتباس من “محاورة الاعتذار” لـ(سقراط) قائلًا:
لا يهمّني ما يهتمّ النّاس به، من أمور ماليّة، وإدارة الممتلكات، ومواقف استراتيجيّة، ونجاح الخطابة، والتّميّز في القضاء، والائتلافات، والوظائف السّياسيّة. لقد ألزمت نفسي بالابتعاد عن هذه السُّبل، إلّا واحدة تخصّ كلّ واحد منكم تحديدًا، هي التي سأحقّق أكبر فائدة بواسطتها، إقناع الشّخص أن لا يهتمّ بما يمتلكه، أكثر من اهتمامه بحالته الرّوحيّة، لكي يجعل من نفسه شيئًا ممتازًا ومعقولًا قدر الإمكان.
فلا يمكن فصل البحث عن الحقيقة من عمل حول الذّات، بهدف عيش حياة صالحة، والاسترشاد بالقيم الصّالحة كذلك.
يوضحّ لنا (سقراط)، أنّ البحث عن الحقيقة والحكمة ليس مقصدًا، بل طريقًا. وأنّه نفسه ليس حكيمًا، لأنّ الحكيم لا يحتاج إلى طلب الحكمة، فهو يمتلكها بالفعل، على هذا الأساس فـ(سقراط) ليس حكيمًا ولا جاهلًا، هو ببساطة يبحث عن الحكمة. ويؤكّد (بيير هادوت) هذه النّقطة في تحليله لـ “المأدبة”، حيث يقول:
مع المأدبة، أصل كلمة الفلسفة [حب، رغبة في الحكمة] يصبح برنامج الفلسفة ذاته. ويمكننا القول مع مأدبة سقراط: إنّ الفلسفة بالتّأكيد، تأخذ في التّاريخ نغمة ساخرة ومأساويّة في الوقت نفسه. فمن حيث السّخريّة، لأنّ الفيلسوف الحقيقيّ سيكون دائمًا الشّخص الذي يعرف أنّه لا يعرف، ومن يعرف أيضًا أنّه ليس حكيمًا، وبالتّالي فهو ليس حكيمًا ولا جاهلًا؛ القابع في مكانه لا في عالَم الحمقى ولا في عالَم الحكماء […]، لذلك فهو غير قابل للتّصنيف. ومن حيث المأساة، لأنّ هذا الكائن الغريب قد عُذّب ومُزّق بواسطة الرّغبة في تحقيق الحكمة، التي تهرب منه والتي يحبّها ويتبعها.
وهكذا، فإنّ الفيلسوف لا يتميّز بامتلاكه الحكمة، بل برغبته في الحصول عليها، وميله البحث عنها بنمط حياة يتوافق مع هذا البحث. إنّه يدرك استحالة الوصول إليها، ويدرك الطّبيعة الأبديّة لسعيه، على حدّ تعبير (بيير هادوت)، هو “برنامج” الفلسفة الذي سيؤثّر على المدارس الفلسفيّة التي ستظهر بعد وفاة (سقراط).
المدراس الفلسفيّة والتّمارين الرّوحيّة:
ستظهر مدارس فلسفيّة مختلفة بعد وفاة (سقراط) نهاية القرن الرّابع قبل الميلاد، وكانت المدارس الرّئيسيّة منها توجد في أثينا، وهي:
- الأكاديميّة؛ التي أسّسها (أفلاطون)
- المدرسة الثّانويّة؛ التي أسّسها (أرسطو)
- الحديقة؛ التي أسّسها (أبيقور)
- ستوا؛ التي أسّسها (زينون)
إذ يتّخذ أعضاء هذه المدارس خيارًا وجوديًّا معيّنًا، ويتبنّون طريقة حياة معيّنة؛ فالخطاب الفلسفي لا ينفصل دائمًا عن الحياة الفلسفيّة بالنّسبة لهم. ومن سمات هذه المدارس أيضًا، حضور التّمارين التي سمّاها (بيير هادوت)، بـ”التّمارين الرّوحيّة”، “أي ممارسة طوعيّة وذاتيّة تهدف إحداث تحوّل للفرد ولشخصيّته”. وبعض هذه التّمارين مألوف لنا أكثر، مثل قراءة النّصوص أو ممارسة الحوار، لكن بعضها الآخر غريب بما يكفي، كما نعنيه بالفلسفة اليوم: حفظ العقائد، الزّهد في الرّغبات، امتحان الضّمير، أو أيضًا، التّوسّع في الكون.
وعلى الأساس ذاته، يمكن أن يكون القرار العامّ لممارسة الفلسفة هذه العصر، دقيقًا أكثر وفعّالًا من خلال إعطاء أنفسنا تمارين تسمح بتغيير نمط تفكيرنا. وهي تمارين تشبه إلى حدّ ما الممارسة المنتظمة لتمارين بدنيّة بهدف تطوير مهاراتنا الفيزيولوجيّة شيئًا فشيئًا، كذلك التّمرين الرّوحيّ ومثال، يسمح لنا بالتّغيير النّفسيّ رويدًا رويدًا. وهكذا يمكن للمرء إدراج قراءة النّصوص في ممارساته اليوميّة، أو الحوار أو التّأمّل أو الانتباه إلى اللّحظة الحاليّة؛ ومع ذلك يجب وضع هذه التّدريبات في المنظور العامّ الذي طوّره (بيير هادوت)، فيما يتعلّق بطبيعة الفلسفة. لذا يجب أن نتذكّر أنّها ليست تمارين نظريّة بحتة، ولكنّها تشير إلى من نحن، وإلى الوجود الذي نريد أن نعيشه، وإلى الحياة التي تستحقّ العناء. وهكذا نعيد أنفسنا مرّة أخرى إلى التّجربة الأولى للفلسفة، إلى “اللّدغة” التي تدعونا إلى التّساؤل عن هوّيتنا، والعالَم الذي نعيش فيه، والآراء التي توجّهنا. هذا الوعي والتّساؤل، مثل البحث عن الحقيقة المرتبطة بهما، ولا يتحقّقان أبدًا، لكن يجب عدم التّخلي عنهما. لذا يمكن للمرء أن يأخذ قرارًا للقيام بممارسة روحيّة وفلسفيّة كلّ يوم.
أحبّ (بيير هادوت)، أن يقتبس هذه الجملة من (جورج فريدمان):
خذ رحلة، كلّ يوم! على الأقلّ لحظة قصيرة جدًّا، بشرط أن تكون قويّة المعنى، لتمارس كلّ يوم “تمرينًا روحيًّا”، بمفردك أو صحبة شخص يريد أيضًا أن يتحسّن.
لذلك، دعونا نتّخذ في خضمّ حياتنا قرارًا أيضًا بممارسة تمرين روحيّ وفلسفيّ كلّ يوم.
بقلم: أوليفييه ميشود
ترجمة: د. محمد كزو
تحرير: أحمد بادغيش
[المصدر]