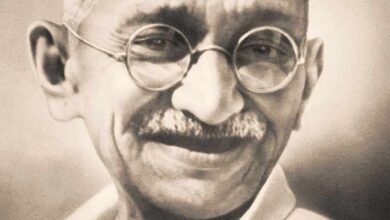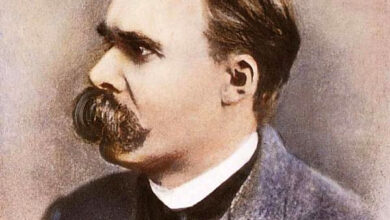الثقافة: الراقي والشعبي
أمبرتو إيكو (Umberto Eco)، فيلسوف ايطالي،روائي وباحث، يُعرف بروايته الشهيرة اسم الوردة، ومقالاته العديدة. وهو أحد أهم النقاد الدلاليين في العالم.
تحدث امبرتو ايكو في أحد المقالات التي كانت تصدر له في نيوورك تايمز وتمت ترجمتها من قبل جريدة الاتحاد الإمارتية بعنوان الثقافة: الراقي والشعبي قائلاً:
أثناء مناقشة “أنجيلو أكوارو” و”مارك أوجيه” كتاب فريديريك مارتل الجديد، وعنوانه “الاتجاه السائد”، في إصدارٍ حديثٍ لصحيفة “لاريبابليكا” الإيطالية، تطرّقا إلى مسألةٍ غالباً ما يتم تناولها، لكن دائماً من زوايا مختلفة، وبوجهٍ خاص في ما يتعلق بمستويي الثقافة، الراقية والمتدنية. ولا شك في أنّ شخصاً شاباً يستمع اليوم لموسيقى موزار وللموسيقى الفولكلورية من دون تمييز، يعتقد أن لا علاقة لهذه المسألة بالموضوع. لكن من الضروري الإشارة إلى أنّ المسألة كانت بالغة الأهمية منذ نصف قرنٍ. ففي عام 1960، كتب الناقد الثقافي الأميركي، دوايت ماكدونالد، مقالاً مميزاً بعنوان “ماسكلت أند مدكلت”، (أي الثقافة الشعبية والثقافة المتوسطة)، ولم يظهر من خلاله مستويين من الثقافة وحسب بل ثلاثة مستويات.
أكّد ماكدونالد أنّ جويس وبيكاسو وسترافنسكي يمثلون الثقافة الراقية، في حين تمثّل أفلام هوليوود وموسيقى الروك وغلافات مجلة “ساترداي إيفنينغ بوست” (ومعظمها للرسام الأميركي نورمن روكول) “الثقافة الشعبية”. غير أن ماكدونالد قام أيضاً بتعريف مستوى ثالثٍ من الثقافة، وهو “الثقافة المتوسطة”، التي شبّهها بمنتجات الترفيه التي استعانت ببعض أنماط الطليعيين، في حين بقيت في أساسها رديئة. ومن بين الأمثلة القديمة على الثقافة المتوسطة، ذكر ماكدونالد أعمال الرسام الفكتوري الهولندي الأصل السير لورنس ألما تاديما، والشاعر الفرنسي العظيم إدمون روستان الذي أحدث تغييراً بارزاً في نصف القرن الماضي. أما بالنسبة للفنانين المصنفين ضمن الثقافة المتوسطة، وهم من جيل ماكدونالد، فقد أشار هذا الأخير إلى إرنست همنغواي في حياته مؤخراً، والكاتب الأميركي ثورنتون ويلدلر، الذي فازت مسرحيته في عام 1938 بعنوان “أور تاون” بجائزة بوليتزر. ومن المرجح أن يكون ماكدونالد قد أضاف الكاتب المسرحي وليام سمرست موم، والهنغاري ساندور بيتوفي والروائي البلجيكي الأصل والرفيع الشأن والكثير الإنتاج جورج كرستشن سايمنن. كما اعتبر ماكدونالد روايات سايمنن البوليسية التي تتميز بالمحقق البوليسي جول ميغريه، من ضمن الثقافة الشعبية، وأعمال سايمنن الأخرى التي تخلو من المحقق ميغريه من ضمن الثقافة المتوسطة.
لا يعود الفرق بين الثقافة الشعبية والثقافة الراقية إلى زمنٍ بعيدٍ كما يتخيّله الكثير من الأشخاص. فقد ذكر أوجيه في صحيفة “لا ريبابليكا” مأتم الكاتب الفرنسي فكتور هوغو، والذي حضره مئات الآلاف من الناس (هل كانت أعمال هوغو من الثقافة المتوسطة أم الراقية؟)، في حين كان تجار السمك في بيريوس حتى، يستمتعون بمآسي سوفوكليس. وما إن تم نشر رواية “ذو بتروثد” في أوائل القرن التاسع عشر للكاتب ألساندرو مانزوني، حتى صدرت عدة نسخ تدلّ على شعبية هذه الرواية. ولا ننسى القصة الشهيرة للحداد المنشد الذي اختلط بسطور قصائد دانتي، الأمر الذي أغاظ الشاعر من جهة لكنّه أظهر أيضاً من جهةٍ أخرى أنّه حتى الأمّيين يدركون أعماله.
وهذا الأمر صحيح، ففي روما القديمة كان الناس يتخلون عن مسرحيات تيرينس للذهاب إلى السيرك ومشاهدة الدببة. لكن حتى في أوقاتنا هذه، يتخلّى المفكرون العظماء عن حفلةٍ موسيقيةٍ ما لمشاهدة مباراة كرة قدم مهمة. وفي الواقع، لا يتضح الفرق بين مستويي الثقافة (أو المستويات الثلاث) عادةً إلا عندما يثير الطليعيون القدامى البرجوازية عن قصد من خلال تمجيد غموض الأداء أو رفضه كقيم فنية.
هل يحدث هذا الفرق بين الثقافة الراقية والمتدنية في أوقاتنا هذه؟ لا. فمؤلفو الموسيقى الكلاسيكية في القرن العشرين، مثل لوتشيانو بيريو وهنري بوسور، يولون موسيقى الروك أهمية كبيرة في حين يضطلع العديد من موسيقيي الروك بالموسيقى الكلاسيكية إلى حدٍّ كبير. فانتشار “البوب آرت” في منتصف القرن وضع حداً لتسلسل الثقافة التقليدية: ويُعزى اليوم عدم القراءة إلى الغموض الكبير لبعض الكتب الكوميدية (وما يعرف اليوم بـ”الروايات القصصية”)، في الوقت الذي يعتبر فيه العديد من مسارات صوت الأفلام الغربية والإيطالية كموسيقى الحفلات. واليوم، كل ما عليك القيام به هو مشاهدة مزادٍ علني على التلفزيون لرؤية أشخاص يقومون بشراء “غير راقٍ” (وبرأيي، كل من يشتري لوحةً على التلفزيون لا يصنّف عضواً في نخبة المثقفين) للوحاتٍ زيتيةٍ مجرّدة من الفن العريق، كان ليرفضها أهلهم وليعتبرونها كصورٍ رُسمت بذيل حمار. وكما بيّنها أوجيه: “ثمة دائماً تبادل سرّي بين الثقافة الراقية والثقافة الشعبية، وغالباً ما تغني الثقافة الشعبية الثقافة الراقية” (وأود أن أضيف قائلاً، “والعكس صحيح”).
والجدير بالذكر أن التمييز الحديث بين مستويات الثقافة انتقل من التركيز على محتوى عمل معيّن أو شكله إلى طريقة الاستمتاع به. وبعبارةٍ أخرى، لم يعد من وجود لأي فرق بين بيتهوفن و”جنغل بلز”. فاليوم يستمتع السامعون بموسيقى بيتهوفن، والتي يتم تصوّرها كخلفيات موسيقية وسلسة نغمات رنين، من دون إدراكهم بذلك (كما أوضحها الناقد الثقافي ووتر بنجامن)، وبالتالي، باتت شبيهة بنغمات الإعلانات. لكن النغمة المعدة لإعلان سائل تنظيف قد تصبح موضوع تحليل مهماً وتكتسب تقديراً نظراً للإيقاع أو اللحن أو التناغم.
وبالإضافة إلى العمل الفني، فقد تغيّرت أيضاً مقاربتنا للأمر. فالأشخاص الذين لا يبالون بالموسيقى، قد يستمعون إلى ووغنر كمسارٍ موسيقي لعرضٍ واقعي، في حين قد يجلس رفيعو الذوق ويستمتعون بمشاهدة فيلم “تريستان وإيزولد” حتى النسخ القديمة منه كتسجيلات الفينيل.