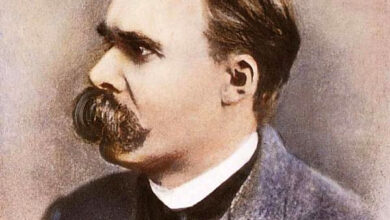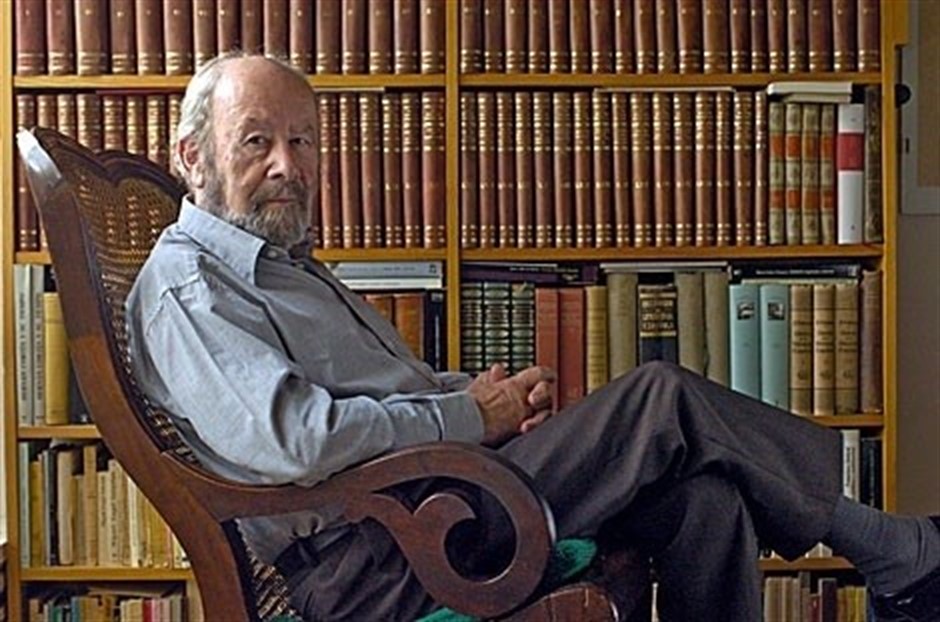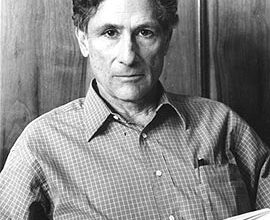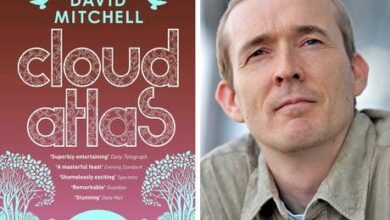فرجينيا وولف تتساءل: لماذا نقرأ؟ وماهي أوجه الشبه بين أعظم الأعمال الأدبية؟
"إضافة إلى الكتابة، فإنني أقرأ الكثير. بيد أن الكتب هي أكثر الأشياء التي أستمتع بها".

تترابط عقولنا، نحن البشر، ببعضها البعض. فكل عقل متقد اليوم، يحاكي عقولاً عظيمة كانت موجودة فيما مضى، أمثال (أفلاطون) و(يوربيديس) إذ يمثل تطوراً واستمرارية للشيء ذاته. إنه ذلك الفكر المشترك الذي يربط العالم بأسره .فالعالم، في جوهره، ليس سوى فكر.
لقد أدرجت (باتي سميث) ضمن قائمة المعايير التي وضعتها لتصنيف الروائع الأدبية، قدرة هذه الأعمال على سحر قارئها إلى الحد الذي يشعره بضرورة إعادة قراءتها مرة أخرى. في حين اعتبرت (سوزان سونتاغ) أن عملية إعادة القراءة، تلك، هي بمثابة ولادة جديدة للنص. وأظنني أُوافقهما الرأي في ذلك، عن طيب خاطر، لأنني أواظب على قراءة رواية (الأمير الصغير) مرة في كل عام. إذ أجدها تبوح لي، في كل قراءة، بمعان جديدة، ومرممات وجودية لكل ما يمكن أن يعكر صفو حياتي في تلك اللحظة.
قد نلجأ، نحن القراء، إلى إعادة قراءة بعض الأعمال المحببة إلينا، لأننا ندرك عدم استمرارية التجارب الإنسانية، بالإضافة إلى آنية تلاقي الحالات والظروف التي تكوّن الذات البشرية في أية لحظة من الزمن. ناهيك عن إدراكنا لتطور شخصياتنا في العام المقبل، إذا ما قورنت بها في العام الفائت، لتغدو أكثر نضجاً في مواجهة كافة التحديات، و الآمال، والأولويات. حيث تصبح ذاتاً جديدة، مختلفة كلياً عنها فيما مضى.
كانت (فرجينيا وولف) في الحادية و العشرين من عمرها حين سجلت هذا الاعتراف، بصفاء ذهني لا يضاهى، وألق لغوي فريد. ففي صيف عام 1903، انزوت (وولف) بعيداً عن صخب مدينة لندن، لتذهب في إجازة قضتها بين رحابة، وخضرة الريف الإنكليزي، لتستمتع بعزلتها، وتقرأ ما يحلو لها.

ربما بلغت قراءتي خلال هذه الأسابيع الثمانية في الريف، ما يفوق ما أقرؤه في ستة أشهر أثناء وجودي في لندن.
في غضون تلك الرحلة الاستجمامية مزدوجة الفائدة، والتي حققت فيها مكسب القراءة والتأمل، وصلت (وولف) إلى اكتشاف السبب الحقيقي الذي يجعلنا نقرأ، بالإضافة إلى ما يمكن للكتب أن تقدمه للروح الإنسانية، وكيف لها أن تمهد لما أسمته (إيريس مردوك): “فرصة للتجرد من الأنانية”، وكيف يمكن للكتب أن تؤدي براعتها المذهلة في كونها تنشأ عن ذهن شخص معين، لتتمكن من الوصول، بهذه الحميمية، إلى آلاف، أو ربما ملايين الأشخاص عبر الزمان والمكان، في عملية تداخل بين مختلف المشاعر، ضمن تجربة تشاركية واسعة.
في الأول من يوليو، كتبت (وولف) في مذكراتها ما يلي:
إضافة إلى الكتابة، فإنني أقرأ الكثير. بيد أن الكتب هي أكثر الأشياء التي أستمتع بها.
في بعض الأحيان، أشعر بأجزاء من دماغي تتسع و تكبر أكثر فاكثر، و كأنها تنبض بدم متجدد، بشكل أسرع من ذي قبل. وليس هنالك شعور أكثر لذة من هذا الشعور. أما حين أقرأ التاريخ، فكل شيء يصبح ,على حين غرة، نابضاً بالحياة. متفرعاً جيئة و ذهاباً، مرتبطاً بكل أشكال الأشياء التي كانت بعيدة في الماضي. وكأنني أشعر، على سبيل المثال، بتأثير (نابليون) على أمسيتنا الهادئة في الحديقة. لأرى كيف ترتبط عقولنا ببعضها البعض، وكيف يمكن لأي عقل متقد أن يحمل التركيبة ذاتها التي كونت عقل (أفلاطون) أو (يوربيديس) إنها عملية تتمة وتطوير لذات الشيء. هو ذلك الفكر المشترك الذي يربط العالم بأسره، فالعالم، في جوهره، ليس سوى فكر.

في وقت لاحق من حياتها، كتبت (وولف) في وصفها الرائع لإدراك معنى أن تكون مبدعاً، ما يلي:
ثمة مثال يكمن خلف كل حالة ضبابية. هذا العالم عبارة عن عمل إبداعي. لا وجود لـ(شكسبير) فنحن الكلمات في أعماله، أو (بيتهوفن) فنحن الألحان في موسيقاه، ولا لإله، فنحن الشيء بعينه.
بعد بلوغها الحادية والعشرين من العمر، تمكنت (فرجينيا) من إدراك آنية هذه اللمحات الجزئية للحقيقة، وكيف يمكن لهذا الشعور بالانتماء الداخلي، أو ذاك الشعور بالكينونة، أن ينزلق من بين أيدينا. تكمل (وولف) تدوين ذات المذكرات التي كتبتها في عام 1903 بلفتة رشيقة من إدراكها أن “العالم بأسره ليس سوى فكر” إلى ذاك الهروب المألوف للمعنى، حينما تجتاحنا تلك الحالة الضبابية لتحيلنا غرباء، مرة أخرى:
ثم أقرأ قصيدة تقول “ذات الشيء يتكرر”. لأشعر أنني تمكنت من القبض على المعنى الجوهري للعالم، و كأن كل هؤلاء الشعراء والمؤرخين والفلاسفة يتبعون طرقاً تتفرع عن ذاك المركز، حيث أقف. ليعتريني بعض الاضطراب بعدها، فيؤول كل شيء للخطأ من جديد.

وبعد أكثر من عقد من الزمن، كررت (وولف) وجهة النظر ذاتها، في واحدة من مقالاتها الاستثنائية التي كتبتها في غضون عملها كناقدة في الملحق الأدبي لصحيفة التايمز البريطانية، والتي تم جمعها، مؤخراً , في كتاب تحت عنوان (نبوغ و حبر؛ مقالات للكاتبة (فرجينيا وولف) حول كيفية القراءة) هذا الكتاب الذي كنت سأدرجه، بكل شغف، ضمن قائمة كتبي المفضلة لهذا العالم، لو كنت من أولئك الذين يفضلون إعادة قراءة الروائع الأدبية المحببة إلى قلوبهم.
كما هو حال الشاعرة البولندية الحائزة على جائزة نوبل للأدب (فيسوانا شيمبورسكا) التي اتسم نقدها التأملي بكونه يوظف الكتب كنقطة انطلاق لتأملات سامية حول الفن والحياة، أكثر من كونها نماذج للمراجعة أو النقد، تعامل (وولف) كل كتاب تقوم بمراجعته كحجرة سقطت من جيب معطفها في نهر الحياة [*]. حيث تقوم برصد الصيغة الأساسية للعمل، ومن ثم تراقب حلقات الإدراك التي تتنامى وتترقرق في نهر الوعي . في أولى مقالاتها من تلك السلسلة التي تناولت فيها روايات الكاتبة (تشارلوت برونتي)، تبنت (وولف) وجهة نظر عميقة حول نشأة الروائع الأدبية، والذي نعاود الرجوع إليه مراراً، وتكراراً :

ثمة ميزة تتشارك بامتلاكها كافة الأعمال الأدبية الحقيقية. ففي كل قراءة لها، يلاحظ القارئ تغييرات طفيفة. كما لو أن نسغ الحياة يجري في أوراقها. أو أنها تمتلك، كما هو حال السماء و النباتات، القدرة على تغيير شكلها ولونها بين فصل و آخر. إن تدوين انطباع القارئ حول مسرحية (هاملت) بعد قراءتها في كل عام، من شأنه أن يصبح أشبه بسيرة افتراضية لكاتبها. فكلما ازدادت معرفتنا للحياة، كان لدى (شكسبير) تعقيباُ على ما عرفناه.
[المصدر]
[*] يقصد بها الإشارة إلى حادثة انتحار (فرجينيا وولف)، حيث ملأت جيوب معطفها بالحجارة وألقت بنفسها في نهر أوز.