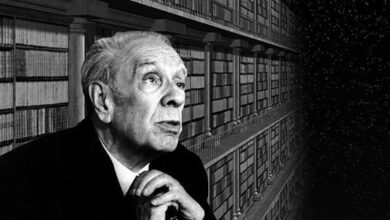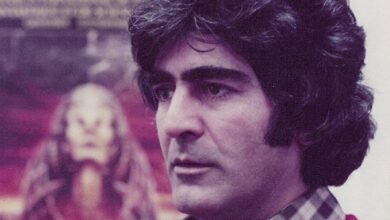مهما بدت مشاهد حيواتنا مشوشة، ومهما كنا، نحن الذين نعيشها، منهكين، بإمكاننا مواجهة تلك المشاهد والسير حتى النهاية

في إحدى ظهيرات مدينة نيويورك ا
في تلك اللحظة، تغير كل شيء. كا
وبالرغم من وصف الشاعر الروسي (جوزيف بروسكي) للشعر بأنه أدا
يتيح الشعر للفرد أعمق أنواع ا
لتملك للعالم.
إلا أن ردة فعلي، في يوم الثلا
إنه رفض يتسم بالخوف.
إن كتاب (موريل) هذا يعد استكشافًا رائعاً، وبالغ الحكمة لكل
إن الشعر هو الطريقة التي تُشعر
البشر بتلاقي ضمائرهم مع العالم. وهو الذي يشعرهم بقيمة معاني مشاعرهم وأفكارهم، وبجدوى علا قاتهم مع بعضهم البعض. هو فرصة للإحساس بعذوبة الأشياء واحتمالاتها المتعددة. فالشعر فن ينهبنا كل هذه الأشياء. لكنه، للأسف، فن منبوذ في مجتمعنا. لقد حاولت جاهدة، في كتابي هذا، تتبع أساليب رفض الشعر. بدءً من كل أنواع الملل، ونفاد الصبر، ناهيك عن إطلاق صفات كالنخبوية، والغموض، والاضطراب، و إثا رة الشبهات على الشعر. فهل ثمة ما هو حقيقي من بين تلك
الصفات، وهل يمكن أن يفضي ذلك إلى إفساد إدراك الإنسان؟ يمكننا أن نلاحظ أن آراءً كهذه
من شأنها أن تؤدي إلى تقييد ملكة الخيال لدى الشاعر وجمهوره، على حد سواء.
أما في سعيها للوقوف على أسباب
تتشابه روابط الشعر، إلى حد كبير، بروابط العلم. و لا أقصد
بذلك النتائج العلمية، بل أعني نقطة التلاقي بين كافة أنواع ا لخيالات، والتي يمكن للشعر أن يمنحها لقرائه. في الوقت الذي تتكون فيه السيمفونية، مثلاً، من مجموعة من النوتات الموسيقية، والنهر من عدد هائل من قطرات الماء، لا يمكن للقصيدة أن تكون مجرد الصور والكلمات الواردة فيها. فالشعر يعتمد في وجوده على تلك الروابط المتحركة بداخله. هو فن يعيش في زمنه. يعبّر ويستحضر تلك الروابط المتحركة بين إدراك الفرد والعالم. إن آلية عمل القصيدة تقوم على نقل الطاقة الإنسانية . و أظن أن بمقدو ري تعريف طاقة الإنسان بكونها قدرته على الإدراك، وعلى إحداث تغيير في ظروف وجوده.
إن تقبل معاني الشعر من شأنه أن
في اللحظة التي نواجه فيها آفاقًا وتضادات أكثر اتساعاً مما سبق، غالباً ما نلجأ لمصادرنا الخاصة التي هي مصدر قوتنا. لننظ
ر، مرةأخرى، لأماني الإنسان و معتقداته. وتلك المصادر هي التي يمكن لخيالنا، من خلالها، أن يقودنا للتفوق على أنفسنا. إذا حدث وراودنا شعور بفقدان شيء من تلك الوسائل، فربما يكون
سبب ذلك الشعور هو عدم استخدام إحداها، أو ضرورة إيجاد الكثير منها والبدء باستخدامها هي الأخرى. لطالما قيل أنه يتوجب علينا استخدام طاقاتنا البشرية، و بأن ثقافتنا هي التي تحثنا على استخد
ام كل مافيها من ابتكارات وحقائق. ولكن، ثمة نوع من أنواع المعرفة الثمينة، المتمردة، والتي تفوق الأوابد الأثرية في قدرتها على تحدي الزمن، والتي يجب أن تتناقلها الأجيال فيما بينها بأية طريقة تكن، ألا وهي الشعر.
تعود (روكيسر) هنا للحديث عن ا
ولأن من الصعب أن نوقف هذا الكم
الهائل من الأحداث والمعاني التي تحدث كل يوم، آن الأوان لنستذكر شكلاً آخر من أشكال المعرفة والمحبة. هذا الشكل الذي لطالما كان وسيلة لبلوغ أقصى أنواع المشاعر والعلاقات تعقيداً. وهذه الوسيلة تشبه غيرها من العلو م والفنون، بيد أنها تمتاز عنها بقدرتها على تأهيل خيالنا للتعامل مع حيواتنا. وأعني بتلك الوسيلة الشعر.
بعد ذلك، تعرض (روكيسر) تعريفًا لا غنى عنه لطبيعة ومغزى الشعر في وجهة نظر عرضها الفيلسوف
يحمل الفن وعداً بالكمال الدا
خلي.
وفي هذا الصدد تكمل (روكسير) حديثها قائلة:
إن الشعر، فوق كل شيء، هو مقا
ربة لحقيقة أحاسيسنا، ولكن، ما هي جدوى تلك الحقيقة؟ مهما بدت مشاهد حيواتنا مربكة أ
و مشوشة، ومهما كنا، نحن الذين نعيش تلك المشاهد، منهكين، بإ مكاننا مواجهتها والسير لبلوغ الكمال.
تذهب (روكيسر) إلى اعتبار الشعر فناً يحضى بأقل قبول بين غيره
أما فيما يتعلق بأصل رفضنا للشعر، والمتمثل بذلك الخوف الذي يعبر عن خلل نفسي، تقول (روكسير):
إن القصيدة الشعرية ليست دعوة فقط، بل هي ضرورة ملحة. فما الذي تدعو إليه القصيدة؟
يمكن للقصيدة أن تحرك فينا العو
اطف والأحاسيس، بل وربما تتطلب منا استجابة شاملة، وهذه الاستجابة الشاملة لا نصل إليها إلا عن طريق المشاعر. كما أن القصيدة المكتوبة بعناية غالباً ما تستحوذ على خيال قارئها فكرياً. فعندما تدرك القصيدة فكرياً، هي تسلك طريقها إليك عبر المشاعر أو مايمكننا تسميته بالأحاسيس.
ولفهم ذلك، ينبغي عليك، عزيري
سيشرق الأمير الصغير على الأطفا
ل بذلك النور الطاغي الذي سيلمس فيهم شيئاً آخر سوى عقولهم. حتى يأتي للوقت المناسب ليستوعبو ا ما حدث.
وفي العودة إلى أولئك الذين لا
ينبع الشهر من أعماق ناظمه، إذ
يخيل لقارئ الشعر الحقيقي أن مشاعر الشاعر تخاطب مشاعره.
وبما أننا قد حُرمنا تلك الهبة، ألا وهي الشعر، تعيد الشاعرة
إن ذلك الخوف الذي يجعلنا نرفض
الشعر هو خوف متعمق في ذواتنا منذ أواخر مرحلة طفولتنا، إذ لم نكن نمتلك ذلك الخوف من قبل. فالطفل الصغير لايعرف هذا الخو ف لأنه يثق بمشاعره. بيد أن الحواجز تُبنى على عتبات مرحلة المراهقة. أما في سن الرشد، فغا لباً مايرمي الناس الشعر وراء ظ هورهم. ولا أعني بذلك المعنى ا لحرفي للكلمة، أي كما يتخلص الأطفال من ألعابهم القديمة، بل أقصد تلك القناعة الصادمة بكون ا لشعر يقع خارج نطاق اهتماماتهم.
ولا عجب أن يقوموا بازدراء الشعر
إن ثقافتنا في التعليم ثقافة تخصصية. فهي تعمل على تزويدنا بمعلومات وخبرات في مجال محدد دون
غيره من المجالات. وهذه الخبر ة تؤهلنا للتعامل مع مشكلات محدد ة هي الأخرى. إذ تسمح لنا بموا جهة الواقع العاطفي والواقع الر مزي بشكل خجول . يمكن لعالم مبتدئ، أو كاتب محترف أن يتساءل قائلاً: كيف بمكنني الحكم على جودة قصيدة بعينها؟ بإمكاني الجزم بجودة الأشياء
الواقعة في مجال تخصصي، بيد أ نني أجد نفسي غير قادر على الجز م بكون قصيدة ما جيدة أم لا. أما في الرد على تساؤل كهذا، فيمكننا القول بأن من قاموا بطرحه هم أناس يفتقرون الثقة بمشاعر
هم ورود أفعالهم. إن فقدان ثقتنا بمشاعرنا هو نوع
من أنواع انعدام الشعور بالأما ن. ولن نتمكن من التخلص من شعو رنا الداخلي بافتقارنا الى الكمال، إذا لم نكن قادرين على دمج كل العناصر المكونة لشخصياتنا من أجل تحقيق التكامل الذي تشكل ملكة تذوق الشعر جزءاً منه. إن هذا الجمع بين العناصر التي
تتحرك سوياً وفق نظام مرئي أصبح واضحاً في كل العلوم، فلا عجب أن يكون حاضراً في كتاباتنا أيضًا. و أينما وجد، فبمقدوره أن يعطينا نوعاً من الخيال الذي يمكننا من التلاقي مع العالم. كما يعزز قدرتنا على التعامل مع أية وحدة مكونة منعناصر متعددة، تعتمد في وجودها على بعضها ا لبعض.
[المصدر]