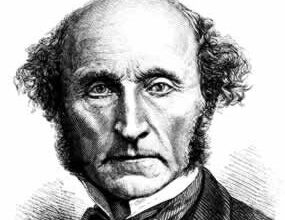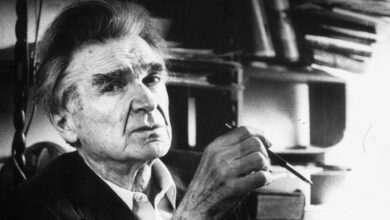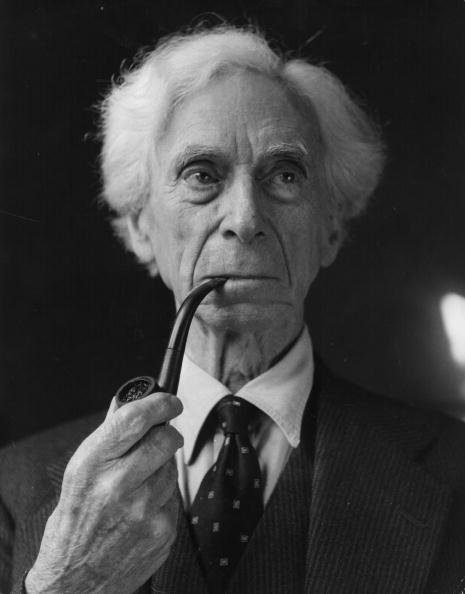مبدأ الهوية عند ديڤيد هيوم، قراءة زكي نجيب محمود
يُعدّ الفيلسوف (ديڤيد هيوم) من أهم فلاسفة الإنجليز كما تُعد رسالته في الطبيعة البشرية، أهم إنتاجاته. ومن خلال عرض الدكتور (زكي نجيب محمود) لهذا الكتاب، نقتبس مقتطفات من هذه القراءة.
فيقول:
من أهم المشكلات التي تعرض لها (هيوم)، مشكلة “الهوية” التي بفضلها نقول عن شيء ما إنه هو هو، برغم تعاقب اللحظات وتعاقب الانطباعات الحسية التي نستقبلها منه، فإذا كان هذا المكتب الذي أمامي يرسل إلى حواسي لمعات من الضوء ولمسات من الصلابة تجتمع معا داخل الرأس لتتكون منها فكرة مركبة هي ما أسميه بكلمة “مكتب”، فلابد لنا من مبدأ يفسر لنا اعتقادنا بدوام وجود شيء معين في الخارج، هو الذي يبعث إلى الحواس بهذه الرسائل المتعاقبة؛ فعلى أي أساس أحكم بأن ذلك الشيء موجود في الخارج، مع أن كل ما لدي عنه هو انطباعات حسية، ثم على أي أساس أحكم بأن ذلك الشيء نفسه مستمر في وجوده حتى ولو خرجت من الغرفة ولم تعد حواسي تتأثر بانطباعاته عليها، وأخيرا على أي أساس أقول إنه هو المكتب نفسه كلما وقع بصري عليه؟ ألا يجوز أن يكون هناك مكتب آخر شبيه كل الشبه بالمكتب الأول، وضع مكانه أثناء غيابي من الغرفة.
ثم يكمل بعد ذلك قائلًا:
إن كل هذه الاعتقادات مني عن المكتب إنما ترتكز على مبدأ يجعل وجود المكتب مستقلا عن إدراكي له، ومن ثم فإنني أحكم بوجوده حتى ولولم أكن أراه ولا ألمسه، ثم أحكم بأنه مكتب واحد حتى ولو كنت أعاود رؤيته حينا بعد حين؛ وذلك المبدأ هو مبدأ تكوين العادات عند الإنسان، فلو كان ارتكازنا على الحواس وحدها لقالت الحواس إنني لا أملك إلا انطباعاتي ولا أدري إن كان هنالك شيء خارج تلك الانطباعات أو لم يكن، ولو كان مرجعنا هو العقل، لقال العقل إن المقدمات التي بين يدي -وهي سلسلة الانطباعات الحسية- لا تنتج بالاستنباط وحده نتيجة تقول إن مجموعة الانطباعات المتتابعة تكون في الحقيقة شيئا واحدا وتأتي كلها من مصدر واحد، واحتكامنا إلى العقل لا يضمن لنا أبدا أن يكون الذي نراه الآن ثم نغيب عنه ثم نعود إلى رؤيته لمرة أخرى في يوم آخر هو هو نفسه، الشيء ذاته لم يتغير. لكنها العادة التي تتكون من رؤيتنا لمجموعة جوانب متجاورة أو متتابعة، فعندئذ إذا ما رأينا جانبا واحدا فقط ورد إلينا بقية الجوانب بحكم العادة، بحيث تصبح وكأنها متماسكة في شيء واحد؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن صورتها وهي متماسكة تكون شديدة الشبه بصورتها حين أدرك الشيء في لحظات متباعدة، حتى ليدفعني هذا الشبه الشديد بين ما رأيته بالأمس وما أراه اليوم إلا القول بأنه هو هو الشيء نفسه في الحالتين؛ ولولا “المادة” التي تشد الشبيه إلى شبيهه لرأيت كل حالة وكأنها مبتورة الصِّلة بأشباهها ولما أتيح لي أن أقول عن الشيء الواحد إنه واحد، ولا أقول عنه إنه مستمر في وجوده شيئا واحدا.
وفي موضع آخر يقول (زكي نجيب محمود):
فلا أساس لمعرفتنا كلها إلا الانطباعات الحسية، تلتئم وترتبط داخل رءوسنا وفق مبادئ ترابط المعاني وتداعيها، فتكوّن الأفكار المركبة التي في رءوسنا، وتعوّدنا رؤية مجموعة معينة منها متلازمة دائما، هو الذي يميل بِنَا إلى القول بأن لهذه المجموعة مصدرا واحدا مستمرا ذَا هوية معلومة.
ونمضي في الحديث فنقول إن عملية التفكير بعدئذ إما أن يكون قوامها ربط فكرة بفكرة تقتضيها، وإما أن يكون قوامها ربط فكرة بأصلها الخارجي، أو بعبارة أخرى عملية التفكير إما أن تكون رياضية استنباطية تستولد فيها فكرة من فكرة، وإما أن تكون متعلقة بأمور للواقع كما هي الحال في العلوم الطبيعية؛ فأما الصنف الأول فنظري صرف ويقيني النتائج ما دامت مستنبطة استنباطا صحيحا من مقدماتها، كأن تقول مثلا إن أربعة مضروبة في خمسة تنتج عشرين، وإن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، ففي حالات كهذه لا نريد إلا أن تكون النتيجة متسقة مع مقدماتها، وما دامت المقدمات صحيحة فلابد أن تكون النتائج صحيحة.
وأما الصنف الثاني الذي نطابق فيه أفكارنا من جهة والواقع من جهة أخرى فلا يقين فيه، لأن أي شيء أقوله عن أمور الواقع يجوز أن يكون نقيضه هو الصحيح؛ فإذا قلت عن ورقة إنها بيضاء، فما الذي كان يمنع عند العقل أن تكون لونا آخر لولا التجربة التي دلتني على لون معين دون سواه.