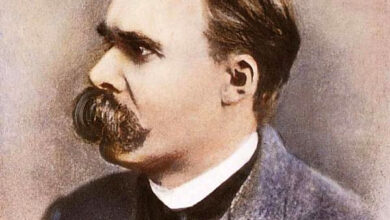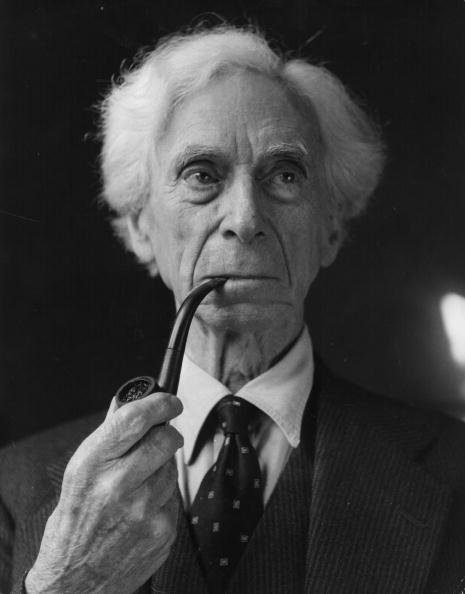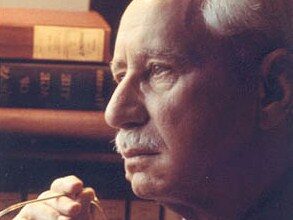عن علم الجمال، عند شوبنهور
آرثر شوبنهور (1788 – 1860) فيلسوف ألماني، معروف بفلسفته التشاؤمية يرى في الحياة شر مطلق فهو يبجل العدم، وقد كتب كتاب (العالم إرادة وتمثل) الذي سطر فيه فلسفته فلذلك تراه يربط بين العلاقة بين الإرادة والعقل فيرى أن العقل أداة بيد الإرادة وتابع لها. في كتاب (تاريخ الفلسفة الحديثة) للفيلسوف الأمريكي (ويليم كيلي رايت)، قام الأخير بسرد فصل يشرح فيه أفكار (شوبنهور) حول علم الجمال أو الاستطيقيا، مستندًا في شرحه على كتاب (شوبنهور) المذكور مسبقًا. يقول (ويليم كيلي رايت) مبتدئًا كلامه:
إن الأفكار، كما رأينا، أزلية، وتقف بين الإرادة من حيث إنها شيء في ذاته والأشياء الفردية المتغيرة التي تتمثل فيها الأفكار. وتظل المعرفة، عادة، خاضعة للإرادة ؛ فنحن لا نعرف إلا لكي ننفذ رغباتنا التي تنبثق من الإرادة. ومثل هذا الخضوع ثابت في حالة الحيوانات. ومع ذلك يستطيع الإنسان في خبرات استاطيقية مختصرة أن يلغي الخضوع للإرادة، ويركز تأمله مباشرة في الأفكار، بغض النظر عن إشباع الرغبات. وعندما يفعل ذلك، يخفي التمييز بالنسبة له بين الذات والموضوع، لأن هذا التمييز لا يوجد إلا في أفراد يتميز بعضهم عن بعض عن طريق مبدأ العلّة الكافية، ولا يتمسك بالأفكار التي تسبق هذا التمييز. ففي العالم فقط من حيث إنه تمثل، أي عالم الموضوعات المدركة، تكون الذات متميزة عن الموضوعات التي تدركها. ومن يصبح مستغرقًا في إدراك الطبيعة التي يفقدها كل إحساس بالفردية، ينتبه إلى معرفة أنه هو والطبيعة أصلًا شيئًا واحدًا.
ثم يقول عن معنى الفن وقيمة الفنان عند (شوبنهور):
إن أحداث العالم، بالنسبة لأي شخص يفهم تلك الحقيقة، ليس لها أهمية إلا من حيث إنها الحروف التي نقرأ بها الأفكار. وهذا النوع من المعرفة، الذي يهتم بالأفكار، التي تكون المضامين الثابتة لكل الأشياء المتغيرة، هو الفن. فهو ينتج من جديد الأفكار الأزلية في وسيط مادي، مثل النحت، والتصوير، والشعر، والموسيقى. والإنسان الذي ينتج الأفكار أو يدركها في عمل من أعمال الفن يكون عبقريًا ؛ لأن أعمال الفن الفعلية هي في الغالب الأعم نسخ غير كاملة من الأفكار، وهي تفتن عبقريًا ذا خيال لكي يقوم بتمييز الفكرة فيها. ويظهر العبقري غالبًا، للناس العاديين القاصرين في التخيل، ولا يدركون موضوعات عادية بينما يرى العبقري فكرة، إنسانًا مجنونًا، وذلك ما يبينه (أفلاطون) في أسطورة الكهف وفي أماكن أخرى، وأشار إليه شعراء كثيرون. وفي حين أن معظمنا ليسوا عباقرة، إلا أن كل إنسان لديه القدرة على المتعة الأستاطيقية يمتلك مقدرة قليلة لإدراك الأفكار التي تكون أساسًا لموضوعات الطبيعة والفن التي ينتجها من جديد.
ثم يتحدث بتفصيل عن عدد من أشكال الفنون، اخترنا لكم بعضًا منها، فنون العمارة مثلًا:
ويوضح فن العمارة، من حيث إنه فن جميل، بعضًا من الأفكار التي تؤلف الدرجات الدنيا من تموضع الإرادة في الثقا والتماسك، والصلابة، والصلادة – الصفات الكلية للحجر، وتجليات الإرادة الأكثر بساطة وإبهامًا. والموضوع الوحيد لجماليات العمارة هو الصراع بين الثقل والصلابة، الذي يكشف عنه الفن بتمييز تام بالنسبة إلى الضوء. واستطاع الفنان المعماري أن ينتج هذه الآثار بحُرّية أكثر في المناخ المعتدل في الهند، ومصر، واليونان، وروما. أما في أوروبا الشمالية فقد قيّد المناخ القاسي حريته، ولابد من تزيين عربات الذخيرة الحربية، والأسطح المحددة، وأبراج العمارة القوطية بزخرفات مستعارة من فن النحت.
يتطرق بعد ذلك إلى فن آخر، وهو الشِعر عند (شوبنهور). يقول:
الشعر هو أعلى الفنون التي تكشف عن الأفكار، الذي يصور الناس في سلسلة مترابطة من مجهوداتهم وأفعالهم. إن الشاعر يصور الخصائص التي لها مغزى ودلالة في أفعال لها مغزى، ويكون أكثر نجاحًا في الكشف الحقيقي عن الأفكار من المؤرخ، الذي يكون مجبرًا على اختيار أشخاص وظروف كما تأتي في علاقاتها المتشابكة والمؤقتة من علل ومعلولات. ولذلك لابد أن ننسب حقيقة داخلية حقيقية بالفعل إلى الشعر أكثر من التاريخ. ويدرك الشاعر في الشعر الغنائي، والأغاني، حالته الداخلية الخاصة ويصفها. […] ويتوارى الشاعر بصورة كبيرة أو قليلة وراء تمثلاته في أنواع أخرى من الشعر، إلى حد ما في القصيدة الروائية، وبصورة كلية في الدراما الشعرية، التي تكون الصورة الأكثر موضوعية، وكمالًا وصعوبة في الشعر. إن الشاعر هو مرآة البشرية، ويجلب إلى وعيها ما تشعر به، وما تفعله.
وبطبيعة (شوبنهور) المتشائمة، فقد تطرق بشكل أكبر إلى التراجيديا، وهي الأعمال الفنية الدرامية المائلة إلى التصوير المأساوي. فيقول عنها:
التراجيديا هي ذروة الفن الشعري، بسبب عظمة تأثيرها، وصعوبة إنجازها. فهي تصور الجانب المرعب من الحياة، تصور الألم الذي يتعذر التعبير عنه، وشكوى البشر، وانتصار الشر، وسقوط البريء العادل. إنها صراع الإرادة مع نفسها، والمعنى الحقيقي للتراجيديا هو أن البطل يُكفِّر، لا عن خطيئته الفردية الخاصة، وإنما عن جريمة الوجود الفردي، وتحطم الإرادة إلى أشخاص منفصلين.
وفي النهاية يذكر الموسيقى كأحد أنواع الفنون:
أما الموسيقى فهي تقف وحدها، مختلفة عن كل الفنون الأخرى. لأن الفنون الأخرى تكشف عن الأفكار، في حين أن الموسيقى تنفذ وراء الأفكار وتكشف عن الإرادة من حيث هي شيء في ذاته. وتصور النغمات المنخفضة، في انسجام الألحان، الدرجات الدنيا لتموضع الإرادة، أي الطبيعة غير العضوية، وضخامة كوكب الأرض، في حين أن النغمات العالية تصور عالم النباتات والحيوانات. وتسير فواصل السلم الموسيقي في موازاة مع درجات التموضع في الطبيعة، أي الأنواع المختلفة.
وأخيرًا يختتم كلماته بالحديث عن المتعة، وعلاقتها بالجمال:
وتمكننا المتعة التي نستقبلها من الجمال بأسره، والعزاء الذي يقدمه لنا الفنان من أن نستغرق لحظة فيما كتب وننسى أنفسنا من حيث أننا أفراد، وننسى كل همومنا الشخصية. وندرك أننا واحد مع الطبيعة بأسرها من حيث إنها تعبير عن الإرادة، وندرك أن كل حياة، وليست حياتنا الخاصة، معاناة تذهب سدى. ويقدم لنا نسيان أنفسنا بهذه الطريقة راحة مؤقتة من الآلام المضنية لرغبات فردية تعي ذاتها.