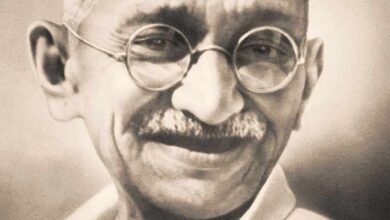رسالة مي زيادة في الصداقة
مي زيادة (١٨٨٦ – ١٩٤١) أديبة وكاتبة فلسطينية لبنانية، اسمها الأصلي كان ماري إلياس زيادة، واختارت لنفسها اسم ميّ فيما بعد. كانت مهتمةً بدراسة الّلغة العربيّة، وتعلّم الّلغات الأجنبيّة، وأتقنت تسع لغات، فتميّزت ميّ منذ صباها ونشرت مقالات أدبية ونقدية واجتماعية، وتعد ميّ من رموز الأدب العربي في العصر الحديث. في مقالة لها بعنوان (كلمات في الصداقة) نُشرت في (مجلة الرسالة) بتاريخ ١١ فبراير ١٩٣٥، كتبت رسالة مهداة إلى الأستاذ (أحمد حسن الزيات)، وإلى الدكتور (طه حسين)، وإلى أصحابهما جميعًا، تقول:
قد تبدو هذه الكلمات غريرةً للذين لا يرون في الصداقة إلا وسيلة نفعية تعود على كلٍ من المرتبطين بها بفائدةٍ محسوسة: كالظهور بمظهر العظمة، أو التمكن من دحر منافس، أو التعاون على الإساءة إلى شخص أو أشخاص، أو جني ثمرةٍ ملموسة وتحقيق غرض مالي أو اجتماعي.
ونخطئ إن نحن نسبنا إلى أهل هذا العصر وحدهم الصداقة المغرضة؛ لأن تلك كانت شيمة الكثيرين في جميع العصور وعند جميع الأقوام، قد تكون في هذا العصر أكثر لنور وإلى الهواء – إذا أنت طلبت هذا من الصداقة وعند الصديق، فما أنت في نظر تلك الفصيلة من الناس إلا من أهل الشذوذ والغباوة. . . على الأقل!
ونخطئ إن نحن نسبنا إلى أهل هذا العصر وحدهم الصداقة المغرضة، لأن تلك كانت شيمة الكثيرين في جميع العصور وعند جميع الأقوام. قد تكون في هذا العصر أكثر لنور وإلى الهواء – إذا أنت طلبت هذا من الصداقة وعند الصديق، فما أنت في نظر تلك الفصيلة من الناس إلا من أهل الشذوذ والغباوة . . . على الأقل!
وعلى رغم كل ذلك فموضوع الصداقة من الموضوعات التي نُقبلُ عليها في اهتمام ولهفة ولو جاز لي أن أشير إلى خلق خاص في، قلتُ إني أشعر بشيء غير قليل من الأسف كلما انتهى إلى أن صديقين كريمين تجافيا بعد التصافي. وقد يكون ذلك أن انفصام عرى الصداقة بين الآخرين كأنما ينال من إيماني بالصداقة ويزعزع من رجائي فيها.
أولى ذكرياتي في هذا الموضوع ترجع الى قصة فرنسية، هي (أبرص بلدة آووستا) بقلم كزافييه دي ميستر، وأظنني قرأتها لأول مرة وأنا في سن العاشرة تقريباً. فيها وصف ذلك الجندي الكاتب اجتماعه برجلٍ ابتلى بداء البرص المروع، فنبده الناس من مجالسهم، وحايدوا الدنو من الدار التي عاش فيها وحده حبيساً طوال الأعوام.
تُطوِّح السبيل بالكاتب الغريب إلى تلك البلدة وتسوقه الى الدار المخيفة، ويلجُ باب الحديقة فيبصر الرجل الموبوء وهو لا يدري بحالته. وعندما يحذره الأبرص ويفضي إليه بمحنته لا يلوذ الكاتب بالفرار، وإنما يقترب منه ويجلس إليه مستفسراً عن معيشته وأحواله، وعما يحسه في الابتعاد عن أولئك البشر الذين هم منهم، فيعترف الأبرص بأن آلامه الأدبية تفوق أوجاعه الجسدية، يعترف بعذابه في حزن هادئ يشبه الامتثال والرضى، يعترفُ بحاجته الى الشعور بأن قلباً يعطف عليه ويحن إليه، بأن يداً تصافح يده، بأن صدراً يتلقاه ويحتضنه، حتى أنه لشدة حاجته تلك يحتضن أحياناً جذوع الشجر ويضمنها إليه ما استطاع، كأنها كائنات انسانية. يعترف بشوقه الى سماع صوت بشري، الى تبادل السلام والحديث مع من يفكر تفكيره ويحس إحساسه، الى جميع تلك الأمور التي عرف قيمتها لأنه حُرِمَ منها، والتي يتمتع بها الجميع جاهلين أنها منحة ومتعةٌ لأنها عاديةٌ بينهم.
ويقولُ فيما يقول وكأنه يلخص جميع صنوف عذابه في هذه الكلمة:
– لم يكن لي يومًا صديق.
والكاتب الذي عرف كيف يصغي إلى شكايته في هدوء ورباطة جأش، تهتاج تلك الكلمة شجونه وتحزُّ الشفقة في قلبه، فلا يتمالك من الهتاف:
– يا لك من تعيس!
تلك الكلمة من الأبرص، ورد الجندي الكاتب عليها، استقرت في موضع عميق من روحي عند قراءة القصة، بل القصة كلها تجمعت عندي في تلك الكلمة وفي التعقيب عليها، وقد يكون لها الأثر الكبير في تكوين إيماني العنيد بأن لا بد من وجود الصداقة، مع اعتقادي بأن نفاسة الصداقة نفسها تحتم فيها الندرة.
لسنا في حاجة إلى دهور نعيشها لندرك كم في هذه الحياة البشرية من خبث ومراوغة ونفاق. اختباراتٌ قليلة تكفي لتدلنا على أن بعض المُثُل العليا تخذلنا وتصرعنا بلا رحمة، ثم تنقلب مسوخاً ساخرة مزرية، لا تلبثُ أن تكشّر عن أنيابها مهددة متوعدة، وهي التي تجلببت في نفوسنا من قبلٌ جلباب القدسية والعبادة!
اختباراتٌ قليلة في أحوال معينة، وأحوال مفاجئة، تكفي لتظهر لنا أن من الناس من يتاجر بكل عاطفة صالحة لتنفيذ أغراض غير صالحة، ومن يستغل كل استعداد كريم لنتيجةٍ غير كريمة، ومن لا يكتفي بالظلم والاجحاف، بل لا يتورع عن إيذاء الذين أخلصوا النية في معاملته، ولم ينله منهم إلا الخير.
اختباراتٌ قليلة في أحوال معينة، وأحوال مفاجئة، تكفي لتُظهِر لنا أن من الناس من يتاجر بكل عاطفة صالحة لتنفيذ أغراض غير صالحة، ومن يستغل كل استعداد كريم لنتيجةٍ غير كريمة، ومن لا يكتفي بالظلم والإجحاف، بل لا يتورع عن إيذاء الذين أخلصوا النية في معاملته، ولم يَنَلْه منهم إلا الخير. وكم من مذيع أنباء الصداقة لا لسبب آخر سوى التوغل في الإيذاء باسم الصداقة، في أساليب سلبية أو إيجابية، لا يعلم إلا هو كم هي خبيثة وكم هي فعَّالة.
وكيف تُعامِلُ أولئك الناسَ عندما تكشف عمَّا يضمرون؟ أتحاسنهم؟ إنهم يحسبون المحاسنة ضعفًا ومداراة، فيمعنون في الأذى! أتخاشنهم؟ إنهم يزعمون المخاشنة جحودًا ومكابرة، فيمعنون في الأذى! ولعل الشاعر العربي كان في حالة كتلك عندما أرسل هذه الزفرة المنغومة التي هي من أبلغ ما أعرف في معناها:
عَذِيرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَا إِنْ جَفَوْتُهُ .. صَفَا لِي، وَلَا إِنْ صِرْتُ طَوْعَ يَدَيْهِ
وَإِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَى ظِلِّ صَاحِبٍ .. يَرُوقُ وَيَصْفُو إِنْ كَدِرْتُ عَلَيْـهِ
يأسُ هذا الشاعر يدل على حاجته الصميمة إلى صداقة نقية غير مغرضة، فنحن مهما تنكَّر لنا معنى الصداقة الصافي، ومهما غدر بنا الغادرون فعلمونا الحذر، فإننا لا نستطيع إنكار احتياجنا العميق إلى الصديق؛ لأن لدينا مرغمين كمية من المودة والوفاء والتسامح والغفران والتضحية لا بد من تصريفها وإنفاقها لتزيد بالعطاء غنًى، وعند من نصرفها وعلى من ننفقها إلا على الأشخاص الذين نراهم قمينين بأنبل ما عندنا من فكر، وأصدق ما لدينا من عاطفة؟
أيها الذين ربطت الحياةُ بينهم بروابط المودة والإخاء والتآلف الفكري والنبل الخلقي، حافظوا على صداقتكم تلك وقدِّروها قدرها! فالصداقة معينٌ على الآلام ومثارٌ للمسرات، وهي نور الحياة وخمرتها، وكم تكنُّ من خير ثقافي وعلمي للنابهين!
لا تخافوا أن تكونوا من أهل الشذوذ والسذاجة في نظر المعرضين! ألا يئست نفسًا فقدت كل سذاجة، وسارت على وتيرة واحدة، لا تعيش إلا للغرض وبالغرض! وما أفقرها وإن كانت ثرية! وما ألصقها بالثرى وإن كانت علية! وحسبكم أنتم أنكم بإيمانكم بالصداقة توجدون الصداقة، وبممارستكم أساليب الصداقة إنما تكوِّنون خميرة الصفاء والصلاح والوفاء!
تحرير: أحمد بادغيش مراجعة: حبيبة خالد