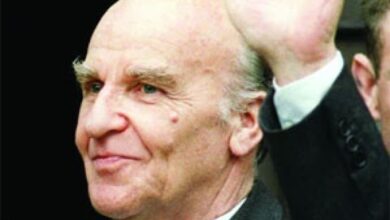أيجب أن يعبر الشعر عن مشاكل المجتمع؟ نازك الملائكة تتساءل
نازك صادق الملائكة (1923 – 2007) شاعرة من العراق، ولدت في بغداد في بيئة ثقافية وتخرجت من دار المعلمين العالية عام 1944. دخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى عام 1949، وفي عام 1959 حصلت على شهادة ماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن-ماديسون في أمريكا، وعينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت. عاشت في القاهرة منذ 1990 في عزلة اختيارية وتوفيت بها في 20 يونيو 2007 عن عمر يناهز 83 عاما.
في كتابها (قضايا الشعر العربي)، تستغرب ممن ينتقد على الشعر والفن بشكل عام انفصاله عن الواقع. تقول مستفتحة حديثها:
باتت الدعوة إلى اجتماعية الشعر نبرة عصبية تطغى على الصحافة العربية طغيانًا عاصفًا. فالقارئ يعثر على أصدائها في كل صحيفة يقرؤها، ويسمعها تتكرر في محطات الإذاعة، وتتسلل إلى أحاديث الأندية والمجتمعات حتى باتت في عنفها تشبه تيارًا جارفًا يريد أن يكتسح القيم كلها. ونحن لا نشكك في سلامة نية هذه الدعوة، وصدق إيمانها بغايتها، ومن المؤكد أنها لا تريد ضرًا بالشعراء، فهي على العكس تؤمن بالشعر إيمانًا متحمسًا يجعلها تنتظر منه أن يحقق المعجزات في سبيل إنقاذ هذه الأمة التي تعبر اليوم مرحلة متأزمة من حياتها. على أن سلامة النية لا تملك أن تعصم من الاندفاع العاطفي الذي نلمس آثاره في هذه الدعوة، ولذلك بات على الشعر المعاصر أن يواجه الموقف ويتخذ إزاءه قرارًا.
ثم تقول بعد ذلك:
أول ما يؤخذ على هذه الدعوة التي تذهب إلى أن الشعر يجب أن يكون “اجتماعيًا”، أنها تتسلح بمجموعة من التعابير المبهمة التي لا تحاول تحديدها من نحو قولهم “أبراج عاجية” و”المتهربون من الواقع” و”الأدب الشعبي” و”الشعراء الذاتيون”. وقد أدّى تداول جماهير الكتاب لهذه الألفاظ إلى اضطراب شديد في مدلولاتها وأكسبها من السطحية ما يجعل الناقد المثقف يتحرج من استعمالها محاولًا صياغة تعابير جديدة تؤدي معانيها الفنية والنظرية.
وترد على ذلك بقولها:
ويبدو لنا أن الدعوة قد نسيت حتى الآن أنها في مجال فنيّ، فهي تتحدث عن كل شيء آخر غير الشعر، مع أنها موجهة إلى الشعراء.
وتكمل حديثها مبيّنة مآخذ تلك الدعوة:
والدعوة بصورتها الحالية تحتمل نقدًا شديدًا من جهاتها كلها؛ فنيًا وإنسانيًا ووطنيًا وجماليًا. وأبرز مواطن الضعف فيها أنها -كما قلنا- لا ترتكز على أسس فنية، شعرية، ولم يحاول كاتب واحد بعد أن يحددها من وجهتها النظرية.
وتبدأ نقدها من الوجهة الفنية، فتقول:
أما من الوجهة الفنية، فيبدو لنا أن الدعوة حين تلحّ على أن الشعر يجب أن يكون اجتماعيًا، فإنما تتناول “الموضوع” وتجعله الغاية الوحيدة المقصودة في كل شعر. فهي لا تهتم بسائر مقومات القصيدة كالبناء والهيكل والصورة والانفعال والموسيقى والفكرة والمعاني الظاهرة والخفية، […] وهذا مخالف لمفاهيم الشعر البديهية، فلعل الموضوع في نظر النقد الأدبي أتفه مقومات الشعر وأقلها استحقاقًا للدراسة المنفصلة، وذلك لأن كل موضوع يصلح للشعر سواء أدار حول مشاكلنا القومية أو حول شجرة التوت أو معركة سباب في شارع ضيق، فالمهم على كل حال هو أسلوب الشاعر في معالجة الموضوع، ولذلك نجد الموضوع عينه ميتًا أو مغمى عليه عند شاعر، حيًا ينبض بالجمال المنفعل عند شاعر ثان. ومن هذا يبدو أن الدعوة تلح على العنصر الوحيد الذي ليس شعريًا في القصيدة.
ولا تقتصر هذه الدعوة على عزل الموضوع عن سائر عناصر القصيدة، وتضخيم قيمته الفنية هذا التضخيم الذي لا يشفع له شيء، وإنما تمضي في طغيانها الحسن النية، فتأبى إلا أن تحدد مجال هذا الموضوع تحديدًا صارمًا. فكل شعور لا يتعلق بالوطنية بأضيق معانيها يفوز لديها بنعوت عاطفية جارفة لا يصد اندفاعها شيء. وهكذا نجدها لا تكتفي بهدم سائر معالم القصيدة، وإنما تهدف إلى أن تتحكم حتى في العنصر الوحيد الذي أبقته وهو الموضوع.
ثم تنتقل بعد ذلك إلى الوجهة الاجتماعية، فتقول:
وإذا فحصنا الدعوة من الوجهة الاجتماعية وجدناها في صميمها تنزع إلى أن تجرد الشعر من العواطف الإنسانية. ذلك أن أشد سخطها واستنكارها ينهال على ما تسمّيه “المشاعر الذاتية” و”الهرب من الواقع” و”الانعزالية”، ولو فحصنا هذه التعابير لوجدناها تنتهي كلها إلى أن تنكر أن يكون شعور الفرد العادي من الناس موضوعًا للشعر، فهو لكي يستحق أن تدور حوله قصيدة، ينبغي أن يكون عملاقًا بلا مشاعر؛ فلا يحب الأزهار، ولا يضيع وقته في مراقبة مغرب الشمس على حقول الحنطة، ثم إنه لا يتألم لهمومه الخاصة، وهو يؤمن بأن الاستماع إلى الموسيقى في هذه الظروف إنما هو خيانة وطنية، ونحو هذا .. وليس أشد تناقضًا من هذا.
وأخيرًا إلى الوجهة الوطنية، تقول:
ولندرس الدعوة من وجهتها الوطنية. فماذا نجد؟ هنا أيضًا ستجبهنا أسس منهارة لا تستطيع أن تثبت للفحص طويلًا. والحق أن العنصر الوطني قائم، لو فكرنا، على فهم للوطنية يضيّق معناها تضييقًا شديدًا. فالدعوة عندما تؤكد أن انصراف الشاعر المعاصر إلى تصوير عواطفه الخاصة يدل على نقص في حسه الوطني -والدعوة تستعمل ألفاظًا أعنف غالبًا- إنما تفترض ضمنًا ثلاثة ضمونات غريبة تستوقف النظر. وسنحاول أن نناقشها هنا.
وتستغرب أن يكون ذلك معارضًا للشعور بالوطنية، وتنتقد وجهة نظر أولئك النقاد وفهمهم للوطن، فتقول:
أول هذه المضمونات أن الدعوة تفصل فصلًا قاطعًا بين دائرة “المواطن” الصالح ودائرة “الإنسان”. فلكي يكون المرء مواطنًا صالحًا في نظرها ينبغي له أولًا أن يتخلص من إنسانيته، فلا يحب قوس قزح، ولا ينفعل لمنظر الحصاد، ولا تطربه أغاني الحمامة بين النخيل في ظهيرة بغدادية، إلخ. فكل هذا إذا تغنّى به الشاعر، إنما يثبت “سلبيته” في نظر الدعوة.
وتكمل قائلة:
وأما ثاني المضمونات الغريبة التي تختفي خلف هذا الحكم الذي تسوقه الدعوة، فهو ينتهي بنا إلى الحكم بأن “الوطنية” معنى مرادف للكفاح السياسي، وهذا مخالف للمعنى الحقيقي للوطنية، معنى حب الوطن العربي وحسب. أما الكفاح السياسي فهو وظيفة النخبة المثقفة من القادة والزعماء والاختصاصيين في كل أمة. ويبدو أن الدعوة تتغافل عن حقيقة أخرى مهمة هي أن الوظيفة العظمى للملايين من المواطنين في كل بلد هي إعالة أسرهم وتحسين أحوالهم الاجتماعية وتهذيب أبناءهم وانصرافهم انصرافًا مخلصًا إلى أعمالهم التي تؤهلهم لها إمكانياتهم العقلية والجسمية، فليس عملهم هذا بأقل قداسة ومكانة من عمل السياسي المناضل والزعيم الموجه.
وتختم حديثها بالنقطة الأخيرة في موضوع الوطنية، فتقول:
أما ثالث المضمونات، فهو الحكم بأن الشعر لا يملك قيمة ذاتية في المجتمع، وإنما هو واسطة لغايات أخرى. وهذا حكم يتجاهل القيم الحيوية التي يملكها الفن في حياتنا الإنسانية بمعزل عن موضوعه. وأول هذه القيم أن الفن شحذ لملكات معينة في الإنسان لا يعقل أن الطبيعة كانت عابثة عندما أوجدتها. وثانيها ما يراه الفيلسوف الفرنسي (جان ماري غويو) من أن الفنون كلها وسيلة لإنفاق الفائض من الطاقة الإنسانية الذي لا بد له أن ينفق، فإذا قضى المجتمع على الفن أدى ذلك إلى أن تختزل طاقة متفجرة في الذهن الإنساني دون أن يجد منفذًا، وهذا لا بد أن يؤدي إلى نوع من فقدان التوازن بين الحياتين الحركية والنفسية، وهو أمر مضر بالحياة.