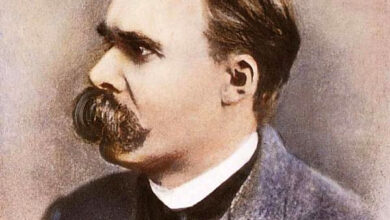علاقة الجمال بالثقافة عند د.ملاك نصر
د. ملاك نصر. محاضر في الدراسات الدينية والثقافة -جامعة فيجن إنترناشيونال، كاليفورنيا. باحث إعلامي وثقافي.كاتب صحافي
قال في مقدمة كتابه (الجمال في زمن القبح):
عالمنا يعيش ” أزمة جمال ” رغم الهوس المحموم بالجمال.
و زمننا – كزمن للتغيير نحو الأفضل – يسعى إلى جمال الناس و المجتمع و السياسة و الأخلاق، بعد كل القبح الذي أصاب مساحات كثيرة من حياتنا و ربما نفوسنا.
في الفصل الأول المُعنون بـ “الجمال و ثقافتنا: أحمر الشّفاه يُغطي الإحساس بالنقص“، تطرّق إلى العلاقة بين الجمال و ثقافتنا الشائعة و تأثير ذلك على نفوسنا و فكرتنا عن أنفسنا بل وعلاقتنا الاجتماعية و تحدث عن قصّة الجمال مع الثقافة من الفيلسوف (أفلاطون) إلى نجم السينما (ليوناردو دي كابريو) و كيف وصل الحال بوسائل الإعلام أن تجعلنا نكره أنفسنا و أجسامنا فصرنا نعاني من الخوف من القبح في زمن يدّعي الجمال!
إن للجمال و ثفافة الجماهير، حيث الشاشات الملوّنة و الصفحات المصقولة و المواقع الإلكترونية، علاقة غريبة مثيرة للتفكير. فقد أصبح الجمال – كقيمة من القيم العليا للحياة – مشوّهاً بسبب ثقافة الجماهير خاصّة في جانبها الإعلامي! و صارت هناك نقطة معتمة في أنصع القيم و أكثرها إشراقاً: الجمال. كما تحوّل الجمال في كثير من أشكال ثقافة الجماهير إلى سلعة تُنتج و يتم تصنيعها بأدوات و إبداعات تلك الثقافة.
يسرد لنا أهم ملامح قصة علاقة الجمال بالثقافة في ثمانية نقاط وهي:
أولاً: الجمال من (أفلاطون) إلى (ليوناردو دي كابريو):
بدأت قصة الجمال مع الثقافة الإنسانية من خلال الثقافة اليونانية و معها بدأت قصة “علم الجمال” عند كبار الفلاسفة اليونان، و لعل أكثرهم في تناول الجمال كقضية مهمة تمسّ الحياة كان (أفلاطون) في محاورته “فايدروس أو عن الجمال“. و هناك قول لهذا الفيلسوف عن الجمال و الرجل يقول فيه:
“ الأمنيات الثلاث لكل رجل: أن يكون بصحّة جيدة، غنياً بوسائل مشروعة، و جميلاً “.
كما اهتمت حضارات أخرى قديمة بفكرة الجمال، خاصة الرجل، فقد اهتم الفنانون في الحضارة المصرية و الإغريقية و الرومانية. بمعايير الجمال لدى الرجل و التي استمرت فيما بعد في أعمال فنيّة كثيرة بالحضارة الغربية الحديثة. ووُضعت تلك المعايير لجمال الرجل على أساس الطول الفارع ( أكثر من 6 أقدام ), والذراعين الكبيرين، والعضلات المفتولة البارزة في الكتفين، و الأرجل الطويلة و الرأس المليء بالشعر الكثيف و الجبهة العريضة كعلامة على الذكاء، و العيون الواسعة التي تقف على بوابتها رموض كثيفة مع الفم الصغير كبوابة لفك قوى الأسنان. وصارت تلك المعايير هي المقياس الأوحد لجمال الرجل، وتلقفتها الحضارة الغربية أوقات كثيرة على أنها مقاييس الرجول المثالية. و الغريب أن تلك المقاييس لجمال الرجولة ظلت باقية لعصور طويلة بل تختفي و تعود مرةً أخرى …
كما نستطيع أن نلمس تلك المقاييس للرجولة المثالية كما تقدمها لنا ثقافة الجماهير من خلال “هوليوود” في عصرها الذهبي في الثلاثينات و الأربعينات و الخمسينات من القرن الماضي، حيث قدمت لنا “أيقونات” رجالية أو أبطالاً سينمائيين أمثال (جاري كوبر) و (تايرون باور) و (كاري جرانت)، و غيرهم من الذين كانوا يتمتعون – بل جعلوهم يتمتعون- بالمقاييس الكلاسيكية للجمال أو الرجولة.
و اليوم، لم يعد كثير من نجوم هوليوود يتمتعون بتلك المقاييس الكلاسيكية، و لكن ثمة مقاييس أخرى الآن موجودة على وجوه و أجساد نجوم أمثال (براد بيت) و (مات دامون) و (ليوناردو دي كابريو) و غيرهم.
ثانيًا: متجر كبير .. للجمال و النجوم:
صرنا في زمننا هذا “نخضع لإغراء متواصل و لنماذج جمال مصطنعة“، على حد تعبير واحد من أهم المفكرين المعاصرين المهتمين بالجمال و هو عالم السيميولجيا و الروائي الإيطالي (إمبرتو إيكو) و قد أطلق هذا الحكم بمناسبة صدور كتابه “تاريخ الجمال” في حوار له مع مجلة ” كي لير – Quee Leer ” الفرنسية حول الجمال كقيمة، و كيف تحولت و تبدلت تلك القيمة في تعريفاتها مراراً و تكراراً بفعل الثقافة و الإعلام. و حول تجديد معيار الجمال اليوم, يرى أن عصرنا يتميز بتعدد نماذج الجمال. فمن ناحية نجوم الجمال اليوم. يرى أن عصرنا يتميز بتعدد نماذج الجمال .. فمن ناحية نجوم الفن و الإعلام في أقصى تطرف للجسد الإنساني مثل (أرنولد شوارزنيجر)، ومقابله الجسد النحيل لنجم هوليوود الكلاسيكي (فريد استير)، فهما نموجان للجمال مختلفان جداً، و كلاهما مقبول. إذن – في رأي (إمبرتو إيكو) لم يبق هناك نموذج ثابت دائم للجمال فنحن نجد أنفسنا أمام “متجر كبير للجمال” حيث يشتري كل شخص مايشاء. و لم يبق هناك نموذج كلاسيكي أو نخبوي للجمال. ما يجعل هذا الشرك خطيراً – في نظر (إمبرتو إيكو) – لأنه سيجعل هناك دائماً الأحدث في الجمال، أي الجديد الأكثر جدّة، فما كان رائجاً بالأمس لن يكون هكذا بالغد.. لذلك، فنحن نعيش تحت الابتزاز أكثر بكثير من إنسان عصر النهضة، فإنسان عصر النهضة لم يكن يرى من الجنس الآخر سوى الوجه و الباقي كان محجوباً.
اليوم نحن خاضعون لابتزاز النماذج المعروضة علينا، بيد أنها سطحيّة جداً، فحتى أجمل عارضة أزياء هي في الحياة و في الواقع أقل جمالاً من الصورة. نحن خاضعون لإغراء متواصل، إنما لنماذج جمال مصطنعة.
ثالثًا: إعلام التجميل .. في مجتمع الشيخوخة المبكرة:
في عصرنا هذا، حيث زمن القبح بأنواعه الكثيرة أصبح كل شيء “يشيخ” بسرعة شديدة خاصة في مجتماعتنا العربية. الجمال أيضاً صار يشيخ أمام هول البشاعة المنتشرة الآن على الشاشات التي نقل أحداثاُ واقعية لم يكن أخصب خيال ليصل إليها يوماً مّا. و من خلال ضغط هذه الشيخوخة المبكّرة على الوجوه و النفوس و العقول يأتي هوس التجديد و التجميل – تجميل الوجوه و الأجساد على الشاشات الفضية و الملوّنة و الافتراضيّة، من خلال برامج لاحصر لها تتسابق على تغيير ملامح المشاهدين نساءً و رجالاً أيضاً.
لقد بدأت ظاهرة إعلام التجميل منذ صدور الإعلام المطبوع في وطننا العربي عندما صدرت المجلات و تحديداً النسائية بالقاهرة و بيروت و عواصم أخرى. حيث كانت تخصص تلك المجلات زوايا أو أبواباً متخصصة في التجميل تقدم فيها نصائح عملية لكيفيّة التزيّن عند النساء.
ثم تطورت الأمور و صارت هناك مساحات أوسع للتجميل و الأزياء و خطوط الموضة للنساء. ثم تطورت الصحافة التجميليّة لتصدر مجلات متخصصة فقط في فنون الماكياج و الأزياء و الموضة، و صارت تُطبع بالآلاف لتوزع في شتى البقاع العربية بما فيها المناطق الريفيّة التي لا تعرف فيها المرأة التجمّل إلا بالوسائل التقليديّة الشعبيّة و ليس بمستحضرات التجميل الصناعيّة.
و مع بداية الإعلام المرئي صارت هناك برامج عامّة للمرأة فيها فقرات خاصة بالتجميل، ثم تطوّر الأمر إلى تخصيص برامج نسائية كاملة قائمة على عالم التجميل و الماكياج و خطوط المرأة. و بظهور الفضائيات العربية الخاصة بدأت الثورة الحقيقية الخاصة بما يكن أن نسميه “إعلام التجميل المرئي” التي قادت هذه الثورة التجميلية ليس فقط على الشاشات و بشكل نظري مرئي، بل بشكل عملي داخل العقول و البيوت و على الوجوه.
لقد جاءت الفضائيات العربية باعتبارها واحدة من أهم القوى الضاربة المؤثرة لثقافة الجماهير لتنشر “ثقافة الجمال” و هي ثقافة مطلوبة و مرغوبة لأسباب اجتماعية كثيرة.
كما أن المرأة الشرقيّة أو العربية تحديداً تهمل كثيراً ( أو كانت تهمل ) في مظهرها و جمالها لحساب مسئوليتها الكبرى تجاه أولادها و زوجها. لذلك جاءت برامج التجميل بانتشارها الكبير لكي تلفت انتباه المرأة إلى فكرتين على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمرأة و هما: الجمال و الشباب. فالقبح و الشيخوخة هما عدوا المرأة الأساسين. لذلك تفاعلت المرأة العربية بشكل غريزي قوي مع برامج التجميل، خاصة في ظل ظهور موجة جديدة من النجمات/ الموديلات اللاتي يشكّلن الجمال الأسطوري الكامل الذي لا يعرف الخطأ أو القبح أو التشويه، وهذا ماضاعف من الضغوط الاجتماعية الاقتصادية تحديداً على كل من المرأة و الرجل على حد سواء.
و يختم هذه النقطة بقوله:” … أصبح في مجتمعاتنا العربية ما يُمكن أن نسميه “هوس التجميل” المرتبط دائماً بما تبثّه الفضائيات، مع أن مجتمعاتنا هذه تعاني قبحاً شديداً في كثير من الجوانب و التي تحاول الثورات إزالته بشتى الطرق.
و نتيجة للعجلة الدائرة ليل نهار لماكينات تصنيع الجمال الحسّي في مصانع ثقافة الجماهير، يخرج الجمال من ضمن منتجات عصرنا، في شكل “منتج” مصنّع إعلامياً و فنّياً و اقتصادياً. ونتيجة لتصنيع هذا الجمال تصنيعاً مفتعلاً غير حقيقي، صارت ثمّة ظواهر جمالية مرتبطة بالناس في عرصنا، و هي ظواهر تشكل بدورها ثقافتنا عن الجمال و عن أجسادنا بل و عن نفوسنا و شخصياتنا – وهذا هو الأهم و الأخطر – باعتبار أن “صورة الجسد” من أهم مقوّمات صورة الشخصية لدينا حسب أدبيات علم النفس.
و يورد إثر ماسبق سؤالاً بقوله:
رابعًا: كيف يجعلنا الإعلام نكره أجسامنا؟
يجيب على ذلك بقوله: ليس من الغريب أن تؤتى ثقافة الصورة و صورة الجمال تحديداً من كل حدب و صوب في عقليات و طرق تفكير الكثيرين في عالمنا، إلى الدرجة التي تؤدي أحياناً إلى كراهية الإنسان لجسده، أو لجزء معيّن من جسده يتمنى لو أنه يختفي من العالم و الوجود. و لعل هذا النوع من كراهية الجسد مايتحدثون عنه الآن في الدوائر النفسية من عرض نفسي يسمى Body Dysmoraphic Disorder و يشيرون إليه بـ (BDD) و هو يعني عرض أو اضطراب الجسم المشوّه. هذا العرض أو الاضطراب بؤدي إلى نوع من الاكتئاب، لأنه يشغل الإنسان بجسده و يرفضه لإحساسه أن بهذا الجسد عيب مكروه من الآخرين. و تقول التقديرات النفسية إن الشخص المصاب بهذا الاضطراب يفكر في تشوّه جسده أو جزء منه من ثلاث إلى ثمانية مرات في اليوم الواحد – على حد تعبير الباحثة النفسية و الأخصائية في السلوك الإنساني (كاثرين فيليبس) التي ترى أيضاً أن ذلك العرض لايؤدي فقط إلى الاكتئاب بل مشاعر القلق و الإحباط و الخزي. و المثير في الأمر:
إن العلاج لهذا الاضطراب كما تؤكد (كاثرين فيليبس) لا يأتي من عمليات التجميل الجراحية أو علاجات البشرة أو خلافه، لأن ذلك الاضطراب يأتي من أعماق الإنسان حيث الإحساس القوي بتشوّه جسده.
خامسًا: التمييز الجمالي: في زمن حقوق الإنسان:
هناك تعريف لما يُسمى “الناس الجميلة” في ثقافة الجماهير الآن، و هو يستخدم لتعريف هؤلاء الأشخاص القريبين في مقاييس جمالهم من الاتجاهات الجديدة في الموضة و الفن و الإعلانات و الميديا بكل أشكالها.
وفي الغالب تكون نماذج تلك الاتجاهات من هؤلاء الأشخاص أصحاب القدر الكبير من الثراء أو النجومية أو التأثير في المجتمع مثل الفنانين و رجال الأعمال و لاعبي كرة القدم أو الرياضة عموماً إلى جانب الموسيقى و نجوم المجتمع.
و “الناس الجميلة” عادةً هم هؤلاء الذين يستمتعون “بصورة” قائمة على المركز الاجتماعي و الذي بدوره يمنحهم النجاح و السلطة و الجمال.
و لكن هذا القصور في تعريف الجمال و بالتالي الجاذبية الاجتماعية ثم القبول الاجتماعي للناس الجميلة، بناءً على المركز الاجتماعي أو المالي أو الفني أو الرياضي، أدى إلى نتائج وخيمة اجتماعية و أخلاقية بل وروحية أيضاً.
ففي الثقافة الغربية نشأ تعبير (Lookism)
الذي يمكن ترجمته بتعبير: “المظهرية” و الذي صار الآن معبّراً عن أدبيات العلوم الإنسانية و الاجتماعية عن “التمييز الاجتماعي و الاقتصادي بل و الجنسي أيضاً بين البشر في المجتمع الواحد، لأنه تمييز قائم على “مظهر” الإنسن و مدى تطابق هذا المظهر مع المقاييس العامة للجمال و المنتشرة في المجتمع بسبب ثقافة الجماهير بكل إبداعاتها“. و بالتالي, ارتبط الآن تعبير “المظهريّة” أو (lookism) بمفاهيم الجمال وعلاقته بالثقافة و “التنميط” بناءً على الدور الاجتماعي للرجل أو للمرأة و التوقعات من ذلك الدور و هي الأدوار التي تتأثر بشدة بمستوى الجمال، للأسف الشديد. و كأن ثمة تمييزاً الآن، بين البشر، ليس على أساس عنصري فقط، بل على أساس جمالي أيضاً.
سادسًا: الهوس بالجمال .. في زمن عقلاني:
عصرنا هو عصر “الهوس بالجمال” مع أنه يدّعي العقلانية.
أصيب عصرنا – المصاب أصلاً بالقبح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الروحي و الديني- بالهوس بالجمال، ذلك الهوس الذي تحاربه الآن الحركات النسويّة بكل قوّتها, و دخل فيما يسمي “حروب الثقافة”
Culture Wars. حيث تنشر الثقافة بكل ما أوتيت من قوّة تكنولوجية اتصالية الاهتمام بالجمال الحسّي الجسدي إلى حد الهوَس.
و كأن عصرنا مدفوع بقوة القبح الجبارة التي تملأ ملامج وجهه إلى السعي المحموم إلى الجمال الشكلي الحسي، تعويضاً عن إحساس لا يهدأ بالقبح الاجتماعي و السياسي و الأخلاقي و الاقتصادي، مادفع بالأجيال الجديدة إلى التمرّد على هذا القبح بالثورات. فالثورات تمرّد صد القبح بكل أنواعه.
سابعًا: (إيزيس)، (فينوس)، (أفروديت) .. أساطير على قيد الحياة:
عصرنا هو عصر الأساطير الجديدة المعاصرة، منها الكثير الذي يخص الجمال، مع أنه عصر يدّعي أنه متديّن. و كأن الإنسان مقدّر عليه صنع أساطيره بنفسه لنفسه، خاصّة فيما يخص الجمال. ففي كل ثقافة على مدار الإنسانية كانت ثمة أسطورة للجمال خاصة بتلك الثقافة، وكانت معظم تلك الأساطير شخصيات أنثوية بالطبع أو آلهة مؤنثة، مثل أساطير إلهات الحضارات الأربع الكبيرة: (أفروديت) في أساطير الحضارة الإغريقية، (فينوس) في أساطير الحضارة الرومانية، (إيزيس) في أساطير الحضارة المصرية، و (رادا) في أساطير الحضارة الهنديّة.
تلك الأساطير أو الشخصيات الجمالية غير الحقيقية، كانت تمثل النموذج الأكمل للجمال في نظر شعوبها آنذاك. و أهم من ذلك كانت تلك الآلهة – إلهات الجمال بكل ما تملأ الأساطير من حكاياتها – شعلة لاتنطفئ تلهب الخيال حول الجمال و بالتالي إشباع الحاجة الشيدة إلى الجمال داخل الإنسان، كما أنها كانت تخاطب الإحساس الغريزي بالجمال.
أما عصرنا الحالي، فهو لم يتهلى عن حاجته لأساطير جديدة مستحدثة حول الجمال و في الجمال و للجمال. و بالرغم من كل نزعته إلى التديّن العائدة بقوة جارفة، إلا أن الحاجة العميقة مازالت موجودة في داخلنا إلى الجمال السّامي، الكامل، النموذج (فالحاجة إلى الجمال صارت ضمن الهرم الشهير للحاجات الإنسانية الأساسية الذي صمّمه عالم النفس الشهير (أبراهام ماسلو)
أخيرًا: الخوف من القبح .. في زمن الجمال:
أظهرت مجلة ” الإيكونومست-Economist ”
في التقرير الخاص حول الجمال و صناعاته أن ذلك التصاعد الهائل في صناعات التجميل و الجمال يعود إلى اللعب على “وتر الخوف” من القبح داخل الناس، في مقابل الإحساس بالسعادة المرجوّة عندما يحصلون على الجمال أو المظهر الجذّاب إلى جانب الاعتماد (في وسائل الإعلام و الدعايات) على النظريات الجديدة لعلم النفس لإقناع النساء بأن إحساساً بالنقص من الممكن أن يزول من خلال أحمر شفاه! مما يجعل من العمليّة كلها مجرّد انتهاك للحقائق بلا رحمة.