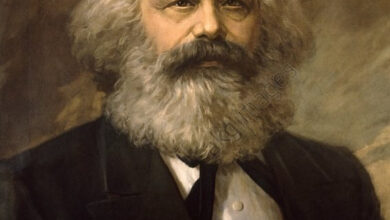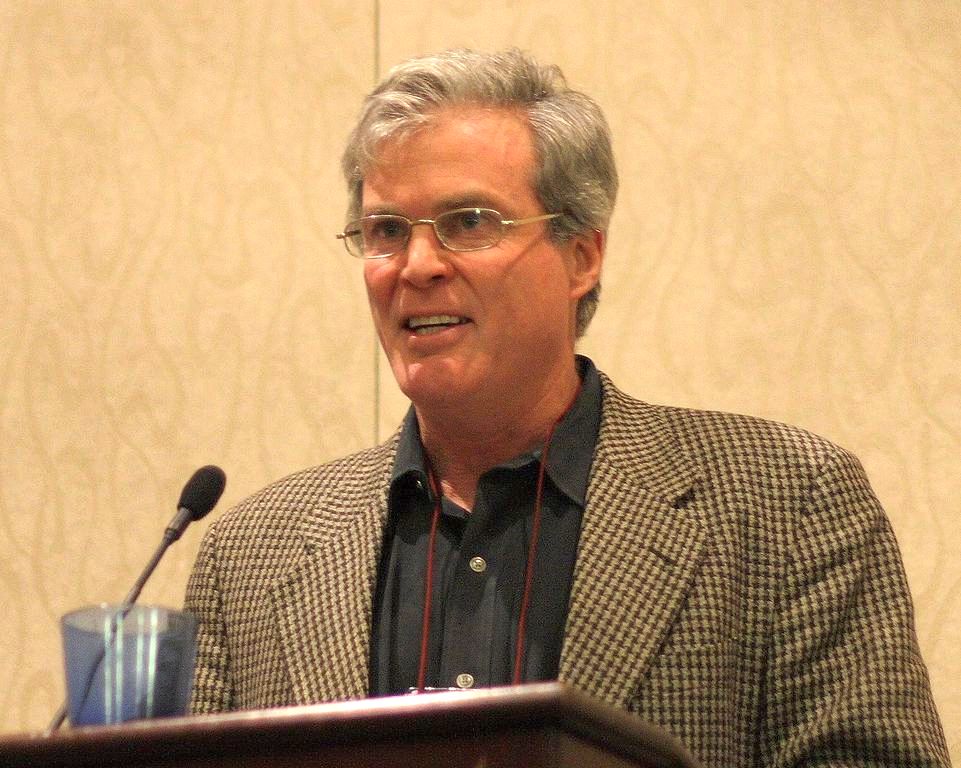ما أهمية (كونديرا) اليوم؟ مقالة مطوّلة مترجمة
في ثمانينات القرن الماضي، كان الجميع يقرأ (كائن لا تحتمل خفته) و(كتاب الضحك والنسيان). لكن الآن وقد قام بنشر روايته الأولى منذ اثني عشر سنة، ما هي سمعة الكاتب التشيكي اليوم، وهل تأثرت فعلا بسبب صورة المرأة فيها؟
في الصفحة الأولى من رواية (ميلان كونديرا) الجديدة التي نشرت في فرنسا السنة الفارطة وقد صار عمر كاتبها 85 سنة، رجل يتنزه في شارع باريسي في شهر جوان، “وقد كانت الشمس تنبثق من بين السحب“. اسم الرجل (آلان)، لكننا لا نعرف شيئا عن عمره ولا مظهره الخارجي، لكننا نعلم أنه مثقف، لأن رؤية سرر [جمع سرّة] الفتيات المكشوفة التي اعترضته في الشارع تلهمه سلسلة من التأملات، كل واحدة من هذه التأملات تحاول أن “تصف وتعرف خصوصية توجه إيروتيكي ما“.
من يمكن إذن أن يكون كاتب هذا المقطع غير (ميلان كونديرا)؟
اثنتان من الاستعارات الأساسية في رواياته حاضران بقوّة منذ الصفحة والنصف الأولى:
أولا، أهميّة النظرة الذكوريّة المركّزة على جسد المرأة، و”المفتونة” به، ثم نسج نظرية دقيقة حوله، انطلاقا مما يرى.
ثانيا: النتيجة التي تأخذنا إليها تلك النظرية، والتي تتجسد في “مركز قوة الإغراء الأنثوي” ليس فقط من وجهة نظر “رجل ما“، بل من وجهة نظر “حقبة زمنية“.
مما يؤكد لنا طموح هذا الروائي، الذي كرّس أعماله من أجل صياغة علاقات وروابط بين الوعي الفردي وبين الراهن والمتغيّرات التاريخية والسياسية.
(حفلة التفاهة) إذن هي بالتأكيد رواية كونديريّة بامتياز، إن لم نعتبرها من كلاسيكياته. إنه كتاب لكاتبٍ شيخ، وبما أنه يحتوي على وميض مؤشرات على ضرب من النشوة والحكمة المرحة، سيكون من المفاجئ ألا تتضمن روحا خريفيّة.
في لمحة على أغلفة روايات (كونديرا) في دار فابير للنشر Faber editions نجد مجموعة من أقوال الإطراء التي كتبها كلّ من (إيان ماكيوان) و(سلمان رشدي) و(كارلوس فوينتس)، وأغلب هؤلاء قد تخطّى العقد الثالث من العمر، حيث يذكّروننا أن شهرة الكاتب كانت في ذروتها في الثمانينات، عندما كان الجميع يقرؤون (كتاب الضحك والنسيان) و(كائن لا تحتمل خفته).
لم بدت تلك الكتب ضرورية ولا غنى عنها في ذلك الوقت؟
هل كان ذلك لملاءمتها بصفة عابرة لروح العصر آن ذاك، أم أنها تحتوي على شيء أكثر متانة وقدرة على الاستمرار؟ كيف سيحكم التاريخ إذن عليها؟
من المنصف القول أن سمعته ستبقى دائما مرتبطة برواياته الكبرى الثلاث، التي كتبها في المرحلة الوسطى من مسيرته وهي: (كتاب الضحك والنسيان)، (كائن لا تحتمل خفته)، و(الخلود).
قبلها، كان هناك ثلاث روايات ساخرة وهي: (المزحة)، (الحياة في مكان آخر) و(فالس الوداع)، والتي استدعى فيها بشكل واضح أجواء ما بعد الحرب والحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا، دون أن يغفل فيها عن إضفاء النفس المميّز لأعماله عليها.
بعد ذلك، نجد ثلاثية متكوّنة من ثلاث روايات كتبها على شكل نوفيلات صغيرة؛ وهي (البطء)، (الهويّة)، و(الجهل)، والتي تدل عناوينها على منحاها الفلسفي إلى جانب طبيعتها كأعمال روائية متخيّلة.
تلك الكتب التي كتبها في أواسط مشواره، هي الشاهدة على عثور (كونديرا) ليس فقط على صوته الروائي الفريد، بل وكذلك الأسلوب الأمثل. إنها روايات الاغتراب، المكتوبة في المنفى.
غادر (كونديرا) تشيكوسلوفاكيا سنة 1975 بعد أن تم تسريحه من وظيفته كمدرس وحرمانه من حقه في العمل، ومصادرة رواياته من المكتبات العامة، وقد تزامن قدومه إلى باريس مع حصول تغيرات هامة في التوجه الأدبي.
تخلّى (كتاب الضحك والنسيان) عن الاسترسال التقليدي لخط السرد، واكتشف عوضا عنه، تركيبة من الحكايات المترابطة في ما بينها، من خلال حضور بعض الشخصيات أحيانا، لكن بشكل أكبر، من خلال تواتر مجموعة من الثيمات والمصطلحات، والرموز ..
كان (كونديرا) مع مغادرته بلده الأم وكأنه قد حرر نفسه كذلك من قيود الكتابة التقليدية، وقد اتسمت الرواية بانسيابية لافتة، وبهدوء لذيذ في انتقالها من سرد للأحداث إلى أسلوب كتابة المقال، ثم العودة إلى السرد.
عدم الفصل بين الشكل والمضمون: يعتبر من أهم الأشياء التي يمكن أن نتعلمها من أعمال (كونديرا).
في كتابته في نوفيلا (البطء) عن أشهر كتب (بيير شادرلو دولاكلوس)، يفكر (كونديرا):
الطريقة التي كُتبت بها العلاقات الخطرة في شكل سلسلة مراسلات، ليست محض طريقة تقنيّة يمكن استبدالها بأخرى بسهولة. الشكل هنا إذن هو ناطق عن نفسه، ويخبرنا أن كل ما تعيشه الشخصيات، إنما تعيشه من أجل أن تتحدث عنه، وتنقله وتعترف به وتكتبه. في عالم كهذا، حيث يقال كل شيء، يصبح السلاح الأكثر توفرا في المتناول والأكثر فتكا هو الإفصاح.
هذه الملاحظة بالطبع لا تصدر فقط عن مؤرخ أدبي فذ، بل عن شخص عاش تحت رقابة البوليس السري. الكتابة، وما يمكن أن “تفشي” عن الكُتّاب، تمثل إحدى أكثر المواضيع الملحّة في أعمال (كونديرا)، منذ ظهور (المزحة).
في (كتاب الضحك والنسيان)، تعيش (تامينا)، وهي مهاجرة تشيكية، في مدينة غربية غير مسماة، وهي مستعدة لفعل المستحيل في سبيل أن تستردّ إحدى عشر وثيقة من مذكراتها الضائعة التي تركتها في بلدها الأم، لكنها تواجه في المقابل عراقيل كثيرة لعل من أهمها عدم قدرة الغربيين على فهمها: “من أجل أن تسهّل فهم الناس هنا لأي شيء عن حياتها, كان عليها أن تقوم بتبسيط الأشياء“.
تعمد إذن إلى إخبارهم أن المذكرات المقصودة هي عبارة عن “وثائق سياسية“، والحال أنها لم تكن سوى كتبا لذكرياتها، كانت تريد استعادتها ليس لأسباب سياسية، وإنما بسبب إحساسها بأن ذاكرتها عن حياتها السابقة قد بدأت تتلاشى، وهي بذلك تأمل في أن “تعيد لها جسدها الضائع. ما يدفعها لفعل ذلك ليس الرغبة في الجمال، بل هي الرغبة في الحياة“.
من خلال هذه القصة، والقصص الأخرى المرتبطة بها، يسلط (كتاب الضحك والنسيان) الضوء على نقاط في حياتنا حيث تتقاطع الهويّة، بكونها البناء المكوّن لذواتنا عن طريق الذاكرة، مع القوى السياسية التي هي في صراع معها.
إنها ثيمة لا يمكن فصلها عن سياق الظروف التي عاشها (كونديرا)، وهي الحقبة الشيوعية السوفييتية، وهو سياق كان قد فتن، وفي بعض الأحيان أربك المراقبين الغربيين في السبعينات والثمانينات، وهو ما فتحت عليه روايات (كونديرا) نافذة فريدة، من خلال عرض تعقيداتها بأسلوب ساخر لا مثيل له، وسوداويّة وصرامة فكريّة كبيرة.
في أعقاب تلك الروايات، أتى كتاب آخر كان من بين مهامه أن يفسرها: (فن الرواية)، وهي مجموعة متكونة من سبع مقالات طرح (كونديرا) من خلالها تصوّره عن التقاليد الروائية الأوروبية وموقعه هو ضمنها.
النص المفتاح الذي استعمله في تحليله هذا كان (السائرون نياما)، لـ(هيرمان بروخ)، وهي ثلاثية روائية كان القليل من القراء البريطانيين يعرفونها في ذلك الوقت، ولعلهم صاروا أقل بكثير في أيامنا هذه، إذ لم يعد حتى في مقدور القارئ أن يعثر على نسخة مطبوعة منها في بريطانيا اليوم.
في هذه الكتب، قدّم بروخ كذلك تركيبة متكوّنة من عديد الأساليب المختلفة، التي رآها (كونديرا)؛ “تعددا في العناصر، كالقصيدة، والسرد، والأقوال المأثورة، والروبرتاج والمقالة. وهي بذلك تشكل توليفة بوليفونية متماسكة“.
على ضوء ذلك، فإنه من الصّعب ألا نلاحظ أن جميع أعمال (كونديرا) التي كتبها في المهجر، كانت عبارة عن محاولة، وقد كانت ناجحة، لمواصلة المشروع الذي بدأه (بروخ)، بما أنّ عمله الخاص على مزج تلك العناصر كان على حد كبير من السّلاسة والإقناع.
لكن هل حقق كونديرا ذلك على حساب شيء آخر مهم، وهو الحقيقة السيكولوجية عن الحياة؟
“رواياتي ليست روايات سيكولوجية“، يؤكد في كتاب (فن الرواية).
“هي بصفة أدقّ تقع خارج الحقل الجمالي للرواية المصنّفة عادة سيكولوجية“.
كان هذا موقفه السّلبي، أي ما لم تكنه رواياته، لكن لمّا كان عليه أن يحدد ماهيتها، كانت إجابته أكثر تعقيدا:
كل الروايات في جميع الأزمنة، هي معنيّة بالبحث في اللغز البشري .. وأنا بتصنيفي أعمالي خارج ما يسمّى الرواية السيكولوجية، لا أروم بذلك تجريد شخصياتي من عالم داخلي نفسي، بل ذلك فقط يعني أن لرواياتي معضلات وأسئلة أخرى تسعى للوصول إليها في المقام الأوّل. إن إدراك الذات في رواياتي يتطلّب الإمساك بجوهر إشكاليتها الوجودية, أي إدراك رمزها الوجودي.
هذا “الرمز الوجودي“، يواصل التوضيح، قد يتم التعبير عنه بواسطة سلسلة من الكلمات المفاتيح. بالنسبة إلى (تيريزا) في (كائن لا تحتمل خفته)، على سبيل المثال، هذه الكلمات هي: “الجسد، الروح، الدوار، الضعف، الأنشودة، الفردوس“.
مفتونين بالذكاء الفلسفي لهذه الرواية، ومن دون شك مأخوذين بالنفس الإيروتيكي فيها، خاصة بالنسبة للقراء الذكور، تقبّل عشاق (كونديرا) استعماله للرمز الوجودي كوسيلة لنحت الشخصيّات، أو حتّى نستعمل مصطلحات أكثر قربا من مجال النقد الأدبي التقليدي، ساهم ذلك في أن ينسيهم ما في الرواية من ضعف في وصف للشخصيات. لكن الحال أنّ الشخصيات لطالما عاشت في ذاكرة القارئ أكثر من الأفكار.
منذ سنوات قليلة في هذه الصّحيفة، كتب (جون بانفيل) مقالا مهما يعيد فيه تقييم (كائن لا تحتمل خفته) بعد عقدين من صدورها. النبرة التي تكلم بها كانت شغوفة لكن مع بعض الرّيبة: “كنت مندهشا من قلّة ما استطعت تذكره“، يقول أيضًا: “كما يحيل العنوان، لقد انساب الكتاب خارجا من ذاكرتي كما لو كان بالونا مملوءا بالهواء الساخن ينسلّ من حبله ويحلق بعيدا … لم أستطع الاحتفاظ بأي شيء عن الشخصيات، ولا حتى أسماؤها“.
لكنه اعترف أن الرواية استطاعت مع ذلك أن تحافظ على أهمّيتها السياسية، حيث أضاف: “لكن أهميّتها (السّياسية) في المقابل لا يمكن مقارنتها بالإحساس بالحياة، والتي لا يمكن أن ينقلها لنا سوى العظماء من الرّوائيين“.
من خلال كتاباته، لا يبدو أن (كونديرا) يعتبر نفسه جزءا من تلك الزمرة من “الروائيين العظام” التي أشار لها (بانفيل) ضمنيا، فالعديد من الروائيين المفضلين لديه؛ (ستيرن)، (ديدرو)، (بروخ)، (موزيل)، (غومبروفيتش)، ينتمون فعلا إلى ذلك الاتجاه في الكتابة الساخرة والمبهمة، التي تتحمّل أكثر من تأويل، والتي يكون فيها الكتّاب أنفسهم واعين تماما بكل ضروب التناقضات والانزلاقات والآليات التي تنطوي عليها عملية خلق العوالم المتخيّلة، ما يجعل من كتبهم في مرحلة ما، أعمالا مضادّة لنفسها، أو على الأقل تقوم باستجواب نفسها.
الشخصيات النسائية في روايات (كونديرا)
من هنا تبدو لنا مكانة كونديرا ضمن هذه النخبة من الكتاب العظام مضمونة، مع ضرورة التنبيه إلى تفصيل مهم، وهو أن روح “الإحساس بالحياة” غائبة بطريقة لافتة في تصويره لشخصياته النسائية.
لطالما قامت الحركة النسوية باتهام (كونديرا)، لكن تلك التهمة لم تبلغ أوج بلاغتها إلا مع (جوان سميث) في كتابها Misogynies أو (كراهية النساء) حيث تتمسّك أنّ “العداء هو الصّفة الأساسية في ما يكتبه (كونديرا) عن النّساء”.
ومضت الكاتبة في ضرب أمثلة عدّة، من بينها تلك التي جاءت في (كائن لا تحتمل خفته) وفيه يتحدّث الراوي عن لقاء سري جمعه بناشرة بإحدى المجلات، كانت بنشرها لمقالاته تعرض نفسها للخطر.
ولأنّها متوتّرة بسبب هذا اللّقاء، تفقد الناشرة السيطرة على أحشائها، تدخل الحمام بصفة متكررة. كردة فعله حيال ذلك، كان الانطباع الذي أبداه الراوي غريبا وصعب التفسير: “رغبة جامحة في اغتصابها .. أردت أن أحتويها كلّيا، بخرائها وبروحها العصيّية على الوصف”
لا شك أن هذا المقطع متهجّم، لكنني شخصيا أراه إدانة للرجال أكثر من أي شيء آخر!
في مقابل أمثلة الإدانة التي قدمتها (سميث)، يتوجّب علينا أن نعرض عدد من الشخصيات النسائية خاصة في الروايات الأخيرة لـ(كونديرا)، حيث تبدو هذه متساوية في حضورها مع الرجال.
بالنسبة لي فإن رواية (الجهل) هي بشكل ما المفضلة لدي من بين أعماله الأخيرة، لعدة أسباب لعلّ أهمها كون بطلتها (إيرينا)، وهي شخصية مركبة ومرهفة، يقدّم لنا سلوكها في المنفى بمزيج من الهزل والتعاطف. لكن حتى هنا، في نهاية الكتاب، تبدو لنا الصورة النهائية لـ(إيرينا) متلصّصة والتعامل معها يكون كشيء لا كشخص. (voyeuristic, objectifying)
حيث تنام عارية “مباعدة بين ساقيها بلامبالاة“، بينما يثبت عشيقها نظره على ما بين فخذيها و”يراقب لوقت طويل ذلك المكان الحزين“.
لماذا يشعر (كونديرا) بالحاجة لعرض نسائه بهذا القدر من الدقّة والقسوة؟
وانطلاقا من ذلك، كيف كان له أن يكتب كتابا من 150 صفحة عن الرواية الأوروبية دون أن يذكر فيه أيّ روائية باستثناء (أغاثا كريستي)؟
لا أستطيع منع نفسي من التفكير، في أنه إذا كان هناك ما يمكن أن يقوّض سمعة (كونديرا) في المستقبل، فلن يكون ذلك أي غياب لـ”الإحساس بالحياة” في رواياته، أو كون أعماله قد تبلورت في ظروف سياسية قد يتم نسيانها؛ بل سيكون ذلك طغيان المركزية الذكورية لديه.
لقد تجنبت كلمة “العداء للنساء” لأنني لا أعتقد أنه يكره النّساء، أو أنه معادٍ لهم بشكل ثابت، لكنه حتما يرى العالم من وجهة نظر ذكورية خالصة، وهذا يمثل نقيصة تؤخذ عليه، رغم ما استطاع أن يحققه من انجازات كروائي وككاتب.
لحسن الحظ، تعتبر (حفلة التفاهة) الأقل تشوّها بهذه النزعة من بين كل ما كتب تقريبا، ورغم أنها ليست عملا جوهريا في مسيرته، لكنها قد تمثل نقطة جيّدة للإقبال مجددا على قراءته، بالنسبة لمن نفروا في الماضي من الإشكاليات الجنسية، السياسية، والتي جعلت حتى أفضل كتبه تنطوي على تلميحات غير مريحة.

[المصدر]