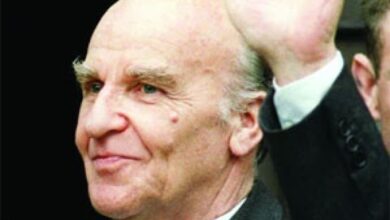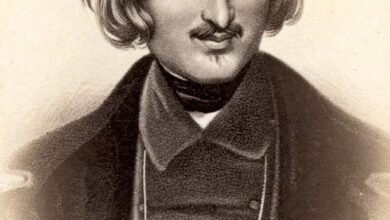لمَ قد تغدو العبقرية مشكلة؟ القصيمي أنموذجًا
"لا تستطيع الإمساك به، فهو صراخ يقول كل شيء ولا يقول شيئًا"
“أنا أوجد لكي أتحول إلى مشكلة، لكي يصبح كل نضالي مقاومة لهذه المشكلة .. إن وجودي كإنسان ورطة فيها كل معاني العقاب والصدمة، وليس تمييزًا في شيء من معاني التفضيل أو التكريم، و لهذا فجميع نشاطاتي ليست إلا مواجهة لهذه الورطة ..”[1]
إن الطفولة القاسية والفقر المدقع، والعيش في كبد الصحراء الزاحفة وغلظة السلطوية الأبوية في التطبيق المظهري للتدين فضلًا عن الحرمان من أبجديات حقوق الطفل؛ كالاستقرار والحنو والرعاية، لاشك أن طفولة كهذه ستترك أخاديدًا في أعماق صاحبها؛ طال عمره أو قصر.
ولكن قد يدفع هذا الاحتمال، اعتبار ان ذلك كان وضعًا سائدًا اشترك في مقاساته أغلب أبناء جيله وأجيال تلته، و قد تكبد وقاسى كثير منهم دون أن يحملهم ذلك على التمرد والجنوح، إلا أن هذه الغضبة الشعورية، إن وافقت نفسية عصية، باحثة عن الذات، عبر مراحل الوثبات الجريئة بين أسفار الحياة بدأت منذ طفولته بحثًا عن كنف آمن لدى أب مهاجر، ولكن لم تقف رحلته عند شعوره بالغبن والإحباط من جراء جفوة اللقاء وقسوة التعامل، بل كانت نقطة بداية بحث ورحلات وتحولات من نوع آخر.
إن للشخصية المتمردة، إذا صاحبها تفوق في عمق الفهم، وتفرد في الألمعية الذهنية، واستثناء في الانفتاح على الثقافات من الفنون والمعارف و التجارب، أضف إليه عنصر الانبهار بالمفارقات الحضارية، و فوق ذلك مزية الانزلاق من قبضة السلطة الجمعية، لاشك سيترتب عليها ظهور شخصًا ثائرًا محتجًا متمردًا مثل (عبدالله القصيمي):
أنا احتجاج أنا رفض دائم، أنا لست مذهبًا، لست معلمًا، لست صانع قيود”
إن الإنسان أشياء كثيرة تمر كلها من طريق واحد هو شعوره؛ نحن نحيا بالشعور ونموت بالشعور، نحن نقتات بالشعور ونجوع لفقده، إن الخبز ليس إلا شعورًا، ليس الخبز إلا شعورًا متحولًا” [2]
وأنا هنا لست معنية بإحصاء أو حتى إنكار عدد المسائل الجوهرية التي تجاوز فيها الحدود بالمساس بمنزلة قداسة الألوهية المصانة من الله -تعالى عما يقولون- لاسيما في مجموعة كتبه الأولى بعد الانعطافة القصوى في فكره، كما اني لا أنهى عن شيء وآتي بمثله حين أحكم على الناس، دون أن أشق عن بطونهم! والناس يتوقع منهم المراوحة بين الجنوح والعدول طالما أنهم على قيد الحياة، و الله تعالى وحده من استأثر بالاطلاع على خبايا أسرارهم ومعاطف نواياهم وخواتيم حياتهم، و آمل أن أحظى عبر منصة ساقية بقراء من ذلك النوع المتجرد الواعي والنزيه الباحث عن الحقيقة، و لا أهدف البتة ذلك الصنف من المفتشين “المباحثين” عن قرائن تصدق ظنونهم و تؤيد أوهامهم وشكوكهم، وتشفي قلوبهم المرتابة، ونفسياتهم الغضبى، كل ذلك يفعلونه تحت غطاء حراسة الدين و الغيرة عليه.
موضوع مقالتي محاولة بدائية للانفتاح على إرث صنعته عقلية جموحة ناقدة فريدة، انقادت وراء ثورة غضبية طالت بشررها قوانين الممنوعات وأبعاد المحظورات، هذا من جانب و من جهة أخرى للاستئناس بما أعتنقه شخصيًا من تأثير مجموع الطبيعة النفسية، والتركيبة العقلية، و درجة الكثافة الحسية للأشخاص، هذا فضلًا عن دور رئيس تلعبه طبيعة المعاملة الأبوية فيما يقع لاحقاً من هؤلاء في تفاوت علاقتهم بكل ما يمثل السلطات العليا ودرجة صبغة تدينهم، قربًا وبعدًا، وفي اختياراتهم الوعاء المناسب لمنظومة الأفكار والرؤى والقيم؛ فهم إن شاؤوا وقع اختيارهم على ما يمثل ذواتهم حقيقة، و إن شاؤوا وقع اختيارهم على ما اختارته لهم مجتمعاتهم، وكذلك إن شاؤوا اعلنوا جنوحهم ورفضهم وإنكارهم لهذا وذاك. وقد اختاروا لأنفسهم قوالبًا يمليها عليهم شعورهم ودرجة وعيهم ومستوى ذكاؤهم. إن البدايات الشعورية هي من تسهم في رسم حدود و أبعاد المساحة التي يسمحون لأنفسهم بالتجوال فيها أو الاكتفاء بالمسافة الضيقة جداً والتي تفصل بين الإنسان ونفسه، وتعكس في الحقيقة علاقة الإنسان بنفسه.
إليكم قائمة بعدد من أبرز المقدمات، بعضها يعود إلى (القصيمي) نفسه وبعضها إلى الجمهور العربي العريض:
١. الاعتماد على البعد العقلي وحده في الحكم على الدين و كشف ألغاز الكون و الحياة:
إن العقل مظهر للكرامة البشرية وميزة لبني آدم، ولكن الاتكاء على العقل وحده، في مهاراته الفكرية، وتحليلاته المنطقية، وتصوراته الذهنية، وخبراته البشرية، وتقديمه كميزان يزن به حقائق الدين و يختبر به ثوابته، ويستند عليه في التشكيك في مصادره، كما يتكئ عليه وحده للعثور على إجابات مقنعة على أسئلته الوجودية وعوالمه الغيبية .. كل ذلك يفضي بصاحبه إلى أن يصطك بعوازل متينة من الغموض تضخ بداخله مزيدًا من التناقض والشك والرفض والقلق، فـ(القصيمي) وإن طرح سؤالاً صحيحاً إلا ان وجهته غير صحيحة؛ إذ السؤال الحقيقي حينما يطرح، لا ينبغي أن يقف مترقبًا الإجابة من عقله!
إذ العبقري والمبدع تأتيه الإجابات والإلهامات من عالم الغيب اللامرئي، إني أجزم بأن الذي حال بين (القصيمي) على الرغم من حدة ذكائه من أن يخرج للأمة بمشروع عبقري ينهض بها، هو أنه وقف على أعتاب العبقرية ولكن لم يطرق باب السماء بتواضع وإخبات وتسليم، بل بقي هناك ينتظر من عقله وحده فك الرموز والعثور على الإجابات؛ ففي سياق إجابته على السؤال ما مكانة العقل و هل يصلح أن يكون حكمًا على الأشياء؟ وبعد عرض أصناف الناس تجاه النقل والعقل، يعقب بقوله:
ومن الكلام الشائع أن الناس يعتقدون ثم يفكرون، وهذا غير صحيح حتمًا، والصحيح أن الناس يعتقدون ثم لا يفكرون، أو يفكرون فيما يجعلهم لا يفكرون، لأنهم بعد الاعتقاد لا يعرضون على الفكر للنقد والاختبار والدراسة، وكل ما يفعلون أن يستعينوا بالعقل على تقوية اعتقاداتهم وزعمها صحيحة، إنهم يسخرون العقل لخدمة ما ليس عقلًا يسخرون العقل لإخماد العقل. [3]
وفي مواضع أخرى يصف الشقاء الإنساني:
كم أتعجب حين أرى الناس يسيرون بجنون دون أن يعلموا أو يسألوا الى أين المسير. هل السير وسيلة؟ اذًا ما الغاية؟ إن ماذا يعني ولماذا يتوقف؟ ماذا يعني أن أعيش اليوم لأعيش غدًا، لأعيش بعد غد، لأكرر نفسي في عملية متشابهة لا تعني شيئاً لتنتهي النهاية العقيمة المحتومة.
إن الحياة تشبه أن تضع قدميك في قيد ذي عقد كثيرة ليكون كل عملك واهتماماتك أن تحاول حل هذه العقد، وكلما حللت عقدة لتقوم مكانها عقدة أخرى شعرت باللذة وبأنك قد انتصرت مع أنه لا توجد لذة ولا انتصار وإنما يوجد زوال وألم. [4]
٢. الاجتراء على المساس بمقام الألوهية و الأنبياء والرسل:
ربما أن الحماسة الغضبية قد تتسبب في انزلاق قلم ولسان صاحبها في اختيار عدد من التعبيرات، دون مراعاة لحرمة وبلا بصيرة وتبيان، وإن كان يحفظ للقصيمي ما جاء في مقدمة كتابه (العالم ليس عقلا)[5] حين أورد استدراكًا، و لكن ذلك لم يمنعه من تكرار التجاوزات التعبيرية، يقول في مقدمة الكتاب (العالم ليس عقلا)
دفاع عن إيماني: إيماني بالله والأنبياء والأديان ليس موضوع خلاف بيني وبين نفسي، أو بيني وبين تفكري.
ولا ينبغي أن يكون موضوع خلاف بيني و بين قرائي، إن الحقائق الكبيرة لا تسقطها الأقوال، كذلك الإيمان بالله والأنبياء والأديان من الحقائق القوية التي لا يمكن أن تضعفها أو تشكك فيها الكلمات التي تجئ غامضة أو عاجزة أو حادة لأن فورة من الحماس أطلقتها ، إن إيماني يساوي أنا موجود، إذن أنا مؤمن.
إلى أن قال:
سيجد القراء في هذا الكتاب أمثال كلمات: إله، آلهة، دين، أديان، أنبياء و قد يشعر أحياناً أنها كلمات لا تحمل الاحترام الواجب لهذه الأسماء، إني لا يمكن أن أعني بالإله إله الكون وخالقه، وواهبنا الحياة، والعقل والنور والحكمة، وإنما أعني بذلك الطغاة والأصنام والأوهام أو النظم الاجتماعية المتأخرة.
إلا أن موضع الخلاف ليس قاصرًا على التعبير اللفظي، فهو – كما السبب الأول – لا يزال يستند على التأويل العقلي وحده في قبول واختبار النقل كما في قصة موسى والخضر في القرآن:
فها هو يحلل قصة النبي موسى عليه السلام والخضر فيقول: “إنك تسألني عن قصة دينية، عن تفسير لقصة قد قصها الكتاب المقدس”، ويستطرد بإسهاب في نقد القصة والتشكيك فيها ومما قاله ساخرًا تعقيبا على قتل الغلام وعلى لسان الخضر: “أبها الصديق إنك لم تستطع أن تفهم، كما أنك لم تستطع أن تصمت”! و يعترض في موضع فيقول: “حتى الأنبياء يفاوضون على فقد حرياتهم، ويوقعون على فقدها وعلى شروط فقدها”.
ثم يسترسل متكلاً على المنطق في السخرية من ممارسات ذلك الرجل الغامض القادم من السماء إلى أن يقول:
ولكني امرؤ لا يفاجأ بالتساؤلات ولا يهدي إليه جديد منها، إن كل التساؤلات وكل المتسائلين يعيشون داخلي، إنهم بعضي.[6]
فهنا نقد وتشكيك في المصادر الإلهية، دون تعظيم لجهة، عدته الاستناد على العقل والمنطق الذي ساقه العالم المادي إليه، فالزهو في الغالب يعطل الالتفات إلى صوت الروح وانصياع الفطرة، وطمأنينة النفس؛ وذلك لأن الموافقة والطاعة والقبول هي الأخرى تجئ تعبيرا عن حالة نفسية سوية من الاعتراف الضمني بالقصور عن الكشف والفهم، يرافقه تواضعا حقيقيا يتجسد في أدب التسليم والتفويض لمن هو أعلى مقاما وأقوى سلطة وأوسع علما.
٣. سيادة لغة الإحباط وحالة التشاؤم:
الإحباط الذي يفرضه الواقع يقود إلى الغضب، والغضب بدوره يفضي لمزيد من الغضب؛ فهو إن علا منسوبه وتسلط على كل المشاعر واستلم زمام كل الأحاسيس والانفعالات، يحمل عيني صاحبه على الوقوع على كل ما يثيره و يسوغه و يبرره أيضًا، فكيف لو أضيف لذلك، معارف متعددة، و قدرة عقلية متميزة قادته للكشف عن حقائق المظاهر وبواعث السلوك، وتحليل عميق لمسببات الظواهر، حينئذ فإنه يستثير كل مكامن الإحساس بالذل والاشمئزاز ويوقظ كل مظاهر الحزن والأسى ويرمي محيطه بجرائم الخوف والخنوع وقائمة تجارب واتهامات طويلة تحمل كل المشاعر المتشائمة الساخرة البائسة!
وهذا سبب لا ينبغي تجاوزه في عزوف الناس عن كتبه وأفكاره، إذ جبلت الناس على الإقبال على من يكرم وجودها ويقبل حتى عيوبها، و إن كان هو يفعل ذلك بنية تغيير العالم وإصلاحه، ولكنه لم يحفظ توازنه النفسي إزاء ذلك ولم ينتبه إلى الفرق الكبير بين الاعتراف بوجود مشكلات محددة ومحاولة إصلاحها من خلال طرح متزن، وبين الاستغراق في حالة التشاؤم وجلد الذات، تقرأ له و كأنك تقرأ قطع مقتبسة منسوبة لـ(شوبنهاور) أو (نيتشة):
والذي يتحدث بالتفاؤل والتشاؤم لا يدعو إلى أي منهما وإنما يتحدث فقط عن نفسه، إنه كالذي يضحك أو يبكي، لا يقصد ولا يستطيع أن يعلم الآخرين الضحك أو البكاء، فهو لا ينطوي على معنى النبي ولا على معنى الشيطان، وكل صاحب رسالة ليس إلا ضاحكًا أو باكيًا، أي ليس الا معبرًا عن نفسه، والآخرون بالنسبة له ما هم إلا أدوات التعبير ومجاله ليسوا إلا أدوات الضحك والبكاء. [7]
٤. الناحية الأدبية:
يؤخذ النقاد على (القصيمي) كثرة كلامه وتكرار معانيه، واسترساله إلى الحد الذي أوقعه في التكرار، وتسبب في ملل القراء، وضجرهم.
ومما نعلم أن تفاقم حالة الغضب وثورانه يحمل صاحبه على تصريف بعض حممه بالإكثار من الكلام، وإن سوغه بالنقد الهادف والشجاعة في تعرية الواقع وأحيانًا بالتعبير عن التعاطف من خلال الشعور بالحزن والضجر على الواقع البائس: ففي ملخص من حديث طويل ومكرر له عن الكلام يقول:
لقد ماتت الكلمة، ماتت منتحرة، ماتت بلا شرف، كل الناس يحولون آلامهم ومتاعبهم وجهلهم وكذبهم وحقدهم إلى كلام كل الناس يتكلمون لا حساب ولا صدق ولا عدل ولا محبة، ولا علم ولا ذكاء .. إنها الوعاء لفضلات النفس. يتكلمون لأنهم دائمًا ينفعلون .. إن الكلام هو دائما تفسيرا للمتكلم، ولعل البشر لم يخترعوا الكلام ليقولوا الحقيقة، أو ليبحثوا عنها، أو ليستعملوها لذلك، ولكنهم اخترعوه وظلوا يستعملوه للقذف لما في أنفسهم للخارج على وجوه و ثياب الآخرين! [8].
القاسم المشترك بين كلماته هو الضجر من الواقع. تجده يجرؤ على التحدي وباسم الحرية لا يكف عن المواجهة باسم الكشف والتنوير وبوازع من إعلان التحدي ضد القيود، فهو -يرى نفسه- صاحب المبادرة في إسقاط الأصنام وكشف الأستار.
٥. المساس بالقارئ العربي: .
العربي متدين بفطرته، والإيمان بالله ورسله وبالوحي المنزل، مدفوع إليه بكامل كينونته، والعربي قد يجترئ على إيقاع الظلم بالآخرين والولوغ في الفساد، ولكنه لا يجرؤ على الاقتراب من حمى الله و ملكوته، وكتب (القصيمي) قد خالفت الوضع الشائع -كما أشرنا – ولذلك لم تلق قبولًا جماهيريًا، ولم يسمح بدخولها إلى موطنه المملكة العربية السعودية مثلًا، أضف لذلك فإن هجومه وإن كان صادما – إلا أنه في كثير منها- لم يخالف الواقع ولم يجانب الحقيقة، ولكنها وقائع وحقائق لم تتقبلها التركيبة الشخصية لكثير من القراء إما لعنصر المبالغة لديه في تسفيه العرب وتعداد مثالبهم، ونسب الذل والعار لهم، هذا من جانب ومن جهة أخرى، فإن زمنه لم تظهر فيه قنوات التواصل الاجتماعي بعد وكلنا يعرف ما للتقنية من دور كبير في التخفيف من حجم وكثافة هالة التعظيم التي يحيطها العربي- لاسيما المثقف – بنفسه وبمكتساباته. أما كتبه أنذاك فهي بلا شك كانت و لاتزال تستفز الشعور بالفخر بهوية (الأنا) لدى أغلب العرب، وقد نال من الخيال في الثقافة العربية:
للخيال العربي عيبان: عاجز في طاقته، منحرف في موضوعه، فمن الناحية الأولى نجده عاجزا عن تخطي واقعه الذاهب في أعماق التاريخ الأليم، إنه لم يستطع أن يتخيل صورًا للمستقبل، إنه يرضى بكل المساوئ التي يحياها. [9]
كما لم يسكت عن طبيعة القصور في التفكير العربي:
التفكير العربي يرفض أن يكون مسؤولًا عن نفسه، إنه يوزع المسؤوليات توزيعًا خارجيًا، إنه دائمًا موجود في غير ذاته. [10]
وكانت له انتقادات لاذعة تجاه الكتاب العرب والمؤلفين لا سيما في المعارف الأدبية، وها هو في موضع آخر يزدري نظام النقل ويسفه عمليات التعليم، ويعزي إليها ضعف طاقة النقد والفهم والابتكار، فيقول:
فإنهم يتعاقبون بلا ملل على هذه الدراسات النقلية، ويظلون يضعون فيها الكتب ويخلقون لها وجوه التأويلات، إن أحدنا لو قدر له أن يحمل إلى منزله كتابًا واحدًا من الكتب التي وضعت في التفسير أو في الفقه آو في الحديث أو في شرحه لاحتاج إلى شاحنة كبيرة، مع أن كل ذلك لايعدو أن يكون تكرارًا لقصة عقيمة! [11]
وقد لوحظ أن التأليف حتى اليوم، ولدى كبار كتابنا، ليس سوى عملية نقل، إما عن تاريخنا القديم أو عن معطيات العصر الحديث. والنقل عن هذا وذاك عملية تكرار بليدة، ومن التخليطات أن هؤلاء الذين يقومون بحركة البعث للكتب القديمة الميتة، لا يعلمون أو لا يبالون أن يعلموا أن هذه الكتب تحرم كل الحياة التي يحيون .. فلقد ترتبت على هذه الثقافة النقلية وقفة عقلية، فإن توجيه الطاقة كلها نحو النقل وقف العقل، وحين وقف ضمر .. لقد خسرنا بخسارتنا العقل الحضارة، فصرنا وجودًا لا إبداعاً. [12]
وكان أقصى ما يبلغه علماؤنا وعباقرتنا العظام أن ينقلوا إلينا ما حفظوا وما قرؤوا كما ينقل لنا الشيخ أو القسيس نصوص صلواتهما وكتبهما المقدسة. [13]
كتاباته لا تشي كثيرًا بحالة ضعف وتردد أو حتى حاجة إلى الدفاع عن النفس أو عن الأفكار، فهو قد استعذب مواطن الهجوم المضاد من خلال تعرية الواقع وهدر حرمة الأفكار والموروثات.
٦. التقاطات رائعة من (القصيمي):
وأمام تلك الأمواج المتلاطمة من عبارات النقد اللاذع والصدام العنيف، ضد الواقع العربي والموروث الفكري، وكأنه “يعصر آخر قطرة من العبودية في نفسه[14]” وواقع أمته كذلك، إلا أن القارئ الواثق وكذلك ذو النفس الطويل، سيعثر على موجات أخرى ساكنة يمكنه ركوبها بسلام ليكتشف ثمة أفكارًا تربوية ويلتقط ملاحظات ألمعية، وينتفع بتشخيصات نفسية عميقة، تعكس أبعادًا جديدة قادته عقلية ثاقبة، وذكاء متقد:
إني لأحسب أن أقوى الأشياء لتقويم سوك الإنسان، وخلق فضائله النفسية، هو تنمية شعوره بذاته، إن احساسه بنفسه وكرامته وشخصيته المتجددة المستقلة، إن إحساسه بأن للكرامة والشخصية حدودًا إنسانية إذا اجتازها أو قصر عنها كان إنسانًا قاصر الحدود، أو بلا حدود.
إن إحساسه هذا هو الذي يصنع الوجود الأخلاقي للإنسان. و حينئذ تصبح مقاييس الشخصية التي تحدد انفعالاتها، وتوجه أفعالها، وتضبط موازينها، جزءًا منها وليس إملاءً خارجيًا.
إن تعلية الشعور بالقيمة الإنسانية ترفع شعور البشر بأنفسهم. [15]
إلا أن الرجوع بالإنسان إلى فضائله الداخلية والتي هي أصلًا لا تتحقق إلا بعودته الأصيلة لفطرته وجوهره عبر الاستسلام لمعبوده هي بدورها كرامة موعودة له ولكن لا يبلغها إلا من أذعن طواعية لشريعته. فبقيت فكرته المطروحه صالحة للتنظير مستبعدة حال التطبيق.
إن المصرف المشروع لشعور الغضب، هو النقد الموجه وكذلك قبول النقد الهادف. يقول (القصيمي) في فصل”أكبر التحديات لعبقرية الوجود”:
الطبيعة تغير نفسها دون أن تستطيع نقد نفسها، إن الإنسان وحده هو الذي ينقد نفسه لأنه أرقى.
إن الذين يرفضون نقد أنفسهم يرفضون شيئاَ يصنعه الجماد، والنبات، والحيوان نفسه، وتفعله أيضًا حياتهم بهم كبشر و طبيعة.
إن نقد الذات هو أحد الفروق الكبيرة بين البشر، فالأقوياء يدركون نقائصهم، الأقوياء يجرؤون على نقد أنفسهم لأنهم يريدون تغييرها، لأنهم يقدرون على تغييرها، إن أعظم الأشياء هي أكثر الأشياء اغراءً للهجوم عليها.
نحن ننقد الشيء بقدر شعورنا نحوه، بقدر ماله من تأثير علينا، فالنقد دائماً علامة تقدير. و كم هم صغار أولئك الذين لا يجدون من ينقدوهم ولا من يسددون إليهم الحملات القاسية، رثائي لأولئك الذين لا يملكون مزايا من أي نوع تتحدى الآخرين، فتجعلهم غاضبين، تجعلهم متهمين، رثائي لأولئك الصغار المنسيين. [16]
و في موضع آخر من (صحراء بلا أبعاد) يحرر مفهومًا جديدًا وغريبًا للتخلف والمتخلفين، فيقول:
إن المتخلفين ليناضلون أقسى نضال لكي يبقوا متخلفين.
إنه لا يمكن في مجتمع من المجتمعات أن يحافظ على مستوى تخلفه ما لم يناضل بعذاب لمقاومة التقدم، إن التخلف نضال هائل ضد النفس و الطبيعة.
ليس التخلف أن نترك التقدم، بل هو أن نعمل عملًا كبيرًا مضادًا ودائمًا لكيلا نتقدم.
إن محاولتنا ألا نتقدم، تشبه محاولات النهر ألا يسير في مجراه. [17]
و(عبدالله القصيمي) بتركيبته الذهنية الوقادة والانفعالية معًا يبرز دور الاحتياج الذي يتفاقم تحت وطأة الإحساس:
إن الأحاسيس و الاحتياجات هي أقوى تحريضًا من أعظم الأقلام التي تكتب أقوى الأفكار.
إن الذي يحس بالشئ و يحتاج إليه، أعظم من الذي يكتبه، إن الذي يضع مسمارًا في مكان الاحتياج إليه، لأعظم خلقًا من جميع الكتاب الذين يحسنون التحدث عن ذلك الاحتياج. [18]
وكأني به يعكس ما يجول بداخله في تفسير الظواهر الاجتماعية المتغيرة حوله، فهو يعلي من شأن التراكم الشعوري والأفكار، ويعد قانون التراكم هو المحرك الحقيقي والسر المختبئ خلف التغيرات الكبيرة والمفاجئة التي تطال المجتمعات، وأن ظهور رجل جديد إنما نتيجة لهذه التغيرات المتراكمة فهو لم يصنع أكثر من إشعال الفتيل في الوقود المتجمع إذ أن هذا التراكم لابد أن يعبر عن نفسه.
ويقول في فصل مبرر للإيمان بالغباء، و كأني بي هنا أقرأ لعالم النفس الشهير (كارل يونغ) في طبيعة النفسية العربية:
لعلهم لو زالت هذه الدولة العدوانية (يقصد إسرائيل) يذهبون يسألون الشيطان أن يهيئ دولة أخرى مثلها أو شرًا منها؛ أو أن يهيئ لهم شيطانًا أو شيء آخر يخوفون به ويخطبون ضده ويصرفون إليه خطبهم وحماسهم وسبابهم.
لعلهم لو زالت هذه الدولة لقاموا في جوف الليل يصلون للشيطان، يضرعون إليه، طالبين منه التعويض، طالبين ألا يتركهم بلا إسرائيل أخرى. [19] .
(عبدالله القصيمي)، بشخصيته الصلبة وأفكاره وقناعاته التي صدم بها – خاصة- أبناء جلدته وملته لاسيما ممن أثنوا عليه وأشادوا به ورفعوا ذكره في بداياته ومقتبل عمره، هو نفسه (عبدالله) الذي أثار إعجاب عددًا من جمهوره الذي واظب على حضور ندواته ومتابعة مقالاته وكتبه، لكونه مركبًا من تناقضات كثيرة أو باعتباره خليطًا من معارف وثقافات عديدة أو لجرأته وشجاعته في تخطي المحظور ومقاومة المألوف.
(عبدالله القصيمي) الذي لم تفلح معه الردود المدوية ولم تحمله المواقف الرسمية الحازمة، ولم تسكته المحاولات المناهضة، كالإقصاء والطرد وفتوى إباحة الدم. كل ذلك لم يشكل ضغطًا عليه قط، ولم يدعوه للتصريح بالحاجة إلى مراجعة أفكاره، وإعلان العدول عن بعض منها، (عبدالله القصيمي) الذي عرف بجداله العنيف وأفكاره الصدامية، أظنه في أيامه الأخيرة قد ترك المقاومة، وأعلن استسلامه التام لساعة الخلاص، حين لاذ بالصمت طواعية قبل موته بأيام – يقال- وقد لازم قراءة القرآن.
المراجع والإحالات:
[1] (صحراء بلا أبعاد) ص ١٠٨.
[2] (أيها العقل من رآك)، ص ٩.
[3] (العالم ليس عقلاً) ص ٣٢٩.
[4] . بتصرف من كتاب (العالم ليس عقلاً) ص ١٦.
[5] و تكررت المقدمة نفسها تقريبا في كتاب (أيها العقل من رآك).
[6] (يكذبون كي يروا الله جميلا)
[7] (العالم ليس عقلا) ص ٢٥.
[8] (صحراء بلا أبعاد) ص ٥١.
[9] المصدر السابق ص ١٨١.
[10] المرجع السابق ص ١٩٨.
[11] (العالم ليس عقلا) ص ٣١١.
[12] المرجع السابق ص ٣١٢.
[13] المرجع السابق ٣١٣.
[14] العبارة منسوبة للكاتب الروسي (تشيخوف).
[15] (صحراء بلا أبعاد) ص ١٦٢.
[16] بتصرف شديد من كتاب (أيها العقل من رآك) ص ١٧.
[17] (صحراء بلا أبعاد) ص ١٣٠.
[18] المرجع السابق ص ٢٥٧.
[19] المرجع السابق، ص ٢٠٤.