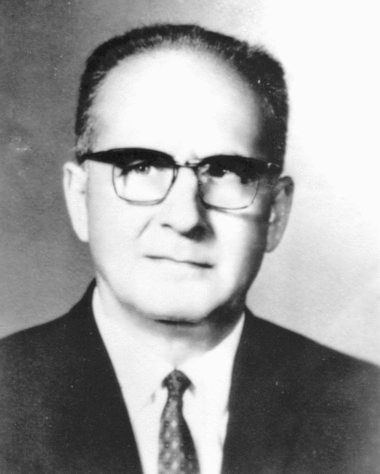دور المسلم ورسالته في القرن العشرين عند مالك بن نبي
مالك بن نبي (1905-1973م) من أبرز المفكرين في القرن العشرين، أهتم بالبحث في مشكلات الحضارة في العالم الإسلامي واعتمد في بحثه منهجا ً مبنياً على أسس من علم الاجتماع وعلم النفس وسنن التاريخ. المصدر
ختم مالك بن نبي سلسلة كتبه (مشكلات الحضارة) بكتاب (دور المسلم ورسالته في القرن العشرين ) والذي يحتوي على محاضرتين ألقاهما عام 1972، تحدث فيهما عن ضرورة معرفة المسلم لدوره في القرن العشرين والعمل بمقتضيات هذا الدور، ويعزي أهمية هذا الأمر الى واقع هذا العصر الذي تشهد مجتمعاته المتحضرة تغييراً جوهرياً من الناحية العلمية والنفسية والأخلاقية، تغييراً نتج عن تراكم التجارب والخبرات في مجالات عدة، حيث يقول مالك بن نبي في وصفه لهذا العصر:
هذا الثلث الأخير من القرن العشرين، كأنه النهر قرب شاطئ البحر وقد بلغ المصب، بعد أن تجمعت فيه جميع روافده من المياه، التي انحدرت من أعالي الجبال في أقصى داخل البلاد. فالثلث الأخير يبدو هكذا تلك الفترة من التاريخ التي تتجمع فيها كل روافد التاريخ، بكل نتائجها النفسية والاجتماعية والسياسية والعلمية، وكل التغيرات المترتبة على هذه النتائج. وعليه فإن هذه المسوغات تكفي لتسويغ اختيارنا له بصفته حقبة زمنية استثنائية في التاريخ، يكون دور المسلم فيها شيئا استثنائيا أيضا، يجب إدراجه بطريقة خاصة في الدور العام الذي حدده له القرآن الكريم بوصفه شاهداً…
التغيير الذي شهدته المجتمعات المتحضرة في معتقداتها الاجتماعية والسياسية والأخلاقية أدى الى تخليها عن المسوغات الحضارية التقليدية التي حركت تاريخها في الماضي. وفي هذا يقول (مالك بن نبي):
إن الأجيال في هذا المجتمع المتحضر عاشت على رصيد ثقافي ورثته من الأجيال السابقة، أعني أنها عاشت على رصيد المسوّغات التي دفعت عجلة التاريخ في القرون الماضية، وخصوصاً في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. والذي يبدو-خاصة إذا رجعنا إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين-أن هذا الرصيد من المسوّغات الضرورية لتحمّل أعباء الحياة، بدأ ينفد، وبدأت الشعوب التي تعيش على محور (واشنطن-موسكو)، الشعوب المتحضرة، بدأت تشعر جميعها بنفاد رصيدها الثقافي، رصيد مسوّغات حياتها التقليدية الموروثة عن أجدادها…لنتصور كيف كان ينشأ الطفل في زمان (كيلنج) مثلاً أو في زمان (أرنست رنان) مثلاً، كان الطفل في ذلك الوقت ينشأ وحوله جو من الأفكار منبتها الاستعمار[…] لذلك لا نستغرب أن نرى رجلاً كـ (ستانلي) في أواخر القرن الماضي، نشأ في هذا الجو وتكونت عنده فكرة الاكتشافات وفكرة الفتوحات، نراه يغادر وطنه وينزل إلى إفريقية الوسطى فيحتل قطاعا كبيراً منها […] أما إذا كان هذا الأوربي جندياً فإن نشأته في هذا الجو، تصور له أن المجال لأداء واجباته الوطنية وواجباته العسكرية، هو قطاع من قطاعات إفريقية وآسية. […] فهذه الأشياء كانت تغمر الحياة الأوربية بفيض من المسوغات. وربما كانت هناك منابع أخرى لهذه المسوغات فقدت أو جَفّ نبعها بعد الحرب العالمية الأولي والثانية، بسبب تطورات تتصل بما حدث مثلاً بشأن الروابط الخفية أو الظاهرة بين مجالي العلم والنفس.
فبقدر ما كانت تتحقق اكتشافات علمية كبرى في أوربة، بقدر ما كانت تترك صداها على المجال النفسي، وأثرها الكبير في التطور الروحي، حتى بدأت تفتر بعض المسوغات الروحية…
فحينما تفقد حياة ما أو مجتمع ما مسوغاته، لابدَّ أن يقوم بعمليات تعويض: يستبدل بمسوغات قديمة أو تقادمت، أو فقدت تأثيرها في الحياة الاجتماعية، بصفتها دوافع قوية للحياة الفكرية والعلمية والعسكرية والاقتصادية، يستبدل بها مسوغات جديدة. […] العالم المتحضر اليوم، يبدو أنه قد أخفق في عملية التعويض، سواء من الجانب الأدبي كمحاولة الوجودية مثلاً، أو من الجانب السياسي كمحاولة الرجوع لأصله الأوربي، بحثاً عن منطلقات جديدة لأفكاره ولنشاطاته الاقتصادية، فكأنما تقطعت أنفاسه، ولم تعد في متداوله تلك الأشياء المتينة التي كان يرتكز عليها في القرن الماضي وبداية هذا القرن.
وفي موضع أخر يقول:
فحضارة القرن العشرين أفقدت أو أتلفت قداسة الوجود، في النفوس وفي الثقافة وفي الضمائر. ولقد أتلفت القداسة لأنها عدتها شيئاً تافهاً لا حاجة لنا به. ولقد انجرت إلى إتلافها بسبب منشأ ثقافتها التي يطلق عليها اليوم (العلمية)، والتي أخضعت كل شيء وكل فكرة إلى مقاييس الكم منذ عهد ديكارت. […] كان الوجود مقدساً في كل تفاصيله، في حياة الحشرات كان مقدساً، وحياة الإنسان كان أكثر قداسة، حتى الأشياء التي تلقى في الشوارع، كانت هناك تفاصيل توحي بقداستها، كان المار في الشارع إذا التقى بصره بِفُتَات الخُبز، ينحني ويلتقط هذا الفتات ثم يقبله ويضعه في مكان طاهر، لأنه كان يشعر بقداسة هذه الأشياء. أما الأوربي فلا يهمه هذا ولا يلتفت إليه لأن هذا الفتات من الخبز، لا قيمة له في نظره الكمي، إذ لا ثمن له، لذا يلقى مع الأشياء الأخرى في سلة المهملات. بقدر ما تراكمت الإمكانيات الحضارية اضمحلت القاعدة الأخلاقية الروحية المعنوية التي تتحمل في كل مجتمع عبء الأثقال الاجتماعية والأثقال المادية، إذ لابدَّ من قاعدة روحية متينة حتى تتحمل هذه الأعباء، هذه الأعباء التي ترزح تحتها أوربة أو الحضارة الغربية اليوم وهي في خضم الأشياء التي تنتجها التكنولوجية.
وعند نفاذ المسوغات الحضارية تحصل أزمة تضخم الإمكان الحضاري وتضاؤل الإرادة الحضارية، وفي حديثه هن نتائج هذه الأزمة يقول (مالك بن نبي):
إذا ما فقد مجتمع ما مسوغاته ولم يستطع تعويضها بالطرق المشروعة في محاولات مبذولة، عندها يعتريه القلق ويعتريه التيه وتعتريه الحيرة. […] البلد الذي حقق الضمانات الاجتماعية إلى أقصى حد مثل السويد، يتميز بشيء خطير وهو أنه يتصدر رأس القائمة في (إحصائية الانتحار العالمية). فظاهرة الانتحار في العالم، يشغل فيها المكان الأول، البلد الأكثر تقدماً نسبياً من حيث الضمانات الاجتماعية.
إذا شبعت البطون قد تبقى الأرواح متعطشة، تبقى الأرواح متطلعة. وحين لا تجد وجهة تتطلع إليها تفضل الاستقالة من الحياة. هذا إذن ما يحدث، وقد يحدث في بلاد أخرى أكثر من هذا في صورة ما؛ ويبدو أن هناك صوراً أخرى للاستقالة من الحياة… عن طريق الموبقات، عن طريق التدهور الأخلاقي، عن طريق الإدمان على المخدرات، فيصبح المجتمع مهدداً بالخراب، لأن قاعدته الاجتماعية تنهار، أي شبابه ينهار.
وفي موضع أخر يعطي (مالك بن نبي) صورة عن وضع المسلمين حضاريا:
نحن نعيش أزمتنا الخاصة بنا ونعيشها بكل أبعادها، بعدها الاقتصادي مثلاً، يكفينا أن نذكر، على سبيل المثال، أن أحطَّ المستويات الاقتصادية في العالم، في صورة ما يسمى متوسط دخل الفرد السنوي، هو في البلاد الإسلامية. إن هذا معناه أن أحطَّ الحظوظ في هذه الدنيا أصبح للأمة التي خصها الله بالهداية الإسلامية، وخصها الله برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في هذه الدنيا. هذه الأمة أصبحت تعاني الأزمات المتنوعة التي قد نجمعها في كلمة واحدة نسميها الأزمة الحضارية، وهي فعلاً أزمة حضارية لا غير إذن نحن نعاني أزمتنا ومن ناحية أخرى تعاني الإنسانية المتحضرة أزمتها.
ولنتقدم كمسلمين فمن الضروري أن نفهم دورنا في هذا العصر ونعمل بمقتضياته، ويرى مالك بن نبي أن دور المسلم يقتضي بناء وتغيير داخلي، حيث أن المسلم إذا أراد ان يبلغ رسالته الى العالم يجب أن يرتقي الى مستوى حضارة هذا العصر، فيبدأ ببناء نفسه اقتصاديا ً وعلميا ً. وفي أهمية هذا التغيير الداخلي يقول مالك بن نبي:
هل ترون الى أرض عطشى تنتظر الري من الماء؟ هل نستطيع ريها بماء يجري تحت مستواها؟ لا لن يسقي الماء الأرض بالصعود إليها، وإنما بالانحدار وذلك بحكم السنن الإلهية عن طريق الجاذبية. سنة الله تقتضي أن ينحدر إلى هذه الأرض إذا كان مستواه يخوله ذلك. إذن إذا أراد المسلم أن يقوم بدور الري بالنسبة للشعوب المتحضرة والمجتمع المتحضر، وأراد-بعبارة أوضح-أن يقدم المسوغات الجديدة التي تنتظرها تلك الأرواح، التي تتألم لفراغها وحيرتها وتيهها، إذا أراد المسلم ذلك، فليرفع مستواه رفعاً يستطيع معه فعلاً القيام بهذا الدور. إذ بمقدار ما يرتفع إلى مستوى الحضارة بمقدار ما يصبح قادراً على تعميم ذلك الفضل، الذي أعطاه الله له (أعني دينه). إذ عندها فقط يصبح قادراً أيضاً على بلوغ قمم الحقيقة الإسلامية، واكتشاف قيم الفضيلة الإسلامية، ومن ثم ينزل إلى هضاب الحضارة المتعطشة، فيرويها بالحقيقة الإسلامية وبالهدى، وبذلك يضيف إليها بعداً جديداً. لأن الحضارة العلمانية، حضارة الصاروخ، حضارة الإلكترون اكتسبت هذه الأشياء، وضيعت بعداً آخر تشعر بفقدانه وهو بُعد السماء.
وليأدي المسلم دوره في القرن العشرين فعليه أمرين الاقتناع والاقناع:
الاقتناع أولاً لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكن للمسلم إن لم يقتنع بأن له رسالة أن يبلغ الآخرين هذه الرسالة، أو فحوى هذه الرسالة أو مفعول هذه الرسالة. إذن يجب أن يقتنع هو أولاً. وأنا أعني قناعته برسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين ولا أتكلم عن اقتناعه بدينه.
وفي اقناع الطرف الأخر يقول (مالك بن نبي):
ما هو واضح في تصوري أنا المسلم، ليس واضحاً بالنسبة للآخرين الذين ينبغي علي أن أتقدم إليهم، آخذاً بالاعتبار تصورهم هم لا تصوري أنا عن حقيقة المسلم. لأن حقيقة المسلم محجوبة عن نظر الآخرين. إن حقيقة المسلم، كرامة المسلم، فضيلة المسلم، أخلاق المسلم، شرف المسلم، عزة المسلم؛ كل هذه الأشياء تخفيها عن نظر الآخرين المظاهر الاجتماعية. وهي تشهد بكل أسف في نظر الآخرين على المسلم وضده. فالمسلم فقير، والمسلم جاهل، المسلم كذا … الإحصائيات الموجودة في العالم كذا … إلخ
ومن هنا نرى ما يترتب على المسلم من القيام بواجبات ملحة، حتى يفي بشرط إعجازه في هذا الثلث الأخير نحو نفسه ونحو الآخرين، […] يجب فعلاً أن تتوافر لرسالة المسلم كل شروط الاقتناع وكل شروط الإقناع؟ ولن يتوافر هذا إلا بتغيير. […] يجب على المسلم. الذي يضطلع برسالته أن يفكر في إعجازه، وإعجازه لا يتأتى إلا بتحقيق شرط جوهري، وهو تغيير ما بنفسه وتغيير ما في محيطه مصداقاً للآية الكريمة: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 12/13].
إذن لكي يتحقق التغيير في محيطنا يجب أن يتحقق أولاً في أنفسنا. […]عندها يجب على كل مسلم أن يحقق بمفرده شروطاً ثلاثة:
أولًا: أن يعرف نفسه.
ثانيًا: أن يعرف الآخرين، وألا يتعالى عليهم، وألا يتجاهلهم […] ويجب عليه أن يعلم ذلك لأمرين لا لأمر واحد، إما لكي يتقي شرهم عن معرفة وإدراك لكل معطيات نفوسهم، وإما لتبليغهم إشراق الإسلام وإشراق الهداية الإسلامية. فهو إن لم يعرف النفوس فكيف يقدر أن يتصرف معها بحكمة؟ إن لم يعرف نفوس الآخرين وظلت صناديق مغلقة عليه فكيف يبلغها الهداية الإسلامية؟ إنه لن يستطيع. يجب إذن على المسلم بعد أن يعرف نفسه أن يعرف نفوس الآخرين.
ثالثًا: أن يعرِّف الآخرين بنفسه، لكن بالصورة المحببة، بالصورة التي أجريت عليها كل عمليات التغيير بعد التنقية والتصفية من كل رواسب القابلية للاستعمار والتخلف وأصناف التقهقر، كل أصناف التخلف وأصناف التأخر. ويجب عليه أولاً أن يقوم بهذه التصفية حتى يقدم للآخرين صورة مقبولة محببة بوصفها عينة من العينات البشرية التي يصنعها الإسلام، أما إذا تقدم المسلم إلى الآخرين بوصفه عورة يجب أن يستحى منها، فالعورة تستر ولا تكشف، والعورة لا يمكنها أن تبلغ إشعاعاً. الجهل عورة الفقر الذي يسببه كسلنا، وكسلنا عورة، الفوضى عورة وهذه العورات كلها لا تستطيع ولا تتيح لشخصية المسلم أن تبلغ إشراق الإسلام.
![المفكر-الإسلامي-مالك-بن-نبي[1]](https://fahd09.opalstacked.com/wp-content/uploads/2017/03/المفكر-الإسلامي-مالك-بن-نبي1-241x300.gif)