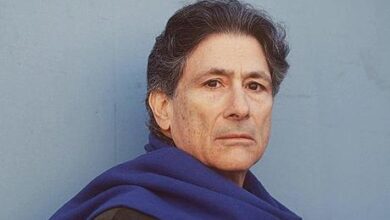هل يشكل الاختلاف عائقا أمام المواطنة المستقلة ؟ رايلي يقول نعم

كافين رايلي -المؤرخ الأمريكي الذي كتب العديد من الكتب التي تقرأ التاريخ من زاوية جديدة والذي أخبرنا كذلك كيف تخلصت أوروبا من البربرية – يكتب هذه المرة عن مفهوم المواطنة. في أهم أعماله “الغرب والعالم: تاريخ الحضارة خلال موضوعات [تحميل])” – ترجمه الدكتور عبد الوهاب المسيري ونشر ضمن سلسلة عالم المعرفة – يكتب عن الفرق بين مدن الرعايا ومدن المواطنة. حيث يستعرض وبحذاقة واطلاع واسع تجارب العديد من المدن القديمة في تأسيس المواطنة ويشكك في المجمل ما إذا كان بالإمكان بناء المواطنة في ظل القبليات والعرقيات والديانات الموجودة. لهذا الاقتباس علاقة وطيدة للغاية بعالمنا العربي حيث نشهد وبشكل متزايد المزيد من التساؤلات حول المواطنة والاختلاف.
لما كانت الهوية الأساسية للساكن الحضري الصيني هي أنه رعية، فإن المدينة كانت دائماً غريبة. وبينما كانت السلطة الإمبراطورية وعضوية الأسرة قد بلغتا ما بلغتاه من قوة في الصين، فقد استحال على جماعات السكان الحضرية أن يروا أنفسهم مواطنين مستقلين لهم عزتهم أو مسؤوليتهم تجاه مدينتهم. ولم يكن في المدينة الصينية ، بصرف النظر عن حجمها، أي أساس لظهور هوية مستقلة، او نوع من أنواع المشاركة مثل ذلك الذي ظهر في داخل المدينة-الدولة. فطبقة التجار التي كانت أكثر الطبقات تحررا من القيود الأسرية والقروية، كانت في أفضل وضع يمكنها من أن تعلن أعضاءها مواطنين ولكن أعضاءها لم يفعلوا، وإنما اكتفوا بأن يصبحوا رعايا أكثر ثراء ومجداً.
وعلى هذا النحو نفسه حالت الوشائج الطائفية أو القبلية أو الدينية في معظم المدن غير الغربية الأخرى، دون ظهور جماعة المواطنين. ففي المدن الهندية خنقت الفروق الطائفية كل شعور بالهوية المدنية المشتركة. وفي إفريقيا والأمريكتين كان للهوية القبلية أو الدينية الغلبة على مكان الإقامة أو موضعه. وفضلا عن ذلك فإن أهالي معظم هذه المدن كانوا رعايا لعاهل أو امبراطور أو رئيس. وكانت الهوية القبلية على وجه العموم أقوى في أفريقيا غير المسلمة وبين الأنكا والأزتيك في أمريكا. أما الهوية الدينية فكانت أغلب في افريقيا الإسلامية وعند المايا في أمريكا. وكانت بعض المدن مدن رعايا في المقام الأول. فالقسطنطينية ، حاضرة الامبراطورية البيزنطية، كانت شديدة الشبه بمدينة الرعايا الصينية. غير أن قوة الكنيسة في القسطنطينية كانت في غالب الأمر تماثل قوة الامبراطور، وكان للانتماء الديني نفس أهمية الانتماء السياسي.
وقد ذهب ماكس فيبر إلى أن الانتماء القبلي سد الطريق أمام ظهور المواطنة المستقلة حتى في أثينا وروما. وربما أمكن القول بصفة عامة أن الهوية القبلية (أو العشيرة-الأسرة) كانت دائما أشد العقبات في وجه تطور الإحساس بالاستقلال الذاتي للمواطن الفرد. وقد درجنا على ربط التنظيم القبلي بالأقارقة أو هنود أمريكا، وهذا غير صحيح،. فكل المجتمعات السابقة على ظهور المدن كانت قبلية. وهذا هو السبب في أن هوية قبلية معدلة احتفظت بأهميتها في كثير من المدن القديمة كروما. وكانت المدينة تعمد في بعض الأحيان إلى تقنين النظام القبلي (ومن هذا القبيل تنظيم جماهير الرومان للتصويت في “قبائل” إلى جانب زعماء “التربيون” المنتخبين للدفاع عن الحقوق العامة). وكثيراً ما أدى هذا إلى تعديل الانتماء الفردي إلى المدينة أو عرقلته. ولكن القبائل أنشأت – في بعض الحالات- مدنا أقرب إلى المدينة-الدولة الديموقراطية منها إلى الطائفة المغلقة أو مجتمعات الرعايا. إذ كانت مدينة تمبتكو الأفريقية ومدينة المكسيك الأزتيكية الأولى على سبيل المثال مدينتي قبائل ظهرت فيها مشاركة السكان الكبيرة في شؤون المدينتين. ولكن حتى في هاتين المدينتين كان حكم الزعيم أو الملك القبلي أكثر شيوعا.
وقد كان لمعظم الديانات دور في خلق الوظائف المغلقة، مما يؤدي إلى التفرقة بين أعضاء المدينة المتعددة الأديان بدلاً من تعزيز هويتهم المشتركة. فالهندوكية في المدن الهندية القديمة ، على سبيل المثال، كرست الفروق بين الطوائف المغلقة التي تفصل بين سكان المدينة. إذ كان الهندوكيون في دلهي من البراهمة أو الكشاتريا والفاشيا أو السودرا وليسوا “دلهيين”. ويعد غيرهم من السكان أنفسهم مسلمين أو فارسيين. ولكنهم، مرة أخرى، لسوا بالدلهيين. وكما كان يهود بابل أو الاسكندرية أو دلهي يعدون أنفسهم يهوداً. أما المسيحية والبوذية ، فقد غرستا ، إلى حد ما، شعوراً بالمشاركة الجماعية، أتاح لسكان المدن فرصة التركيز على الأهداف والحاجات الجمعية. وقد كانت مدن الهند البوذية أقل انقساماً على أساس طائفي، وكانت تفوق المدن الهندوكية أو المدن التي أسسها الفاتحون المسلمون في درجة قربها من نمط الدولة-المدينة. غير أن البوذية أصبحت أكثر اهمية في الصين منها في موطنها الهند. وقد وضعت الصين عقبات أخرى في وجه نمو جماعة المدينة المترابطة. أما تلك المدن، التي كانت مراكز دينية أساسا مثل مكة ومدن المايا في أمريكا، فقد كانت تشجع نشوء نوع من جماعة المؤمنين، غير أن هذه المدن كانت في الغالب “عواصم” للعقيدة الدينية لا يمكن أن تترك للسكان المحليين. وقد أدار حكام المسلمين وكهنة المايا هذه المدن إدارة مباشرة، بل إن الكهنة كانوا في بعض مدن المايا هو السكان الوحيدون – وكانت الجماعة المترابطة التي يشكلونها أشبه بسكان الأديرة.
ويبدو ماكس فيير على حق في النهاية، فقد كان ثمة حواجز خطيرة تحول دون تطور الجماعة الحضرية في معظم المجتمعات الامبراطورية والطائفية المغلقة والقبلية في العالم الوسيط. لقد كانت هذه المدن -في الغالب- رائعة متألقة وافرة الإنتاج، ولكنها قلما أتاحت الفرصة للمشاركة الديموقراطية التي كانت توفرها القرية على مستوى أكبر. ولم يكن سكان هذه المدن يعدون أنفسهم مواطنين، ولم يشاركوا في تسيير شؤون مدنهم. ولم تعمل هذه المدن على مواصلة التوسع في الإجراءات الديموقراطية التي ظهرت لأول مرة في المدن-الدول الأولى، وإنما حدث ذلك في أوروبا الغربية.