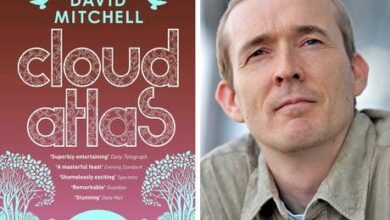ميلان كونديرا في حديثه عن الذاكرة والنسيان
(ميلان كونديرا)، روائي وفيلسوف تشيكي لديه العديد من الروايات العالمية المشهورة مثل (كائن لا تحتمل خفته). يتحدث في كتابه (الستارة) حيث يحكي مستفتحًا:
أتذكر لقائي مع بعض زملائي في الثانوية بعد عشرين عامًا من البكالوريا؛ يخاطبني (ج) بفرح: “ما زلت أراك تقول لأستاذنا في الرياضيات: تبًا يا سيدي الأستاذ”، والحال فإن اللفظ التشيكي لكلمة “تبًا” نفّرني على الدوام، وكنتُ على ثقة تامة بأنني لم أقل ذلك، لكن الجميع من حولنا انفجروا ضاحكين، متظاهرين بأنهم تذكروا تصريحي الظريف. أدركتُ أن تكذيبي وإنكاري لن يقنع أحدًا، فابتسمت بتواضع دون احتجاج لأنه، وأُضيف هذا إلى خجلي، سرَّني أن أرى نفسي وقد تحوّلت إلى بطل يطلق كلامًا بذيئًا في وجه الأستاذ الملعون.
عاش الجميع مثل هذه الحكايا. عندما يستشهد أحدهم بما قُلته في محادثة، فإنك لن تتعرف أبدًا على نفسك؛ تغدو عباراتك في أحسن الأحوال مبسطة على نحوٍ فظ وأحيانًا مشوّهة -عندما يُؤخذ تهكمكم على محمل الجد- وغالبًا غير منسجمة البتة مع ما سبق لك أن قلته أو فكرت به. وينبغي أن لا تدهش أو تسخط، لأن هذه بديهية البديهيات: الإنسان منفصل عن الماضي -الماضي القديم كما الماضي القريب جدًا منذ بضع ثوانٍ- بقوتين تباشران العمل وتتعاضدان: قوة النسيان، التي تمحي، وقوة الذاكرة، التي تُحوِّر.
هذه بديهية البديهيات، لكن من الصعب قبولها لأنه، عندما نفكر فيها حتى النهاية، ماذا ستصبح كل الشهادات التي يستند إليها التأريخ، ماذا تصبح يقينياتنا عن الماضي، وماذا يصبح التاريخ نفسه الذي نرجع إليه يوميًا بسذاجة وحسن نية وعفوية؟ خلف بطانة المُسلّم به الرقيقة -ليس ثمة شك أن (نابليون) خسر معركة (واترلو)- يَنتشر فضاءٌ لا نهائي، فضاء التقريب والاختلاق والتشويه والتبسيط والمبالغة وسوء الفهم، فضاءٌ لا نهائي من اللا حقائق التي تتكاثر كالفئران وتَتَخلَّد.
ويكمل بعد ذلك فيقول:
يعطي النشاط الدائم للنسيان لكل واحد من تصرفاتنا طابعًا شجيًا وغير حقيقي وضبابي .. ماذا تغذينا قبل البارحة؟ ماذا روى لي صديقي بالأمس؟ وحتى: بماذا فكرت منذ ثلاث ثواني؟ كل هذا يُنسى، وما هو أسوأ بكثير، لا يستحق شيئًا آخر. ومقابل عالمنا الواقعي الزائل والجدير بالنسيان في حد ذاته، تنتصب الأعمال الفنية كعالم آخر، عالم مثالي وراسخ، لكل تفصيل فيه أهميته ومعناه، وكل ما يوجد فيه، كل كلمة، كل جملة، تستحق ألا تُنسى وأن تُفهم كما هي.
مع ذلك لا يُفلت الإدراك الحسي للفن أيضًا من سلطة النسيان. وبهذه الدقة، يوجد كل فن من الفنون في موقع مختلف إزاء النسيان. من وجهة النظر هذه، الشِعر محفوظ. مَن يقرأ نشيد (بودلير)، لا يسعه أن يقفز فوق كلمة واحدة منه. وإذا أحبه، سيقرؤه عدة مرات وربما بصوت مرتفع. وإذا أحبه إلى درجة الجنون، سيحفظه عن ظهر قلب. فالشعر الغنائي هو معقل الغناء.
أما الرواية، بالعكس، هي قصر محصّن بردائة إزاء النسيان. وعندما أخصص ساعة لقراءة عشرين صفحة، فإن رواية من أربعمئة صفحة ستأخذ مني عشرين ساعةولنقل إذًا أسبوعًا. ونادرًا ما أجد أسبوعًا بكامله فارغًا. وعلى الأرجح ستخلل جلسات القراءة انقطاعات لعدة أيام، سيقيم خلالها النسيان ورشته على الفور، لكن النسيان لا يعمل في فترات الانقطاع فقط، بل يشترك في القراءة بشكل مستمر، بلا أي توقف، وأنا أقلب الصفحة أنسى ما قرأته توًا؛ ولا أحتفظ منه إلا بنوع من المختصر الضروري لفهم ما يليه، بينما تُمحى جميع التفاصيل والملاحظات الصغيرة والعبارات المثيرة للإعجاب. وذات يوم بعد سنوات، ستراودني الرغبة في التحدث إلى صديق عن الرواية، عندئذ ستتأكد أن ذاكرتينا اللتين لم تحتفظا من القراءة إلا ببعض المقتطفات، أعادتا بناء كتابين مختلفين لدى كل واحد منا.
ومع ذلك، يكتب الروائي روايته كما لو كان يكتب نشيدًا. انظروا إليه، إنه مذهول بالتأليف الذي يراه يرتسم أمامه؛ أدنى تفصيل مهم بالنسبة له، يحوّله إلى موتيف -موضوع فني أو أدبي صغير- وسيعيده في تكرارات عديدة وتنويعات وتلميحات كما في مقطوعة الفوغ -تنويع موسيقي تتكرر أجزاؤه. لهذا السبب هو لأنه واثق من أن الجزء الثاني من روايته سيكون أجمل وأقوى من الأول، لأنه كلما تقدم في قاعات هذا القصر، تضاعفت أصداء الجمل الملفوظة والثيمات المعروضة سابقًا، وبعد أن تتجملع في تناغم، ترن في كل الأجاء.