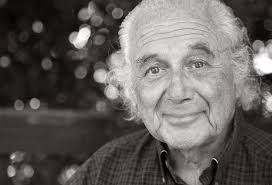لماذا نحترم أو حتى نقدّر الفلاسفة الذين يعانون من التمييز العرقي و التحيز الجنسي؟
جوليان باجيني فيلسوف بريطاني، نشر هذا المقال مطولاً في المجلة الرقمية (آيون) بتاريخ 7 نوفمبر 2018، وله العديد من الكتب والدراسات، وترجم له للعربية كتاب (حجج فاسدة: تجعلنا نبدو أغبياء)، وهو كتاب يستحق القراءة.
نقدم لكم هنا، ترجمة لمقاله “لماذا نحترم أو حتى نقدر الفلاسفة الذين يعانون من التمييز العرقي أو التحيز الجنسي”، بشكل حصري لدى ساقية.
أصبح سهلاً الوقوف على حافة الأخلاق عند الإشادة بأحد العقول العظيمة من الماضي، فلو قدَّرت (ايمانويل كانط)، سيذكرونك أنه يؤمن بتقسيم الناس على حسب اللون، فهو يقول: “كمال البشرية الإبداعي يكمن في العروق البيضاء”، ويقول: “الهنود الصفر لهم موهبة ضئيلة، والزنوج أقل منهم بكثير.” وعند احترام (أرسطو) سَتشرح كيف انَ الحكيم الحقيقي لم يسلم من التفكير في: “أن جنس الذكور بطبيعته متفوق، والأنثى أقل شائناً، والذكور أصلح للقيادة، والأنثى رعية.” وعند كتابة تأبين في (ديفيد هيوم)، كما فعلت أنا سابقاً، هاجمني أحدهم لرثاء مفكر كتب مرةً في عام 1753-54 ميلادي: “أنا لا أشك أبداً في أنّ الزنوج وجميع أنواع البشر هم بالطبيعة في مستوى أدنى من الإنسان الأبيض.”
نحن هنا عالقون في معضلة محيرة، فلا نستطيع رفض التحيزات العنصرية غير المقبولة باعتبارها غير مهمة، ولكن وإن فعلنا، وعاقبنا وجهات النظر و الأقوال اللا أخلاقية من الماضي؛ فلن يسلم أحداً في التاريخ ، وستقف هذه الأحكام حاجزاً عن تقدير عقلاً عظيماً في زمانه أو قائداً عسكرياً مهماً.
على أي حال، إنَ مسألة الحُكم تلقائياً بسبب التمييز العرقي، و التمييز الجنسي، وكل أشكال التعصب، ضد الشخصيات التاريخية القديمة، مسألة مضللة، ومخادعة. لأن من يتميز ضدهم يتخيل أنَّ من يحمل أياً من تلك الصفات لابد أن يكون فاسداً من الداخل. وقول ذلك دليل على وجود قصور في استيعاب الشروط الإجتماعية التي تؤثر على ماهية العقل؛ دون استثناء حتى الشخصيات العظيمة.
دواعي الغضب هو التصور في أن هؤلاء الفلاسفة فُضلاء، وأنهم منزهين عن الوقوع في أي وحل غير أخلاقي حتى لو كان المحيط من حولهم مصاب بالعمى الذي يمنعه عن رؤية الظلم، و يجب علينا أن نعرف الأفضل، وأن نتذكر الدرس التاريخي الموجع مع الرايخ الألماني الثالث (ألمانية النازية)، وكيف أنها كانت مدعومة بنسبة كبيرة جداً من الناس العاديين والبسطاء الذين لو قُدِرَ لهم أن يعيشوا في زمن مختلف لعاشوا حياة بريئة، ولكن الصدفة القدرية جعلتهم جزء من محيط ملوث، ولو كنا نحن جزء من ذلك الظرف الزماني والمكاني، ومع بالغ الثقة، لكنا سنفقع في نفس المأزق، ولهذا فنحن اليوم نعرف مالم يعرفه ذلك المجتمع وقتها، و عدم دعم النازية اليوم أمراً بديهياً لأننا رأينا العواقب التي نتجت عنها.
لماذا يؤمن الكثير بإستحالة عدم رؤية التمييزات العنصرية غير المنطقية وغير العقلانية الصادرة ممن يعرفون بمسمى”العبقرية”؟
أحد أهم الأسباب هو أن ثقافتنا مكونة من مفاهيم عميقة مبنية على افتراضات خاطئة في أن الفرد هو عقل بشري مستقل بذاته عن بيئته الإجتماعية، ولكن هذا الوهم المريح يسحقه معرفة علم النفس، وعلم الإجتماع، والأنثروبولوجيا..
تستطيع ثقافة التنوير المعتدلة أنّ تجعلنا نفكر أننا ذوات حُرة ولكن مشروطة بإعتبارات آخرى، وذلك بعيداً عن الوقوع في تشويش أوهام الثقافة التنويرية المثالية والتي تقترح أننا ذوات نفكر بأنفسنا في أننا مستقلين استقلالية فردية مطلقة، ولكي تتضح الصورة أكثر يجب أن لا نخلط بين الإثنين. لأن أفكارنا تتشكل من خلال محيطنا الإجتماعي بطرق عميقة لا يمكن ادراكها، و حتى الإنتباه لها في كثير من الأحيان. وألئك الذين يرفضون قبول قوى تأثير البيئة على أفكارنا لديهم أوهام جنون العظمة الفكرية.
عندما يكون الشخص متجذراً بعمق في نظام غير أخلاقي، فإنه يصبح من الصعب إعطاءه خصلة ” المسؤولية الفردية”. و المشكل، أننا متشبثون بالفكرة التي تدعي ان المسؤولية الأخلاقية مرتبطة تماماً باستقلال الفرد الذاتي المطلق. و بالمقابل من المرعب أخذ مسألة التكيف الإجتماعي مع المعتقدات و الممارسات المقيتة بحِدَّة، لأن الجميع سيتخطى المأزق، ولن يتبقى إلا التبرير عبر مفهوم” نسبية الأخلاق ” الميؤس منه.
إن كراهية النساء و التمييز العرقي قُبح لا يتغطى، لأنه نتائج المحيط الإجتماعي، على نطاق واسع، وعلى درجات عالية، أكبر من أن يكون فردي/شخصي. بالطبع، ذلك لا يعفي ديفيد هيوم من عنصريته النتنه، ولا يبرر لأرسطو تحيزه الجنسي ضد المرأة، فلم ولن تكن العنصرية والتمييز أمور حسنة قط، وهم بالفعل أشخاص آمنوا بها.
وكل ذلك لا ينفي السابق، بل يجب معرفة ان (ايمانويل كانط) و(هيوم) كانا نتاج بيئتهم، ومعرفة أيضاً أنه حتى العقول العظيمة لا تسلم من الوقوع في الأفخاخ المقززة عبر العمى عن الأخطاء والشرور التي تكون واسعة الإنتشار بما فيه الكفاية.
إن دفاع (إيديث هول) عن تحيز (أرسطو) ضد المرأة هو أنموذج على إنقاذ الفيلسوف من أسوء ما قد يعيشه. وبدلاً من الحكم عليه تحت معايير هذا الزمن؛ لابد أن نختبر طبيعة طريقة تفكير (أرسطو)، فتناقش (إيديث هول):
هل لو عاش بيننا اليوم (أرسطو)، هل ستؤدي به فلسفته إلى التحيز ضد المرأة؟ وبالنظر إلى انفتاح (أرسطو) على الأدلة والبراهين نجد وبكل يقين أن (أرسطو) اليوم سيكون مقتنعاً تماماً بالمساواة بين الرجل و المرأة. ولو طبقنا نفس التجربة على (ديفيد هيوم)، فلو كان بيننا اليوم لن يزدري أصحاب البشرات الداكنة. بإختصار، لا نحتاج للنظر بعيداً عن أساسيات فلسفتهم التي يقدمونها، لرؤية أماكن الخلل في طريقة تطبيقها.
أحد الأسباب التي تجعلنا نتردد في عذر عقول الماضي، هو أننا نخشى أن ذلك سيتبعه عذراً للتبرير عن الأحياء. ان عجزنا عن لوم (هيوم) و(كانط) و(أرسطو) على تحيزاتهم، كيف يمكننا أن نلوم الأشخاص الذين فضحتهم حملة #أنا_أيضاً بسبب الأفعال التي ارتكبوها داخل المحيط الإجتماعي حيث كانوا فيه طبيعين تماماً؟ ولكن، ألم يكن (هارفي واينستين) نموذج مثالي على “مدرب اختيار ممثلين وممثلات” في ثقافة هوليوود ؟ وداخل محيطه؟
وتوجد هنا نقطة مهمة جداً، وهي التفريق بين الأموات والأحياء، فالحي بستطاعته أن يرى سلوك الخطأ، ويعترف به، ويعتذر عنه، وربما يندم، وإذا ارتكب الحي جريمة وتسبب في ضرر، فإنه يواجه القانون والعدالة، ولا يمكننا قبول العنصرية والتمييز من الأحياء كما هو من الأموات. وأما تعديل المحيط الإجتماعي فيتطلب إظهار إمكانية تجاوز العنصريات ، ونشر الوعي ضد القُبح اذا تفاقم.
لسيوا مسؤولين الأحياء عن خلق القيم المشوهة القبيحة التي تصبح أجزاء من تكوين البيئة الإجتماعية، ولكن يمكنهم تحمل المسؤولية في كيفية التعامل معها…
لا يملكون الموتى نفس الفرصة، فبالتالي تصبح ممارسة الغضب نحوهم مضيعة لا فائدة منها. فنحن على حق حينما نأسف على خطايا الماضي، ولكن من القسوة إلقاء اللوم على الأفراد بسبب مافعلوه في أوقات أقل استنارة إستناداً على معايير اليوم.
[المصدر]