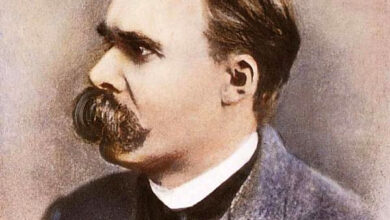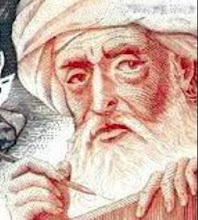في تلاقي الدين بالفلسفة، نديم الجسر يكتب

الشيخ نديم الجسر (1897 – 1980)، رجل دين وسياسي لبناني، ينحدر من أسرة مصرية الأصل، في كتابه (قصة الإيمان: بين الفلسفة والعلم والقرآن) ينقل قصة (حيران بن الأضعف) مع شيخه الموزون في عزلته الواقعة في مسجد مبني عند ضريح الأمام البخاري رضي الله عنه.
يقول حيران بن الاضعف:
لما كنت اطلب العلم في جامعة بيشاور كانت النفس الطلعة مشوقة، بفطرتها، إلى المعرفة : تستشرف كل غيب، وتشرئب إلى كل مجهول، فتبحث عن أصل كل شيء، وكهنه، وسببه وعلته، وسره وحكمته، فكان دأبي وديدني أن اسأل الشيوخ والرفاق عن هذا العالم، ما هو، ومتى خلق، ومم خلق، ومن الذي خلقه، وكيف خلقه ؟ فلا أقابل على هذه الأسئلة إلا بالزجر، ولا أجاب عليها إلا بالسخر، فيقول المشايخ عني : هذا ليس بطالب علم ولا دين .. إن هو إلا متفلسف سخيف.
ثم يقول كيف زاده هذا التهكم و الزجر إصرارا وشكاً:
وزادني هذا التهكم إصرارا وشكاً، حتى وقر في نفسي أن الحقائق التي انشدها، لا تدرك ولا تعلم، إلا من طريق الفلسفة، وان العقل والدين لا يجتمعان، ولو لا ذلك ما نفر مشايخي من الفلسفة، ولا تهربوا من الخوض معي، وفي كل جدل عقلي، حول سر الوجود، فأهملت دروس الدين، وأخذت ابحث عن كتب الفلسفة.
وتلا ذلك أن تم طرده من الجامعة و محاولة والده نصحه بترك الفلسفة والانصراف إلى علم الدين حتى ينتهي منه ثم ينكب على الفلسفة انكباباً صحيحا يقول حيران عن والده:
وقال لي في آخر حديثه: يا (حيران) لقد مرت في مثل الذي أنت فيه، فمالت نفسي إلي الفلسفة وأوغلت في الشك والحيرة لكن استأذنا الأكبر العارف بالله الشيخ (أبو النور الموزون السمرقندي)، الذي كان فقيهاً كبيراً، وعالماً جليلاً، وفيلسوفاً عظيماً، نصحني، يومئذ، بمثل ما أنصحك به اليوم وقال لي: “إن الفلسفة بحر، على خلاف البحور، يجد راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطآنه، والأمان والإيمان في لججه وأعماقه”
دله والده على مكان الشيخ (الموزون)، دون أن يعلم أنه دله على طريق الفرار من الجامعة، رحل (حيران) إلى سمرقند حيث مال (الموزون) في شيخوخته، إلى الزهد والانقطاع لله، في مسجد مبني عند ضريح الأمام البخاري رضي الله عنه. فيقص كيف كان لقاءه فيه فيقول:
وفي الصباح الباكر حملت جونة الشيخ، وأمر كبير القرية، رجلا، أن يدلني على البستان الذي يسرح الشيخ فيه. فسار بي حتى أوصلني إلى المسجد، ثم دلني على البستان، وعلى المكان الذي جرت عادته أن يضع فيه الطعام، فدنوت من سياج البستان، ووضعت الجونة في مكانها و ثم علقت بحرفها ورقة صغيرة كتبت فيها هذه الكلمات:
ما ..؟ ومن ..؟ ومم..؟
وكيف …؟ وأين …؟ ومتى…؟
توارى (حيران) خلف الشجرة متشابكة الأغصان، انتظر حتى دنا الشيخ من السياج واقبل نحو الجونة، فلما تناولها وقعت عيناه على الورقة، وقرأ ما فيها، يقص (حيران) كيف تأثر الشيخ بما في هذه الورقة فيقول:
اخذ يتلفت يمنه ويسره، ثم ترنح وسقط مغشياً عليه. فعودت نحوه، وفعلت كل ما أمكن حتى أنعشه. فلما أفاق من غشيته، فتح عينيه، ونظر إلي نظرة طويلة ثم تمتم قائلاً: لا تخف ساعدني على النهوض، فساعدته حتى دخلت به البستان، فجلس على حرف الساقية، فغسل وجهه، واستسلم إلى السكون، وهو مغمض العينين. وبعد صمت طويل سمعته يقول، بصوت بحة الباكي: لا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها ثلاثا .. ثم التفت إلى وقال: يا بني. لقد أزعجتني، وأفسدت علي لذة استغراقي في ذلي وانكساري إلى لله، وذكرتني بشر ما كانت تعانيه النفس من غصص الحيرة والشك .. سامحك الله . من أنت يا ولدي ؟
قلت: أنا حيران بن عبد لله الأضعف، تلميذك البنجابي القديم.
قال: أهلا بك. كيف حال أبيك ؟ قلت: بخير.
قال: أراك وقعت في مثل ما وقع فيه أبوك من قبل ؟
قلت: نعم، وهو الذي دلني عليك وأرشدني إليك يا مولاي.
فنظر إلي الشيخ نظرة طويلة، ثم حول وجهه إلى الماء وأطال النظر فيه، واغرورقت عيناه بالدموع، ثم قال: وراحمتاه لكم يا شباب هذا الجيل. انتم المخضرمون بين مدرسة الإيمان عن طريق النقل، ومدرسة الإيمان عن طريق العقل. تلوكون قشوراً من الدين، وقشوراً من الفلسفة، فيقوم في عقولكم، أن الإيمان والفلسفة لا يجتمعان، وأن العقل والدين لا يأتلفان، وأن الفلسفة سبيل الإلحاد. وما هي كذالك يا والدي، بل هي سبيل لأيمان با لله، من طريق العقل.
طلب منه الشيخ أن يحضر له فراش لينام في المسجد، ودفتر كبير، ليكتب فيه، وخصص الليل لدرس والنهار لعزلته في الانقطاع لله.
وفيما يخص الأسئلة التي كتبها (حيران) على الورقة يقول الشيخ:
أسئلتك هذه. هي التي شغلت عقول الفلاسفة، بل عقول الناس كافة، منذ بدأ الإنسان يفكر . والفلسفة هي التي تحاول أن تجد لها جواباً. أما أنها وجدت الجواب الصحيح، على كل سؤال، أو لم تجده، فهذا شيء سوف تعرفه أذا بلغت الغاية. فالفلسفة تريد أن تعرف يا (حيران)، حقيقة كل شيء وكنهه، وأصله، وغايته، ولا تكتفي بالظواهر بل تريد النفوذ إلى البواطن، ولا تكتفي بهذا العالم المحسوس، بل تريد أن تعرف ما وراءه، وما كان قبله، وتريد أن تعرف من الذي خلقه ومن أي شيء خلقه، ومتى خلقه، وتريد أن تعرف ما هو هذا الخالق وما كنه ذاته، وحقيقة صفاته، وما هو هذا الإنسان، وما حقيقته، وما هو عقله، وكيف يتم إدراكه، وما مبلغ هذا الإدراك من الصحة، وما هو الخير، وما هو الجمال، ولم كان الخير خيرا، والجميل جميلاً إلى غير ذلك من الأسئلة التي لا تنتهي، سعياً وراء معرفة المبادئ الأولى لكل شيء . لذلك قالوا في تعريف الفلسفة: أنها النظر في حقيقة الأشياء، وقالوا: أنها علم المبادئ الأولى، وقالوا غير ذلك أما أنا، فاني أعرفها لك، بأنها محاولة العقل أدراك كنه جميع المبادئ الأولى، وسوف ترى أن كنت على حق في هذا التعريف.
وفي الفرق بين العلم والفلسفة يقول الشيخ:
أن العلم يكتفي بدرس ظواهر هذا الكون، ونظمه، ونواميسه، أما الفلسفة فتبحث في أصل الكون وعلته، وحقيقته.
ويقول في جوهر الفلسفة:
فالفلسفة كانت وما زالت، في جوهرها، عبارة عن البحث عن الله.
ويرى أن الفلاسفة اليونان:
أخذوا يبحثون عن الإله الحق، الذي ليس كمثله شيء من حيث لا يشعرون.
وعن اجتماع الدين والفلسفة في قلب المؤمن يقول: أن نتاج الفلسفة الصحيح لا يتنافى أبداً مع الدين الحق، في إثبات وجود الله ووحدانيته، بل يؤيد هذا الإثبات الذي جاء به الوحي بالنظر العقلي الخالص. فهذا ما أرشد أليه الشيخ، وخبره بنفسه.
وفي إمكانية الجمع بين الفلسفة والدين والتقائهما في الحق ينقل عن (ابن مسكويه) هذا القول:
بأن الإنسان نفسه لا يزال يرتقي ويزداد ذكاء، وصحة في التفكير، وجودة في الحكم، حتى يبلغ الأفق الأعلى الذي يتعرض به لأحدى منزلتين؛ إما أن يديم النظر في الموجودات ليتناول حقائقها، فتلوح له الأمور الآلهية، وإما أن تأتيه تلك الأمور من الله تعالى، من غير سعي منه. وصاحب المنزلة الأولى هو “الفيلسوف”، وصاحب المنزلة الثانية هو “النبي” الذي يتلقى فيضاً من الله تعالى. فإذا التقى من وصل من أسفل بالتفلسف، ومن تلقى من أعلى بالفيض، أتفق رأيهما وصدق أحدهما الآخر، بالضرورة، لاتفاقهما في تلك الحقائق .
وهو في ذلك إنما أراد التلاقي على الحق في شيء واحد الأيمان بوجود الله. وليس التساوي في القيمة والقدر والعلم والعصمة.
وفي كراهية العلماء السلفيون الذين يكرهون هذا التعمق الفلسفي في الاستدلال على وجود الله يقول:
أنهم كانوا على حق قبل أن تعم البلوى، فقد كان المسلمون في العصر الأول من الإسلام لا يعرفون هذا الجدل الفلسفي حول وجود الله وصفاته، وأما بعد أن ترجمت الفلسفة اليونانية، وخاض كثير من علماء المسلمين فيها و ألفوا، وانتشرت بين الناس شبه الفلاسفة واشتهرت وعمت البلوى، وانبرى كثير من علماء الدين على الرد، على تلك الشبه، فقد أصبح الخوض في الفلسفة أمراً لابد منه، بل أصبح الاطلاع عليها واجباً على علماء الدين بوجه أخص ليتمكنوا من حسن الدعوة إلى الإيمان بالله.
يقول (الغزالي): أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كهنه، رد في عماية. ولهذا رأى أن يطلع على آراء الفلاسفة الآلهيين اطلاعاً تاماً قبل أن يرد عليهم فوضع كتابه (مقاصد الفلاسفة)، ثم وضع كتبه الشهير (تهافت الفلاسفة).
وعن الشبهات التي ترمي بعض فلاسفة المسلمين بزندقة وتشكيك بإيمانهم فبشأن (الرازي)، و(الفاربي) و(ابن سينا) يقول:
أنهم من أعظم المؤمنين بالله، ومن أصدقهم برهانا على وجود الله، وكيف لا يكونون كذلك، وهم كغيرهم من فلاسفة المسلمين، قد جمعوا إلى أيمان الوحي الصادق، وإيمان العقل السليم، نورا على نور. ولكن هؤلاء أخذوا بترهات الأفلاطونية الحديثة وخيالاتها في مراتب الخلق و وسائطه، وأختلط عليهم الأمر فحسبوها من كلام (أرسطو)، وحال إجلالهم للمعلم الأول، دون تمحيصها، لذلك كان على من يكتب عن هؤلاء أن يمحص أقوالهم ويميز بين ما فيها من الحق النير والباطل المظلم، وهذا ما لم يفعله الذين كتبوا عنهم، أما عجزاً عن التميز، أو زهداً في نصرة الأيمان، أو كيداً للإيمان.
هل القران لم يترك شيئاً من العلوم إلا وأشار إليه؟ يقول الشيخ في ذلك:
كلا هؤلاء الذين يقولون ذلك ليسوا بعلماء ولا عقلاء ولا أذكياء، فالقران ليس بدائرة معارف علمية. ولا من مقاصده أرشاد الناس، إلى العلوم الكونية، من باب التعليم. ولكن ما ورد فيه من الآيات، التي تشير إلى حقائق كونية كشفها العلم. إنما ورد بقصد التنبيه إلى ما في خلق العالم من آثار الإرادة، والقدرة، والعلم والحكمة، والإتقان، والاتزان، الدالة على وجود الله، والنافية لتكوين بالمصادفة، ولم يقصد به تقرير العلوم الكونية لأن القران خاطب البشر بلغة البشر، والله أحكم من أن يخاطب الناس بأمور لا يعرفون أسمائها، فضلا عن أسرارها، ولكنه أشار إلى دلائل وجوده، وقدرته وإرادته، وعلمه، وحكمته، ببيان عجيب يفهمه، على ظاهره، البدوي الساذج في القرن السابع عشر. ويفهم أسراره رجل العلم في القرن العشرين.
خاتمة الكلام يقول (حيران):
وبعد أن قضيت في ضيافته شهراً كاملاً، استأذنته، في السفر، والعودة إلى بلادي، وذكرت له عذري، وارتباطي بالأمير فقال لي: يا أبا النور! هذه الأيام المعدودات التي سمعت بها الدروس لا تكفيك، ولكني أنصحك أن تكثر من قراءة الفلسفة، حتى لا تترك منها شياً، وتكثر من قراءة علوم الطبيعة، وتكثر من قراءة القران.
قلت: كيف أكثر من قراءة الفلسفة وهذا الشك ما أتاني إلا منها ؟
قال: يا ولدي أبا النور ؛ أن الفلسفة بحر، على خلاف البحور، يجد راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطآنه، والأمان والإيمان في لججه وأعماقه. فاقرأها يا أبا النور، بصبر وأناة، ولا تترك شيئاً مما قاله الفلاسفة عن وجود الله وأحاديته. ثم اجمع أقوالهم، وقارن بينها ووازن، ثم اجمع من القران كل الآيات الدالة على وجود الله، واقرأها بتدبر، على ضوء ما قرأت من الفلسفة والعلم. وارجع، في التوفيق بين العلم والدين، إلى تحكيم العقل. وسوف تجد نفسك، بعد ذلك، في أحضان الإيمان واليقين. وأكثر، يا أبا النور، من قراءة سورة الضحى وسورة الأنبياء. ولا تقنط من رحمة الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يصلح بالك. ويهديك إلى طيب القول، وإلى صراط مستقيم.