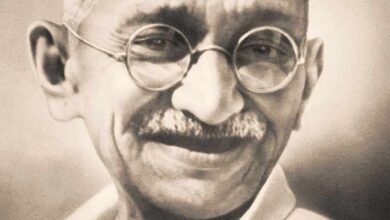الفن كواقع ثالث برأي رينيه هويغ
رينيه هويغ (1906-1997) كاتب فرنسي في التاريخ وعلم النفس والفلسفة الفنية، له حوار منشور في كتاب مع الفيلسوف الشاعر الياباني (دايساكو إيكيدا) حول الأزمة المعاصرة بعنوان (شرق وغرب حوار في الأزمة المعاصرة).
يرى (هويغ) أن الفن واقع ثالث أنشأه الإنسان بين واقعين أساسين يعيش بينهما، وحول الواقعين يقول:
فهناك من جهة، الواقع المحسوس المنظم في المكان والمكون من المادة والذي تلاحظه أعضاؤنا الحسية، أعضاء جسدنا. ولكن هناك واقعًا آخر هو الواقع الداخلي الذي هو أقل تعلقًا بالمكان منه بالزمان لأنه لا يقع في أي مكان ونقول بحق أنه موجود -داخل رؤوسنا-
وبالنسبة لكل مشاكل الحياة البشرية فإن منشأها عند (هويغ) هو:
أن كل مشكلة الحياة البشرية هي هذا التقاطع وهذا التداخل بين بعد هو المكان الذي يستقر فيه جسدنا وبعد آخر هو الزمان الذي يحمل وينقل حياتنا الواعية واللاشعورية. ذلك أننا زمن، فنحن نهرم في كل ثانية من الزمن فلا نظل نحن بالذات، فالزمن هو جوهر وجودنا الانساني.
وكيف أن الفن يكون واقعاً ثالثًا يتوسط هذين الواقعين يضيف:
أن الفن يستعير من عالم المادة والمكان العناصر جامدة كالحجر والرخام والخشب ..إلخ، فيثبت في هذا العالم وينقش آثار ومرتسم العالم الداخلي، العالم الذاتي.
وهكذا ومع الفن لم تعد فقط للإنسان مساكنة مألوفة بين عالمه الذاتي الذي يحرك حياته الداخلية والعالم الموضوعي الذي يقع فيه جسديًا ويعرض فيه نشاطه.
فهناك اندماج العالمين، اندماجًا مفاجئًا تحقق وتجسد في أثر فني.
يرى هويغ أن الأثر الفني يتألف من قسمين هما:
الأثر الفني له تكوين مادي، هو مادة البناء، وله فضلاً عن ذلك محتوى هو نوع من الحالة الداخلية التي تنبثق منه مثلما يمكن لحياتنا النفسية أن تعبر عنها النظرة.
ونختم بالغاية الأساسية للفن عند (هويغ): “وتبقى غاية الفن الأساسية الانتقال من الزمان إلى المكان”.