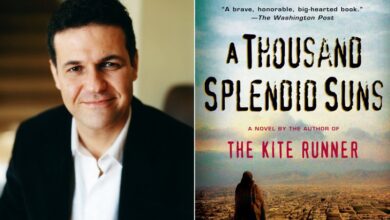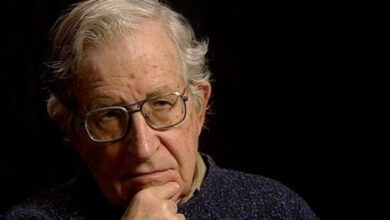الحب عند حنة أردنت وكيفية العيش بخوف متأصل من الخسارة
هذا المنشور هو نتاج للتعاون بين منصة ساقية ومنصة إكليل، ضمن مبادرة (عشر سواقي 2019)
“أحب لكن حذارِ مما ستحبه” كانت هذه النصيحة التي كتبها الفيلسوف الروماني الأفريقي القديس (أوغسطينوس) في السنوات الأخيرة من القرن الرابع. وإذا نظرنا للأمر بعمق فإننا ما نحب -نصبح هو بقدر ما يصبح هو نحن، فهو يستدعي عددًا من بواعثنا الواعية واللاواعية من شوقٍ ويأسٍ ورغبةٍ منقوشة فينا. ولكن يظل هناك تناقضٌ عميقٌ يشوب هذا النداء للتفكير بهذا المفهوم لكوننا نمارس الحذر والحيطة في الحب- لتحب يعني أن تعرف حدود اللاعقلانية التي تهوي وتنزلق حتى من بين يدي أصلب العقول وأعندها حين يمسك القلب بزمام الأمور بتلك اللامبالاة اللذيذة التي هي صفته.
كانت فكرة كيفية إتباع نصيحة (أوغسطينوس) لا بالخضوع بل بفهم أعمق لتجربتنا في الحب هو ما بحثت فيه (حنة أردنت) في عمله الأقل شهرة ولكن الأجمل (الحب والقديس أوغسطينوس)، وهي أول مخطوطة بحجم كتاب لـ(حنة أردنت) وآخر ما نُشر بالإنجليزية، والذي أنقذته العالمة السياسية (جوانّا فيكشيارلي سكوت) والفيلسوفة (جوديث شيلس ستارك) من أوراقها بعد وفاتها.
يتضح أنها و بعد نصف قرن من كتابتها لهذا العمل كأطروحة لدرجة الدكتوراة سنة 1929 -في الوقت الذي سيصبح فيه هذا العقل حواريّ المنطق والذي سيصبح أحد أعمق عقول القرن العشرين التحليلية والتي كان أثناءها تؤلف رسائلها المتقدة المتبادلة مع (مارتن هيدجر)- راجعت المخطوط و شرحته. وعلى النقيض من تخلي (أوغسطينوس) عن أفكاره الفلسفية شحذت (أردنت) جوهر فلسفتها وعلى رأسها القطيعة المقلقة التي رأتها بين الفلسفة والسياسة كما يتجلى ذلك في ظهور أيدولوجيات من قبيل الشمولية والتي بحثت فيها بجهود واضحة لا تخفى. وكانت استعارت من (أوغسطينوس) العبارة “ amor mundi” أي حب العالم والتي ستصبح سمة مميزة لفلسفتها. يأسرها سؤال لِم نخضع للشر و نطبعه حددت (حنة) جذور الطغيان بأنها فعل تحويل البشر الآخرين لكائنات لا أهمية لها، ومرارًا وتكرارًا رجعت إلى ترياق (أوغسطينوس): الحب.
لكن بينما كان مفهوم حب الجوار القديم والذي كان ملهمًا لـ(لوثر كنج) محور اهتمام (حنة) الفلسفي الأساسي وسبب اهتمامها بـ(أوغسطينوس) فإن أهمية السياسية لا تنفصل عن النبع الأعمق الذي لا بنضب للحب: الحب الشخصي. فكل الحكمة السياسية والفلسفية التي استقتها من أفكاره كانت (اعترافات أوغسطينوس) فيها يحركها تجربته الشخصية في الحب- القوة الأبدية التي تحكم الشمس والقمر ونجوم حيواتنا الداخلية- والتي انعكست ودونت في بنيتنا الثقافية والإجتماعية.
واضعة نصب عينيها تصور (أوغسطينوس) عن الحب كـ “نوعٍ من الشهوة” (appetitus) وهي الكلمة اللاتينية التي اُشتقت منها كلمة شهية، وتأكيده على “أن الحب ما هو إلا اشتهاءٌ لشيء لذاته ورغبة به” اعتبرت حنة هذه الرغبة الموجهة بدافع حبًا:
“كل شهوة مرتبطة بكيان محدد، وهذا الكيان هو كل ما مطلوب لإثارة هذه الرغبة وبالتالي ابتكار هدفٍ لها. إن الشهوة تتحدد بإعطائها ما تسعى إليه بالضبط كحركة يحددها الهدف الذي تتحرك باتجاهه”. لذا فالحب كما كتب (أوغسطينوس) “شكلٌ من أشكال الحركة وكل حركة هي باتجاه شيءٍ ما”. أما ما يحدد حركة الرغبة فهو معروف دومًا مُسبقًا، فرغبتنا بشيء تهدف إلى عالمٍ نعرفه و لا تكتشف شيئًا جديدًا لا نعرفه. إن الشيء الذي نعرفه ونرغب به هو “جيد” وإلا لما كنّا نسعى إليه شوقًا، كل الأشياء الحسنة التي نرغب بها في حبنا الذي نسعى إليه هي كيانات مستقلة غير مرتبطة بكيانات أخرى، وكل كيان منها لا يمثل إلا حسنه هو المنفرد. أما السمة التي تميز هذا الشيء الحسن الذي نرغب به هي أننا لا نملكه. ومتى ما نلنا هذا المرغوب تنضب رغبتنا ما لم نكن مهددين بفقده، وحينها تتحول الرغبة التي كانت تعترينا إلى خوف من الفقد. كمسعى للحصول على ذلك الشيء الحسن تحديدًا لا الحصول على أشياء كثيرة عشوائيًا تكون الرغبة خليطًا بين “استهداف” و“الإشارة إلى”. إنها الإشارة إلى الفرد الذي يعرف خير العالم وشره ويسعى إلى العيش بسعادة، ذلك لأننا نعرف السعادة التي نريدها لنكون سعداء، ونظرًا لأنه لا شيء مؤكد وثابت كرغبتنا بأن نكون سعداء فإن مفهومنا للسعادة يرشدنا في تحديد الأشياء الحسنة المعنية التي ستصبح بعدها رغباتنا. الشهوة أو الحب هو إمكانية الظفر بامتلاك الإنسان للحسن الذي سيجعله سعيدًا، هو الظفر بحيازة ما هو على الأرجح يخصه.
لهذا السبب يبدو الحب الكريم غير المتملك -الحب الذي لا يُنقصه الفشل ببلوغ الحسين الذي يرغب به- كإنجاز لا يقدر عليه إلا إنسان خارق. (“إذا لم تكن العاطفة متساوية/ فلأكن أنا الأكثر حبًا” كان هذا ما كتبه صديقه الطيب لـ(حنة) وأشد معجبيها (ويستن هيو أودن) في قصيدته السامية الموجهة “انتصار قلب الإنسان الخارق” لكن الحب المبني على التملك تحذر (حنة) من تحوله إلى خوفٍ حتمي، الخوف من خسارة ما كسبت. بعد ألفي سنة من تقديم (إبكتيتوس) وصفته لعلاج القلب المكسور قبولٍ لفكرة أن كل الأشياء فانية وكذلك الحب الذي يجب التمسك به بأصابع الانفصال الطليقة كتبت (حنة) -التي لاحظت دين (أوغسطينوس) للفلسفة الرُّواقية- تقول:
طالما أننا نرغب بأشياء زائلة لزمن طويل نحن مهددون دومًا، ويماثل خوفنا هذا من الخسارة والفقد رغبتنا بالامتلاك. تنبع الأشياء الحسنة المؤقتة و تهلك منفصلةً عن ذلك المربوط بها برغبته. مقيدين دومًا بالرغبة والخوف من مستقبل تملؤه الشكوك نجرد كل لحظة من لحظات المستقبل من سكينتها وقيمتها الجوهرية تلك التي لا نقدر على الاستمتاع بها. وهكذا يدمر المستقبل الحاضر.
أضافت (حنة) بعد نصف قرن من تحذير (تولستوي) بأن “الحب في المستقبل غير موجود لأن الحب فعل حاضر فقط“:
ليس الحاضر محددًا بالمستقبل على هذا الأساس.. ولكن بسبب أحداث معينة نتمناها أو نخاف المستقبل بسببها، والتي تبعًا لها نشتهي ونسعى، أو نتحاشى ونتجنب. تتمثل السعادة في التملك، في حيازة الحسن الذي يخصنا والاحتفاظ به، بل وحتى في الثقة بعد خسارته وفقده. لكن سعادة الامتلاك بالنسبة لـ(أوغسطينوس) لا يناقضها الحون ولكن الخوف من الفقد. إن مشكلة سعادة البشر أنها مثقلة دومًا، ليست المشكلة في انعدام الامتلاك بل سلامة الامتلاك واستمراريتها هي التي على المحك.
والموت طبعًا هو الخسارة العظمى – في الحب وكذلك في الحياة- و هو لذلك العنصر الأقوى في مستقبلنا الذي يحكمه الفزع. ورغم ذلك فإن الهرب من الحضور من بوابة القلق -الذي هو ربما الداء الأكثر عرضة للإصابة به- هو ذاته موت على قيد الحياة عن ذلك كتبت (حنة):
خوفًا من الموت يعيش هؤلاء حياة الخوف، حياة مآلها الموت.. المزاج الذي تُعرف فيه الحياة وتصور على أنها قلق، وحينها يصبح موضع الخوف خوفًا بذاته. وحتى لو علينا أن نفترض عدم وجود ما يتطلب خوفنا، وأن الموت ليس شريرًا، ستظل فكرة الخوف من أن كل الأشياء ستتلاشى وتفنى.
وبعيدًا عن هذه الخلفية السلبية تشكل (أردنت) وتمثل شكل هدف الحب الأسمة حسب (أوغسطينوس):
إن الجسارة والشجاعة هي ما سعى إليه الحب. فالحب كرغبة يحدده هدفه وغرضه، وهذا الهدف متحررٌ من الخوف.
وعن العاطفة توضح الآلية الجوهرية التي يخدع فيها الإحباط الرضى (المؤقت) في الحب الرومنسي تضيف:
الحب الذي يسعى إلى أي شيء آمن ومتاح على الأرض دومًا ما يكون حبًا محبطًا يتحول ويصبح هدفه وغرضه باطلًا، وحينها لا يعود أي شيء مرغوبًا سوى الحرية من الخوف. وشجاعة كهذه لا توجد إلا في السكينة التامة التي لا تعود أحداث المستقبل قادرة على زعزعتها.
إذا كان الحاضر – طارد التوقعات- شرطًا أساسيًا لتجربة حب حقيقة، فإن الزمن هو العنصر الأساسي الهيكلي للحب. بعد قرابة نصف قرن وبعد ما أصبحت أول امرأة تتحدث في محاضرات (جيفورد) الشهيرة في الذكرى الخامسة والثمانين للسلسلة، ستجعل أردنت هذا المفهوم عن الزمن كانطلاقة للأنا المفكرة محورًا لمحاضرتها الهامة حياة العقل. والآن وبالاقتباس من كتابات (أوغسطينوس) تأخذ بعين الاعتبار مفارقة الحب خارج حدود الزمن للمخلوقات الزائلة مثلنا:
حتى لو كان يفترض بالأشياء ألا تزول فإن حياة الإنسان ليست كذلك. نحنُ نخسرها يوميًا. فبعيشنا تمرنا السنون وتبلينا نحو العدم. ويبدو أن الحاضر هو الحقيقي فقط بالنسبة “لأشياء مضت وأشياء لن تأتي“، ولكن كيف يمكن للحاضر -الذي لا أقدر على قياسه- أن يكون حقيقيًا وهو لا يملك أي “حيزًا”؟ إن الحياة دومًا هي إما لا مزيد أو ليس بعد، وكالزمن تنبع الحياة من “ما ليس بعد مارةً بما لا يملك حيزًا ومختفية في ما عاد موجودًا“. هل يمكن قول أن الحياة موجودة أصلًا؟ تظل حقيقة أن الإنسان يقيس الزمن، ربما يتملك “الحيز” حيث يمكن حفظ الزمن كفاية لقياسه وليس هذا “الحيز” والذي يحمله الإنسان معه متخطيًا الحياة والزمن؟
يوجد الزمن بقدر ما يُمكن قياسه والمعيار الذي نقيسه به هو الحيز.
بالنسبة لـ(أوغسطينوس) كما لاحظت الذاكرة هي الحيز الذي يُقاس فيه الزمن ويخبأ:
الذاكرة هي مستودع الزمن، هي حضور “لا أكثر من ذلك” كاستثناء لحضور “ليس بعد”. لذلك لا أقيس لا أكثر من ذلك، ولكني بعض الأحيان أفعل ذلك في ذاكرتي التي يظل ثابتًا فيها. لا يوجد الزمن أبدًا إلا باستدعاء الماضي والمستقبل إلى حاضر التذكر والتوقع. و من ثم فالزمن الصحيح الوحيد هو الحاضر، الآن.
أحد أهم الثيمات التي بحثت فيها خلال الاكتشاف هو سؤال الزوال هذا حتى لأكثر تجاربنا خصوبةً. كتبت (مارجريت فولِّر) -إحدى كتابي المفضلين- مرةً: “اتحاد طبيعتين معًا لزمنٍ أمر عظيم“. هل علينا أن نيأس أو نبتهج بخصوص حقيقة أن حتى أعظم حب يوجد فقط “لزمن”؟ إن ميزان الزمن مرن، ينكمش ويتمدد بعمق و جسامة كل حب، لكن له دومًا نهاية وحدود كالكتب، كالحيوات، كالكون نفسه. إن نصر انتصار الحب هو في الشجاعة والنزاهة التي نُسكن فيها التجربة الفائقة الزائلة التي تجمع شخصين لمدة من الزمن قبل أن تحررهم بنسبة متساوية من الشجاعة والنزاهة. غلب تعجب فولِّر من رؤية لوحات كورديجو لأول مرة على الجمال الذي عرفته قبلًا، الجمال الذي يشع حقيقة ضخمة عن قلب الإنسان: “يا روح الحب الحلوة! عليّ أن أقلق منك أيضًا لكنها كانت جميلة ذاك اليوم“.
حددت (أردنت) مكان هذه الحقيقية الجوهرية عن القلب في كتابات (أوغسطينوس). فبعد قرن من تأكيد (كيركغورد) أن “أن اللحظة على الأرجح ليست ذرة من الزمن ولكنها ذرة من الخلود” لاحظت:
الآن هو ما يقيس الزمن جيئةً وذهابًا؛لأن الآن بالمعنى الدقيق لكلمة ليس الزمن ولكنه خارج الزمان. في الآن يتقابل الماضي والحاضر، لأجل لحظة عابرة هما متزامنين ليحفظا في الذاكرة التي تتذكر الأشياء الماضية وتحمل توقعات ما سيأتي مستقبلًا. لأجل لحظة عابرة (الآن الزائل) كأنما يبقى الزمن ثابتًا، و الآن هو ما أصبح نموذج (أوغسطينوس) للأبدية.
و(أوغسطينوس) نفسه رصد هذا الزوال المهم:
من سيمسك القلب و يعالجه ليبقى ثابتًا لبرهة ويلتقط للحظة روعة الأبدية التي تبقى ثابتة للأبد، ويقارنها باللحظات العابرة الزائلة التي لا تثبت ولا تبقى، ويرى أنها لا تُقارن.. لكن و لأن كل هذا في الأبدية لا شيء يمضي ولا يمر لكن الحاضر هو الكامل.
اتجهت (أردنت) إلى قلب المفارقة:
ما يمنع الإنسان من “العيش” في الحاضر الأزلي هو الحياة نفسها والتي لا “تثبت” إطلاقًا. الشيء الحسن الذي يشتهيه الحب ويرغب به موجود بعيدًا عن كل الرغبات المجردة. فإذا كان محض سؤالٍ وبحثٍ عن الرغبة فإن كل الرغبات ستنتهي بالخوف. ولأن أي شيء يواجه الحياة من الخارج كيكان لما يرغب به هو ما يُسعى إليه لأجل الحياة (الحياة التي سنفقدها) فإن الكيان والشيء الأقصى الذي نرغب به هو الحياة ذاتها. الحياة هي الشيء الحسن الذي علينا أن نسعى إليه وتحديدًا الحياة الحقيقية.
ثم تعود إلى الرغبة التي تأخذنا في الوقت نفسه خارج الحياة و تغرقنا فيها:
تتوسط الرغبة بين الموضوع والهدف وتبيد المسافة بينهما بتحويل الموضوع إلى حبيب والهدف إلى محب. وبالنسبة للحبيب فهو لا ينفصل أبدًا عن ما يحبه، هو ينتمي له.. لكون الإنسان كائن غير مكتفٍ بذاته ولذلك دومًا ما يرغب بشيء خارج نفسه، وسؤال من هو يمكن إجابته فقط بالحصول على ما يرغب به وليس بكبت دوافع الرغبة نفسها -كما تعتقد الفلسفة الرُّواقية -: “كل أحد هو ما يحب” كما كتب (أوغسطينوس) بدقيق العبارة: من لا يحب ولا يرغب هو لا أحد إطلاقًا.
هذا الشخص لا يمكن تحديد جوهره؛ لأنه دومًا يرغب بالانتماء لشيء خارج نفسه ويتغير تبعًا لذلك… وإذا ما أمكن قول أن له طبيعة واحدة جوهرية فهي انعدام اكتفائه الذاتي. وبالتالي فهو منقاد للهرب من عزلته بوسائل الحب لبلوغ السعادة، التي هي نقيض الوحدة والعزلة، وما هو مطلوب أكثر من الانتماء المحض. لا تحقق السعادة إلا عندما يصبح المحبوب عنصرًا أصيلًا دائمًا في وجود الواحد الذاتي.
[المصدر]