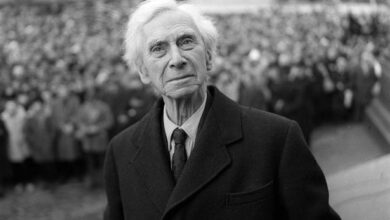الحب كمعنى للحياة في منهج الإنسانوية الجديدة

لوك فيري، فيلسوف فرنسي، من مواليد 1952. شغل منصب وزير التربية والتعليم في فرنسا ما بين 2002 و2004. هو واحد من الفلاسفة الفرنسيين الجدد، الذين أحدثوا تحولا عميقا في الأوساط الفلسفية السائدة، برموزها المعروفة أمثال (جاك دريدا) و(جاك لاكان) و(جيل دولوز) و(ميشال فوكو) وغيرهم؛ لاعتقادهم أنّ الفلسفة ضلّت الطريق بتوغلها في مباحث فكرية ومعرفية عويصة ومعقدة لايفهمها إلا خاصّة الخاصّة. في كتابه (أجمل قصة في تاريخ الفلسفة)، تحدث عن مراحل الفلسفة، ابتداء من الفلسفة اليونانية، ثم التنويرية، والإنسانوية، والتفكيكية. واختتم كتابه بالحديث عن فلسفته الخاصة أو قراءته للفلسفة القادمة والتي يقرأ انتشارها في الواقع، ألا وهي “الإنسانوية الثانية” كما اختار التعبير عنها، يقول:
نأتي الآن إلى ما أعتبره فلسفتي الخاصة، المرتبطة بتلك الحقبة الخامسة من التفكير، التي نحياها الآن، وقد أسميتها “الإنسانوية الثانية” … فبدل أن تقصر هذه الإنسانوية الجديدة قيمة الحياة الإنسانية، على ما يتبع العقل والحقوق والتاريخ والتقدم، فإنها تبدو إنسانوية قائمة على الحب، وسنرى كيف أصبحت كذلك. أعتقد أن هذا الشعور ليس واحدًا من بين مشاعر أخرى يمكن مقارنته بالخوف والغضب والاستياء على سبيل المثال، بل إنه قد أصبح مبدأً ميتافيزيقيًا جديدًا، إذ هو يعطي لحياتنا معنى. وبالفعل، هو وحده قادر على إضفاء طابع مثالي على كل ما يمكن أن يكون محبوبًا، على وجه الدقة، في جميع المفردات الإنسانية، مع إيجاد مُثل جَمعية جديدة، لأننا نريد أن نترك عالمًا يمكن العيش فيه ويكون أكثر ما يمكن استقبالًا لمن نحبهم، لأطفالنا وللأجيال القادمة. ومن هذا المنظور، يؤدي الحب تجاه الأقرباء إلى الاهتمام بالإنسان الآخر المثيل (وهو عكس القريب، أي من لانعرفه)، كما نرى ذلك بالخصوص في نشأة الإنسانوية الحديثة منذ (هنري دينان). إنّ نشأة كل من الزواج المبني على الحب، والعائلة الحديثة في أوروبا، وسّعت الأفق وخلقت معنى جديدًا لما هو جمعي، وذلك بعيدًا عن الدفع إلى الانكفاء الفرداني على دائرة الحياة الخاصة. هذا على الأقل ما سأحاول الاستدلال عليه.
فالحب، هو ما يجعل البشرية تقوم بما يلزم لتوفير مناخ وحياة أفضل للأجيال القادمة. بل أن البشر، في وقتنا الحالي، يبدون أكثر استعدادًا للتضحية في سبيل من يحبون، أكثر من استعدادهم للتضحية في سبيل الأفكار أو المعتقدات أو حتى الأوطان.

فقد تخلصت البشرية من كل الأوهام الميتافيزيقية، بما في ذلك أوهام الأنوار، وتحررت بهذا أبعاد الوجود التي ظلّت إلى ذلك الحين مهملة أو مقموعة، فإنه (أي التفكيك) سيعطي الكائن البشري مزيدًا من الاستقلالية وحرية أكثر لصنع المصير واختيار أشكال الحياة التي تناسبه – علمًا بأن تلك الحرية هي بالتأكيد محيّرة ولذيذة على حد سواء – لذا يجب توفير الوسائل الذهنية الكفيلة بتجاوز التناقضات الملازمة للتفكيك؛ وتلك في نظري إحدى المهمات الأكثر جوهرية التي تضطلع بها الفلسفة المعاصرة كما أتصورها. وبالطبع، لابد من بلوغ ذلك دون إعادة النظر في مكتسبات الحقبة السابقة. وإني أرى لأسباب تاريخية وفلسفية بالأساس، أن ما سيمكننا اليوم – في هذه الرؤية الخامسة للعالم – من الإجابة عن مسألة معنى الحياة، إنما هو إذًا الدور المركزي من الآن، الذي نعطيه تلقائيًا لهذا الشعور الفريد للغاية، ألا وهو الحب.
فالحب سيصبح برأي (لوك فيري) هو المعنى لوجودنا، ليس في دائرة الحياة الخاصة فحسب، وإنما في دائرة الحياة الجَمعية أو الاجتماعية. يقول:
إن المكانة المركزية المسندة إلى الحب تبعث فينا الحرص المتواصل على فعل كل شيء حتى نوفر لمن نحبهم الشروط التي تسمح لهم بالازدهار، وبأن يكونوا أكثر مايمكن أحرارًا وسعداء. من هنا يأتي دور التربية الحاسم في العائلات اليوم، وسيتسع إلى الأبعاد التي كانت تجهلها التربية من قبل: فالأمر لايتعلق فقط بتبليغ معارف معينة، وإنما بالعمل على أن تتمكن الشخصية والمخيّلة والإبداعية، والمهارات الرياضية أو الفنية من الازدهار على أفضل وجه. إلا أن ثورة الحب تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. فهي تتجاوز، بقدر واسع، مجرد دائرة العائلة والحياة الخاصة، لكي تؤدي إلى تجديد المُثل الجَمعية، المرتبطة بالسعي إلى ترك عالم يمكن العيش فيه لأطفالنا، وبالتالي للأجيال القادمة عمومًا. وهكذا، فإن أولوية الحب ستنمي فينا مجددًا معنى ما هو جَمعي، بعيدًا عن الدفع بنا إلى الانطواء الفرداني.
فالحب يعطي بُعدًا مقدسًا للمعيش ذاته، دون التدخل في الأوهام الميتافيزيقية التقليدية التي حاربتها فلسفة التفكيك. وفي الوقت ذاته، فلا يمكن أن يكون ذلك “وثنًا” بالتعبير النيتشوي؛ لأنه دنيوي المصدر.
يختتم بعد ذلك مقالته بالتساؤل عن معنى “العمل الإنساني“، ما هو العمل الإنساني إذًا؟ يقول (لوك فيري):
ذات يوم، بينما كنت ألقي محاضرة حول هذا الموضوع، لاحظ لي (روبير بادنتر)، وهو محق جدًا في هذا، أن مقولته التي انطلق في صياغتها من القاعدة التقليدية: “لا تفعل بالآخرين ما لا تريد أن يُفعل بك” إنما هي توسيع لها: “لا تترك الآخرين يواجهون ما لا تريد أن تواجهه“. وهكذا، فالعمل الإنساني هو النضال ضد اللامبالاة، علمًا بأن هذا الصراع قد نشأ من ذلك الإحساس بالحب، الذي يغمر الحياة الخاصة وينعكس بكل تأكيد على كل ماهو جَمعي.